
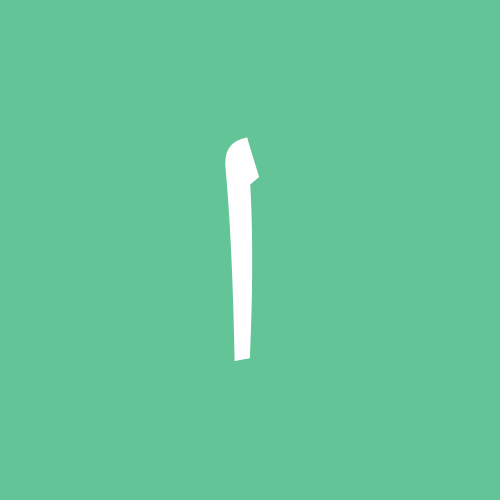
امانى يسرى محمد
-
عدد المشاركات
7754 -
تاريخ الانضمام
-
تاريخ آخر زيارة
-
الأيام التي فازت فيها
60
مشاركات المكتوبهة بواسطة امانى يسرى محمد
-
-
(قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا ذَلُولٞ تُثِيرُ ٱلأَرۡضَ وَلَا تَسقِي ٱلحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لاشِيَةَ فِيهَاۚ قَالُواْ ٱلـَٔنَ جِئتَ بالحَقِّۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفعَلُونَ) [البقرة: 71]
السؤال الأول:
ما الفرق في استعمالات الفعل (كاد) في قوله تعالى: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفعَلُونَ) [البقرة:71] و (إِذَآ أَخرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ) [النور:40] و (وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبصَٰرِهِمۡ) [القلم:51]؟ وما الفرق بين كاد وعسى؟
الجواب:
( كاد )
(كاد) من أفعال المقاربة، أي: قارب الحصول ولم يحصل بينما (عسى) هو لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء.
ـ خبر كاد فعل مضارع غير مقترن بأنْ على الغالب، وذلك لقربها من الوقوع.
ـ خبر عسى فعل مضارع مقترن بأنْ على الغالب؛ لأنّ (أنْ) تدل على الاستقبال.
وقيل: إنَّ (كاد) إثباتها نفي ونفيها إثبات، فإن قلت: كاد يفعل , فمعناه لم يفعل, وإنْ قلت: ما كاد يفعل, فمعناه أنه فعله بعد جهد، بدليل قوله تعالى: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفعَلُونَ) [البقرة:71].
ومعنى قوله تعالى: (إِذَآ أَخرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ) [النور:40] أي: مبالغة في (لم يرها) , أي: لم يقرب أنْ يراها فضلاً عن أنْ يراها, والأصح أنّ المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتها.
ومعنى قوله تعالى: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفعَلُونَ) [البقرة:71]أي: ذبحوها بعد الجهد، وبعد أنْ كان بعيداً في الظن أن يذبحوها.
ومعنى قوله تعالى: (وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) [الزُّخرُف:52] هذا الكلام عن لسان فرعون في موسى عليه السلام، ولا شك أنّ موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي ذكرها القرآن مع فرعون والمعنى أنه كان يبين لكنْ بصعوبة.
ومعنى قوله تعالى: (لَّا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ قَوۡلا) [الكهف:93] هذه المحاورة تدل على أنهم يفقهون ولكنْ بصعوبة, ولا تدل على أنهم لا يفقهون وإلا فما هذه المحاورة بينهما؟
ومعنى قوله تعالى: (وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبصَٰرِهِمۡ) [القلم:51] دلالة على شدة تحديق المشركين ونظرهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حالة قراءة النبي للقرآن، وهو قوله: (لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكرَ) [القلم:51] غيظاً وسخطاً بحيث لو أمكنهم أنْ يصرعوه لصرعوه.
السؤال الثاني:
قوله تعالى في الآية: (يَفعلُونَ) ما الفرق بين (يعملون) و(يفعلون) وما الفرق بين الفعل والعمل والصنع؟
الجواب:
1ـ العمل هو إيجاد الأثر في الشيء وعلى الأغلب فيه قصد ويحتاج إلى امتداد زمن، يقال: فلان يعمل من الطين خزفاً، وهو مختص بالإنسان من المخلوقات، كما ينسب العمل إلى الله سبحانه نحو: (مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيدِينَآ أَنعَٰما) [يس:71].
2ـ الفعل عام، وقد يكون بقصد أو بغير قصد، ويصلح أنْ يقع من الحيوان أو الجماد، كما تقول: فعل الرياح.
3ـ الصنع: أخص من الاثنين، وهو إجادة العمل ويحتاج إلى دقة ولا ينسب إلى حيوان أو جماد.
4ـ الفعل عام، والعمل أخصّ من الفعل، والصنع أخص.
ونستطيع أن ننظر في معاني الآيات، فالتي فيها زمن يقول: (يعملون) وما ليس فيه امتداد زمن وهو مفاجئ يقول: (يفعلون).
شواهد قرآنية: العمل:
ـ قوله تعالى عن الجان: (يَعمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ) [سبأ:13]، وهذا العمل يقتضي منهم وقتاً.
ـ قوله تعالى: (مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيدِينَآ أَنعَٰما) [يس:71] ما قال: فعلت؛ لأنّ خلق الأنعام والثمار يحتاج لوقت، فالله تعالى عندما يخلق التفاحة لا يخلقها فجأة، فقال: عملت أيدينا، يعني هذا النظام معمول بهذا الشكل؛ لأنّ فيه امتداد زمن.
قوله تعالى:( وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعمَلُونَ) [البقرة:96] أي: في الحياة؛ لأنّ العمل عادة فيه مدة.
شواهد قرآنية: الفعل:
ـ قوله تعالى عن الملائكة: (وَيَفعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ) [النحل:50]؛ لأنّ فعل الملائكة يتم برمش العين.
ـ قوله تعالى (أَلَمۡ تَرَ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحَٰبِ ٱلفِيلِ) [الفيل:1] باللحظة أرسل عليهم حجارة.
ـ قوله تعالى (أَلَمۡ تَرَ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ) [الفجر:6] خسف بهم.
ـ قوله تعالى (وَتَبَيَّنَ لَكُمۡ كَيفَ فَعَلنَا بِهِمۡ) [إبراهيم:45] أي: العقوبات، وغضب الله سبحانه وتعالى لمّا ينزل على الضالين والظالمين أنفسهم ينزل فوراً ولا يحتاج لامتداد زمن.
ـ قوله تعالى (وَمَا كَادُواْ يَفعَلُونَ) [البقرة:71] أي: كادوا لا يفعلون والذبح سريع فهو فعل.
شواهد قرآنية: الصنع:
ـ قوله تعالى: (صُنعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ) [النمل:88].
ـ قوله تعالى: (وَسَوۡفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصنَعُونَ) [المائدة:14] أي: ما يخططون ويدبرون بدقة ضد المسلمين.
والله أعلم.
-
يقول الله تعالى في محكم آياته : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) (98)( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) (99) الحجرقال سالم بن عبد الله بن عمر: (اليقين هنا هو الموت) ، وقد وردت كلمة اليقين بمعنى الموت في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه : (عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ – وَهْىَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – – قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّىَ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . قَالَ « وَمَا يُدْرِيكِ » . قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَاللَّهِ . قَالَ « أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ » فقوله تعالى : ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) ،(99) الحجر أي: اعبد يا محمد ربك حتى يأتيك الموت الذي أنت موقن به، وقال القرطبي: والمراد استمرار العبادة مدة حياته، كما قال العبد الصالح: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) (31) مريم ، وقال ابن كثير في تفسيره مدلالاً على أن اليقين هنا هو الموت، فقال : والدليل على ذلك قوله تعالى عن أهل النار : قال الله تعالى : (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ*وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ*وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ*وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) [المدثر:43-47]. ثم قال ابن كثير: ويستدل على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة يسقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته، وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد باليقين ههنا الموت، وقال الحسن البصري – رحمه الله – : يا قوم المداومة المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ، فلم يجعل الله في الآية الكريمة حداً زمانياً، أو مكانياً، أو كمية من العمل، إذا وصل إليها العبد توقف عن العبادة وإنما جعل ذلك حتى الموت.وهذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حيًا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته، فمثلا : إن لم يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ففي صحيح البخاري : (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ – رضى الله عنه – قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ :« صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » . فالمداومة على العمل الصالح ،دون انقطاع حتى الموت، هي وصية الله – عز وجل – لعبده ورسوله محمد – صلى الله عليه وسلم ، وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – كذلك، فقد روى البخاري: (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ قَالَتْ لاَ ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً،وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْتَطِيعُ )( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) (99) الحجرففي هذه الآيةِ الكريمةِ دعوةٌ صريحةٌ منَ الله تعالى لعبده المؤمن، إلى ضرورة المداوَمة على العبادة، حتى يَلقَى ربَّه ، فالمؤمن اليَقِظ يحرص على العبادة حتى تُؤتي ثمارها، وتظهر عليه آثارُها، فليس منَ الفطنة في شيء أن يَعمدَ المسلم إلى القرآن مثلا، فيُداوم على قراءته طوال شهر رمضان المبارك، فإذا خرج رمضان لم تبقَ له بالقرآن الكريم صِلة تُذْكَر، فالمداوَمة على العمل الصالح تُمِدُّ المؤمنَ بالهمَّة على مجاهدة نفسه، وتُبعد عنه الغفلة؛ ولهذا حَثَّ الرسولُ صلى الله عليه وسلم على المداوَمة على الأعمال، وإنْ كانت يسيرة قليلة؛ ففي الحديث الذي يرويه مسلم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ». قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ. يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: إنَّ القليل الدائم خيرٌ منَ الكثير المنقطع، وإنما كان القليل الدائمُ خيرًا منَ الكثير المنقطع؛ لأنه بدوام القليل تدُوم الطاعة، والذِّكْر، والمراقَبة، والنِّيَّة، والإخلاص، والإقبال على الله سبحانه، ويستمرُّ القليل الدائم؛ بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. ولهذا قال بعضُ الحكماء: إذا غفلَت النفسُ بترْك العبادة، فلا تأمن أن تعودَ إلى عاداتها السَّيِّئة، وصدَق ابنُ حزم حين قال: إهمال ساعة، يُفسد رياضة سَنَة.فالواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله في أقواله وأفعاله، وحركاته وسكناته، وفي كل شأن من شؤون حياته، يتحرى صحة العمل وإخلاص العبودية لله، والمعصية مذلة ومهانة وضنك وشقاء، ولذلك كان البعض يقول: ” رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة ” ،وكان الحسن يقول: ” فإنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه ” .ولذلك فالمؤمن الكيس الفطن هو الذي ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ويحرص على الإكثار من الدعاء فالدعاء هو العبادة، ولن يهلك مع الدعاء أحد، وإذا ألهم العبد الدعاء فإن الإجابة معه، ولا تعارض بين هذا كله وبين العمل والتكسب ،والقيام بواجب الدعوة إلى اللهفالمطلوب من المؤمن الصبر ،والثبات على الهداية ،وعلى تعظيم كلمات الله ، بتطبيقها واقعاً حيا معاشاً ،مع دوام التسبيح ،والمسارعة بالتوبة عند الوقوع في فخ المعصية.{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} الاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوصًا { بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ } اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور.موقع حامد إبراهيم -
مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ
الخطبة الأولى
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، { الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى }، وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله، رفعه الله فوق السماوات العلا ورأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى، وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد:
أيُّها النَّاس، اتقوا الله تعالى، واشتغلوا بما ينفعكم وينفع إخوانكم، وتجنبوا ما يضركم ويضر إخوانكم، فهذا هو الذي كلفتم به روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ " رواه الترمذي، فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومنهج واضح يسير عليه المسلم في حياته، أنه يأخذ بما يعنيه ويشتغل به ويترك ما لا يعنيه ويتجنبه، فلو أن المسلم التزم بهذا المنهج لحصل على خير كثير ولسلم من شر كثير، فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوقه أن المسلم يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال أي ما لا يفيده ولا ينفعه ولم يكلف به، وأنه يعمل ما يعنيه وما يخصه وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وذلك بأن يبدأ بنفسه فيعمل لها ما يصلحها ويجنبها ما يضرها من الأقوال والأعمال، فمن الأقوال لا يتكلم إلا بما فيه خير ومصلحه عاجله أو آجله قال الله جل وعلا: { لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } فهذا فيه إحسانٌ إلى نفسه وإحسان إلى الناس، وهو الأمر بكل خير وطاعة وما فيها مصلحة له ولغيره، فلا يستعمل لسانه إلا بذلك ولا ينطق بما يضره ويضر غيره من الأكاذيب والشائعات أو من السب والشتم أو من غير ذلك قال الله جل وعلا: { إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ } يعني الملكان { عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } فأقوالك محصاة ومكتوبة وستحاسب عنها، فإن كانت صالحةً جنيت منها الخير عاجلاً وآجلا، وإن كانت سيئة جنيت منها الشر عاجلاً وآجلا ففي الحديث: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ يهوي بها في جهنم "، فالكلمة الواحدة هذا شأنها، فكيف بالكلام الكثير؟ { لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ } أي: من كلامهم إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى فاحفظوا ألسنتكم، فالإنسان لا يتكلم إلا بما فيه مصلحه لنفسه ومصلحة لإخوانه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويذكر الغافل ويدعو إلى الله هذا فيما ينفع الناس، وفيما ينفع نفسه يشتغل بذكر الله وبتلاوة القرآن بالتسبيح والتهليل والتكبير ويكثر من ذلك فإنه ذخر له عند الله سبحانه وتعالى، ويتجنب الكلام السيء فقد سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، قَالَ:
" ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ " أَوْ قال: " عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " ،
الإنسان يتساهل في الكلام ولا يلقي له بالاً يتلقف الشائعات والأكاذيب ويروجها بين الناس { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ } يذيعه بين الناس { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } ، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه إلا في الخير، وكذلك الأعمال فلا يعمل إلا ما فيه خير ونفع عاجل أو آجل والأعمال الصالحة والأعمال المفيدة كثيرة ولله الحمد، وفيها ما يشغل المسلم ويأخذ فراغه ووقته ولا ينشغل بما فيه ضرر عليه لا يشتغل بالقيل والقال وسماع الكلام وسماع الملاهي والمعازف والمزامير لا ينظر فيما يضره ولا يسمع ما يضره ولا يتكلم إلا بما ينفعه ، { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً }،
فالإنسان مسئول عن هذه الحواس وعن هذه الأعضاء ما يعمل بها فهو يجني على نفسه أو يجني لنفسه " مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ " فاتركوا ما لا يعنيكم واشتغلوا بما يعنيكم ويفيدكم ويجلب لكم الخير في الدنيا والآخرة ما ينفعكم وينفع مجتمعكم وإخوانكم، أسعوا بالإصلاح بين الناس، أسعوا بما ينفع الناس من الأمر بالصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنالوا هذا الوعد من الله سبحانه { فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً }، فتنبهوا لذلك فإن الأمر خطير جدا، وكلما تأخر الزمان كثر الانشغال بالقيل والقال والغفلة عن ذكر الله وانطمست أعلام الخير إلا فيما وفقه الله سبحانه وتعالى وذلك لإقبال الدنيا على الناس وانفتاحها على الناس خصوصاً في هذا الوقت الذي تقاربت فيها الأقطار بواسطة وسائل النقل السريعة وبواسطة وسائل الإعلام السريعة حتى ما يحصل في أقصى العالم يبلغ أقصاه في لحظة واحدة، إما أن يكون خيراً وهذا قليل، وإما أن يكون شراً وهذا كثير، فأنقذوا أنفسكم أنقذوا أنفسكم من هذه الأخطار تعيشون الآن بين أخطار عظيمة وتيارات جذابة فخذوا حذركم وخذوا بأنفسكم خذوا بأولادكم وأهليكم إلى طاعة الله وانهوهم عن معصية الله فإنكم مسئولون عنهم خذوا بأيدي إخوانكم المسلمين فأنتم مكلفون بذلك قال صلى الله عليه وسلم:
" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وصاحب البيت رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "
من الذي يسألكم؟ إنَّه العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فتأهبوا للسؤال وأعدوا الجواب، فإنه لا ينجي عند الله إلا الصدق اليوم ينفع الصادقين صدقهم، فالله جل وعلا لا يروج عليه الكذب لا يروج عليه البهتان والاحتيالات والتزوير لأنَّه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء وهو محيط بكل شيء.
فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، عباد الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ " في بر أو بحر أو جو أو في بلدك أو في بلاد الكفار البلاد الأخرى اتق الله حيث ما كنت لأنك مسلم مسئول عن إسلامك مسئول عن دينك، أما من يظهر النسك والتقوى في بلاد المسلمين ثم إذا ذهب إلى بلاد الكفار انساح معهم وترك دينه أو ربما أنه يشعر دينه ذلة وأنه عورة فيخفيه أو يتركه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا من تسويل الشيطان دينك أمانتك ،
{ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً * لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } وهذه الأمانة يفهم بعض الناس أن الأمانة هي الوديعة فقط، الأمانة أعظم من ذلك الأمانة ما كلفك الله به من عبادته وحده لا شريك له ومن التزام دينه، فدين الله أمانة بينك وبين الله عز وجل ستسأل عنه يوم القيامة عن هذه الأمانة، ولهذا قسم الناس نحو هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من حفظها ظاهراً وباطنا وهم المؤمنون.
القسم الثاني: من ضيعها ظاهراً وباطنا وهم الكافرون.
القسم الثالث: من حفظها ظاهراً وضيعها باطناً وهم المنافقون { لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً }،
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكرِ الحكيم، أقولٌ قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد:
أيُّها الناس، اتقوا الله تعالى، { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً } أشكروا الله على هذه النعمة التي تعيشونها تحت ظل الإسلام وتحت عدل الإسلام ورحمة الله جلَّ وعلا " تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " كما أوصاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضيعوها ولا تتهاونوا بشأنها ولا تنشغلوا عنها بما يحدث الآن في العالم من الفتن والشرور ولو اقتصرت عليهم في بلادهم لما سألنا عنهم ودعونا الله أن يزيدهم منها ولكن وصلت إلينا عن طريق الانترنت وعن طريق وسائل الإعلام المسموعة المرئية والمقروءة، وصلت إلينا بما فيها من الشرور والتحريش بما فيها من الأكاذيب وما فيها من الإرجاف حتى أصبح بعض الناس لا شغل له اليوم إلا بمطالعة هذه الأشياء والتحدث عنها بين الناس حتى يصبح مشغول البال مندهشاً مما يسمع ويقرأ وغالبه كذب وإرجاف، فعليه أن يتوكل على الله عز وجل قال الله جل وعلا:
{ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا تهمكم هذه الأشياء إذا اعتصمتم بعصمة الله ورجعتم إلى الله { وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }.
فاتقوا الله، عباد الله، ولا تنشغلوا بهذه الأمور اتركوها وابتعدوا عنها وأبعدوها عن بيوتكم وعن أولادكم واشتغلوا بذكر الله وبطاعة الله، فإنها فتن عظيمة و" فتن كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ " كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فحاذروها واحذروا منها وحذروا منها، واشكروا الله على ما أنتم فيه من الخير والنعمة والأمن والإيمان فحافظوا على ذلك تمام المحافظة حتى يبقى لكم ويدوم فإن الله جلَّ وعلا { لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ }.
واعلموا أنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهديَّ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتها، وكُلَ بدعةٍ ضلالة.
وعليكم بالجماعة فإنَّ يد الله على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار ، { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }،
اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيَّنا محمد، وارضَ اللَّهُمَّ عن خُلفائِه الراشدين، الأئمةَ المهديين، أبي بكرَ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وعَن الصحابةِ أجمعين، وعن التابِعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
اللَّهُمَّ أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين، اللَّهُمَّ من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، وردد كيده في نحره، وجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير، اللَّهُمَّ انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللَّهُمَّ أنت اللهُ لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين، اللَّهمَّ أغثنا، اللَّهمَّ أغثنا، اللَّهمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أرحمنا برحمتك،اللَّهُمَّ أرحمنا برحمتك ولا تقتلنا بغضبك وعقابك يا رب العالمين، اللَّهُمَّ أحي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر حمتك وأحي بلادك الميت، اللَّهُمَّ إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }، اللَّهُمَّ أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مظلين، اللَّهُمَّ أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } .
عبادَ الله، { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }، { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }، فاذكروا اللهَ يذكُرْكم، واشكُروه على نعمِه يزِدْكم، { ولذِكْرُ اللهِ أكبرُ واللهُ يعلمُ ما تصنعون }.
-
تعقيباً على ما تم ذكره
قال ابن القيم :
( ثبت عن خالد بن الوليد: أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة - رضي الله عنهم - فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة،وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه )
[الداءُ والدواءُ صـ٤١٨]لابن القيمقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" أما الإحراق : فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ، ومن طريق ابن المنكدر : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ، ينكح كما تنكح المرأة ، فجمع أبو بكر الصحابة ، فسألهم ، فكان أشدهم في ذلك قولا علي ، فقال : نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك .
قلت : وهو ضعيف جدا ، ولو صح لكان قاطعا للحجة ".
انتهى من " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 103 ) .
وعلق الشيخ بكر أبو زيد على هذه الرواية بقوله :
" وحكم الأئمة بأنه حديث مرسل كما صرح به البيهقي والشوكاني " .
انتهى من " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص 175 ) .
فالحاصل أن هذه الحادثة غير مقطوع بصحتها وثبوتها .الاسلام سؤال وجواب
-
بسم الله الرحمن الرحيم
[الداءُ والدواءُ ]
﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ﴾
قال ابن القيم :
( و من" هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاءً قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن )
[الداءُ والدواءُ صـ ٣٧]
قال ابن القيم :
( ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة، لرأى لها تأثيرًا عجيبا في الشفاء.
ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواءٌ ولا أجد طبيبًا ولا دواءً، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، فأرى لها تأثيرًا عجيبًا، فكنتُ أصف ذلك لمن يشتكيألمًا، وكان كثير منهم يبرأ سريعًا )
[الداءُ والدواءُ صـ ٣٩]
قال ابن القيم :
( الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها، هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحلِّ، وقوة همة الفاعل وتأثيره،فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثيرِ الفاعل، أو لعدم قبول المُنفَعِلِ، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء )
[الداءُ والدواءُ صـ ٣٩]
قال ابن القيم عن أوقات الإجابة:
( وهي: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقضى الصلاة، وآخرُ ساعة بعد العصر من ذلك اليوم )
[الداءُ والدواءُ صـ ٤٨]
قال ابن مسعود :
( ما كُرِبَ نبيٌّ من الإنبياءِ، إلا استغاث بالتَّسْبِيحِ)
[الداءُ والدواءُ صـ ٥٤]
قال ابن القيم :
( وكثيرًا ما نجدُ أدعية دعا بها قوم فاستُجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورةُ صاحبه وإقباله على الله، أو حسنةٌ تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنته، أو صادف وقت إجابة، ونحو ذلك، فأجيبت دعوته، فيظن الظَانُّ أن السِّرَّ في لفظ ذلك الدعاءُ فيأخُذُهمجرَّدًا عن تلك الأمور التي قارَنَته من ذلك الداعي )
[الداءُ والدواءُ صـ ٥٦]
قال ابن القيم :
( والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه، لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به، والسَّاعدُ ساعِدُ قويٍّ، والمانع مفقودٌ؛ حصلت به النكاية في العدوِّ، ومتى تخلَّف واحد من هذه الثلاثة تخلَّفَ التَّأثيرُ )
[الداءُ والدواءُ صـ ٥٧]
وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به -أي الدعاء-على عدوه، وكان أعظم جنديه،وكان يقول لأصحابه:
(لستُمْ تُنصرُونَ بكثرةٍ، وإنما تنصرون من السماء)
[الداءُ والدواءُ صـ ٦٠]
قال ابن القيم :
( فالتَّاريخُ تَفْصيلٌ لجُزْئِيَّاتِ ما عَرَّفنا الله ورسولُهُ من الأسبابِ الكُلِّيَّةِ للخيرِ والشَّرِّ )
[الداءُ والدواءُ صـ ٦٦]
قال ابن القيم عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا﴾
( ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائِبين )
[الداءُ والدواءُ صـ٧٠ ]
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر حديث ( ما ظنُّ مُحمَّدٍ بربه، لو لقي الله وهذِهِ عِنْدَهُ )
( فيالله! ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه، ومظالم العباد عندهُمْ)
[الداءُ والدواءُ صـ ٧٦]
قال ابن القيم :
( فَالعَالِمُ يَضَعُ الرَّجاءَ مواضعَه، والجَاهِلُ المُغْتَرُّ يَضَعُهُ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهِ.)
[الداءُ والدواءُ صـ ٧٨]
قال الحسن البصري:
( إن قومًا ألهتهم أمانيُّ المغفرةِ حتى خرجوا من الدنيا بغير توبةٍ، يقول أحدهم: لأني أُحسنُ الظَّنَّ بِرَبِّي، وكَذَبَ، لو أحسن الظَّنَّ لأحسنالعَمَلَ )
[الداءُ والدواءُ صـ ٧٩]
قال ابن القيم :
( وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشَرُّ الناس من تشبَّه بهم من الكذابين، وادعى أنه منهم، وليس منهم.
فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشَرُّ الناس من تشبَّهَ بهم، يُوهِمُ أنه منهم، وليس منهُمْ )
[الداءُ والدواءُ صـ٩٥]
قال بعض السلف :
( إذا رأيتَ الله يُتَابعُ نِعَمَهُ عليك، وأنت مقيمٌ على مَعَاصِيِهِ؛ فاحْذَرْهُ، فإِنما هُوَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ، يَسْتَدْرِجُكَ بِهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ ٩٨]
قال ابن القيم :
(ومما ينبغي أن يعلم أنّ من رجا شيئًا استلزم رجاؤُهُ أمورًا:
أحدها: محبة ما يرجوه.
الثاني: خوفه من فواته.
الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.
وأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك، فهو من باب الأماني! والرجاء شيء، والأماني شيء آخر. فكلُّ راجٍ خائفٌ، والسائر على الطريق إذا خافأسرَعَ السيرَ مخافةَ الفوات. )
[الداءُ والدواءُ صـ ١٠٧]
قال ابن القيم :
( مَنْ تَأَمَّلَ أَحْوَالَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَجَدَهُمْ فِي غَايَةِ الْعَمَلِ مَعَ غَايَةِ الْخَوْفِ، وَنَحْنُ جَمِيعًا بَيْنَ التَّقْصِيرِ، بَلِ التَّفْرِيطِ وَالْأَمْنِ
فَهَذَا الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ.
وَذَكَرَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَمْسِكُ بِلِسَانِهِ وَيَقُولُ: هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ )
[الداءُ والدواءُ صـ ١٠٨]
قال ابن القيم :
( وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الطُّورِ إِلَى أَنْ بَلَغَ: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ حَتَّى مَرِضَ وَعَادُوهُ )
[الداءُ والدواءُ صـ ١١٠]
قال علي بن أبي طالب:
( يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة، وهي خراب من الهدى، علماؤهم شرُّمن تحت أديم السماء، منهم خرجتِ الفتنة وفيهم تعود )
[الداءُ والدواءُ صـ ١٢١]
( وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرٍو الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ: إِنِّي مُهْلِكٌ مِنْ قَوْمِكَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ خِيَارِهِمْ، وَسِتِّينَأَلْفًا مِنْ شِرَارِهِمْ، قَالَ: يَا رَبِّ، هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ، فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ قَالَ: لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي، وَكَانُوا يُؤَاكِلُونَهُمْ وَيُشَارِبُونَهُمْ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٢٤]
( وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا هَذَا؟ مَا أَسْرَعَ مَا أَحْدَثْتُمْ، لَئِنْ عَادَتْ لَا أُسَاكِنُكُمْفِيهَا )
[الداءُ والدواءُ صـ١٢٦]
قال الحسن:
( إِنَّ الْفِتْنَةَ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٢٩]
( ذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ: إِذَا عَصَانِي مَنْ يَعْرِفُنِي سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي )
[الداءُ والدواءُ صـ١٣١]
قال العمري الزاهد:
( مـن ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مخافةً من المخلوقين، نُزعت مِنهُ الطاعةُ، ولو أمر ولدهُ أو بَعْضَ مَوَالِيهِ لاسْتخف بحقِّهِ )
[ الداء والدواء صـ ١٣٣ ]
قال بعضُ السلف:
( الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ، كَمَا أَنَّ الْقُبْلَةَ بَرِيدُ الْجِمَاعِ، وَالْغِنَاءُ بَرِيدُ الزِّنَا، وَالنَّظَرُ بَرِيدُ الْعِشْقِ، وَالْمَرَضُ بَرِيدُ الْمَوْتِ )
[الداءُ والدواءُ صـ ١٣٧]
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ:
(لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٣٨]
قال الفضيلُ بنُ عِيَاضٍ :
( بِقَدْرِ مَا يَصْغَرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ يَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغَرُ عِنْدَ اللَّهِ.)
[الداءُ والدواءُ صـ١٣٨]
قال ابن القيم :
( لِلذَّنْبِ نَقْدًا مُعَجَّلًا لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ، قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُ الذَّنْبَ فِي السِّرِّ فَيُصْبِحُ وَعَلَيْهِ مَذَلَّتُهُ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٤٢]
قال ذو النون :
( مَنْ خَانَ اللَّهَ فِي السِّرِّ هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٤٣]
( لَمَّا جَلَسَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ يَدَيْ مَالِكٍ وَقَرَأَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ وُفُورِ فِطْنَتِهِ، وَتَوَقُّدِ ذَكَائِهِ، وَكَمَالِ فَهْمِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّهَ قَدْ أَلْقَى عَلَىقَلْبِكَ نُورًا، فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٤٤]
قال ابن القيم :
( ما استجلب زرق الله بمثلِ تركِ المعاصي )
[الداءُ والدواءُ صـ١٤٤]
قال بعض السلف :
( إِنَّ مِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، وَإِنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا )
[الداءُ والدواءُ صـ١٥٠]لابن القيم
قال ابن القيم لما تحدث عن آثار المعاصي :
( ومنها: أَنَّهُ يَنْسَلِخُ مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاحُهَا، فَتَصِيرُ لَهُ عَادَةً، فَلَا يَسْتَقْبِحُ مِنْ نَفْسِهِ رُؤْيَةَ النَّاسِ لَهُ، وَلَا كَلَامَهُمْ فِيهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٥٣]
قال ابن القيم :
( وَإِذَا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ لَمْ يُكْرِمْهُ أَحَدٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ}
وَإِنْ عَظَّمَهُمُ النَّاسُ فِي الظَّاهِرِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِمْ أَوْ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِمْ، فَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ أَحْقَرُ شَيْءٍ وَأَهْوَنُهُ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٥٥]لابن القيم
﴿كَلّا بَل رانَ عَلى قُلوبِهِم ما كانوا يَكسِبونَ﴾
قال بعض السلف :
( هو الذنب بعد الذنب )
[الداءُ والدواءُ صـ ]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وَالَّذِي يَفُوتُهُ بِالْمَعْصِيَةِ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ السُّرُورِ وَاللَّذَّةِ بِهَا، فَهَلْ يُقْدِمُ عَلَى الِاسْتِهَانَةِ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَالِاسْتِخْفَافِبِهِ ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٥٨]
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}
قَالَ: هُوَ الذَّنْبُ بَعْدَ الذَّنْبِ
[الداءُ والدواءُ صـ١٥٩]لابن القيم
قَالَ مُجَاهِدٌ:
( إِذَا وَلِيَ الظَّالِمُ سَعَى بِالظُّلْمِ وَالْفَسَادِ فَيَحْبِسُ اللَّهُ بِذَلِكَ الْقَطْرَ، فَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، ثُمَّ قَرَأَ: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} )
[الداءُ والدواءُ صـ١٧٣]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب.
وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها،وإنما حدثت من قرب )
[الداءُ والدواءُ صـ١٧٥]لابن القيم
قال الإمام ابن القيم :
( أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي ﷺ أغيرَ الخلق على الأمة، والله سبحانه أشدغيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني )
[الداءُ والدواءُ صـ ]لابن القيم
( والله سبحانه - مع شدة غيرته - يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتىيعذر إليهم، ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان، ونهاية الكمال )
[الداءُ والدواءُ صـ١٧٩]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة من غير ريبة» وذكر الحديث.
وإنما الممدوح اقترانُ الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة، ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا )
[الداءُ والدواءُ صـ١٨٠]لابن القيم
( فَالْغَيُورُ قَدْ وَافَقَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ
وَمَنْ وَافَقَ اللَّهَ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ قَادَتْهُ تِلْكَ الصِّفَةُ إِلَيْهِ بِزِمَامِهِ، وَأَدْخَلَتْهُ عَلَى رَبِّهِ، وَأَدْنَتْهُ مِنْهُ، وَقَرَّبَتْهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَصَيَّرَتْهُ مَحْبُوبًا )
[الداءُ والدواءُ صـ١٨٠]لابن القيم
قال ابن القيم :
( عَلَى قَدْرِ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لِلَّهِ يُحِبُّهُ النَّاسُ، وَعَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ يَخَافُهُ الْخَلْقُ، وَعَلَى قَدْرِ تَعْظِيمِهِ لِلَّهِ وَحُرُمَاتِهِ يُعَظِّمُهُ النَّاسُ، وَكَيْفَ يَنْتَهِكُ عَبْدٌحُرُمَاتِ اللَّهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ١٨٧]لابن القيم
قال ابن القيم :
( الذنب إما يميت القلب، أو يمرضه مرضا مخوفًا، أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبيﷺ وهي: « الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال»)
[الداءُ والدواءُ صـ١٩٥]لابن القيم
قال ابن القيم :
( فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصولهبالخوف من سلبه وفواته، والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه ثلاثة أنواع منالعذاب في هذه الدار )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٠٣]لابن القيم
قال ابن القيم :
(ومن أعظم نعم الله على العبد: أن يرفع له بين العالمين ذكره، ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى:﴿وَاذكُر عِبادَنا إِبراهيمَ وَإِسحاقَ وَيَعقوبَ أُولِي الأَيدي وَالأَبصارِ إِنّا أَخلَصناهُم بِخالِصَةٍ ذِكرَى الدّارِ﴾)
[الداءُ والدواءُ صـ٢١١]لابن القيم
﴿وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكَةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدوا إِلّا إِبليسَ كانَ مِنَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَولِياءَ مِن دوني وَهُم لَكُم عَدُوٌّ بِئسَلِلظّالِمينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠]
قال ابن القيم بعد كلامه عن هذه الآية :
( ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيفٌ عجيبٌ: وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت معاداتهلأجلكم، ثم كان عَاقِبَةُ هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٢٠]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وَلَيْسَتْ سَعَةُ الرِّزْقِ وَالْعَمَلِ بِكَثْرَتِهِ، وَلَا طُولُ الْعُمُرِ بِكَثْرَةِ الشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، وَلَكِنَّ سَعَةَ الرِّزْقِ وَطُولَ الْعُمُرِ بِالْبَرَكَةِ فِيهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٢٢]لابن القيم
قال ابن القيم :
( الشَّامُ أَرْضُ الْبَرَكَةِ، وَصَفَهَا بِالْبَرَكَةِ فِي سِتِّ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٢٤]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وَلِهَذَا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعِيشُ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوَهَا، وَيَكُونُ عُمُرُهُ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا، كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَمْلِكُ الْقَنَاطِيرَالْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَكُونُ مَالُهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَبْلُغُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَهَا، وَهَكَذَا الْجَاهُ وَالْعِلْمُ.
وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ» .
وَفِي أَثَرٍ آخَرَ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ» فَهَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ الْبَرَكَةُ خَاصَّةً، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وعليه التكلان )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٢٦]لابن القيم
( في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: {وجعل الذل والصغار على من خالف أمري}
فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل، درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال فيارتفاع حتى يكون من الأعلين )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٢٧]لابن القيم
قال ابن القيم :
( فإن الذنب وإن صغر، فإن مقابلةَ العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعمِبجميع أصناف النعم دقيقها وجلها - من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها )
[الداءُ والدواءُ صـ ٢٣١]لابن القيم
قال بعض السلف :
( إِنِّي لَأَعْصِي اللَّهَ فَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي خُلُقِ امْرَأَتِي وَدَابَّتِي )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٣٤]لابن القيم
قال ابن القيم :
( إِنَّ الْكَمَالَ الْإِنْسَانِيَّ مَدَارُهُ عَلَى أَصْلَيْنِ: مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَإِيثَارِهِ عَلَيْهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٤١]لابن القيم
(فإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، فَإِنَّهُ بالْحَرِيِّ أَنْ لَا يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٦٢]لابن القيم
وقال بعض السلف:
( إذا ركب الذكر ُ الذَّكرَ عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٧١]لابن القيم
قال ابن القيم :
(عُقُوبَاتُ الشَّارِعِ جَاءَتْ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ وَأَوْفَقِهَا لِلْعَقْلِ، وَأَقْوَمِهَا بِالْمَصْلَحَةِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٨٢]
قال ابن القيم :
( فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فتركوا إنكاره أوشك أن يعمهم اللهبعقابه )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٨٣]لابن القيم
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
( لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الْقَتْلِ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٨٤]لابن القيم
قال ابن القيم :
( فَالزِّنَا بِمِائَةِ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا أَيْسَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزِّنَا بِامْرَأَةِ الْجَارِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٨٥]لابن القيم
( لَا يَجْتَمِعُ الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ فِي مَعْصِيَةٍ، بَلْ إِنْ كَانَ فِيهَا حَدٌّ اكْتُفِيَ بِهِ وَإِلَّا اكْتُفِيَ بِالتَّعْزِيرِ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْحَدُّ وَالْكَفَّارَةُ فِي مَعْصِيَةٍ، بَلْ كُلُّمَعْصِيَةٍ فِيهَا حَدٌّ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَمَا فِيهِ كَفَّارَةٌ فَلَا حَدَّ فِيهِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٨٩]لابن القيم
( فالذنب لا يخلو من عقوبة ألبتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم،فإذن استيقظ وصحا أحسَّ بالمؤلم )
[الداءُ والدواءُ صـ٢٩٥]لابن القيم
قال ابن القيم لما تحدث عن حق الخلق:
( وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٠٩]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة، على أن من الذنوب كبائر وصغائر، قال الله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما})
[الداءُ والدواءُ صـ٣١٢]لابن القيم
قال ابن القيم :
(و{{لا ينبغي}}في كلام الله ورسوله ﷺ للذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا}وقوله: {وماينبغي له}
وقوله: {وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم}
وقوله: {ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٣٢]لابن القيم
( أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعدالله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: {عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنموساءت مصيرا} )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٢٤]لابن القيم
قال بعض السلف :
( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٥٥]لابن القيم
قال ابن القيم :
( لهذا كان أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًّا أو قتله نبيٌّ )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٥٧]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وما أوتي عبد - بعد الإيمان - أفضل من الفهم عنِ الله ورسوله، ﷺ ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٦٤]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي ﷺ في النار والهرة تخدشها في وجههاوصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟)
[الداءُ والدواءُ صـ٣٦٩]لابن القيم
قال ابن القيم لما تحدث عن أهمية حفظ الفرج:
ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدؤها من البصر، كما أن معظم النار منمستصغر الشرر، فتكون نظرة، ثم تكون خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة.
ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات، والخطرات، واللفظات، والخطوات.
فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو، فيجوس خلال الديار ويتبرما علا تتبيرا.
[الداءُ والدواءُ صـ٣٧٢]لابن القيم
قال ابن القيم :
( فَأَمَّا اللَّحَظَاتُ: فَهِيَ رَائِدُ الشَّهْوَةِ وَرَسُولُهَا، وَحِفْظُهَا أَصْلُ حِفْظِ الْفَرْجِ، فَمَنْ أَطْلَقَ بَصَرَهُ أَوْرَدَ نَفْسَهُ مَوَارِدَ الْمُهْلِكَاتِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٧٣]لابن القيم
قال ابن القيم :
( ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى مالا صبر لك عن بعضه، ولا قدرة على بعضه)
[الداءُ والدواءُ صـ٣٧٥]لابن القيم
مَا زِلْتَ تُتْبِعُ نَظْرَةً فِي نَظْرَةٍ
فِي إِثْرِ كُلِّ مَلِيحَةٍ وَمَلِيحِ
وَتَظُنُّ ذَاكَ دَوَاءَ جُرْحِكَ وَهُوَ فِي الْـ
تَحْقِيقِ تَجْرِيحٌ عَلَى تَجْرِيحِ
فَذَبَحْتَ طَرْفَكَ بِاللِّحَاظِ وَبِالْبُكَا
فَالْقَلْبُ مِنْكَ ذَبِيحٌ أَيُّ ذَبِيحِ
[الداءُ والدواءُ صـ٣٧٧]لابن القيم
قيل: إِنَّ حَبْسَ اللَّحَظَاتِ أَيْسَرُ مِنْ دَوَامِ الْحَسَرَاتِ.
[الداءُ والدواءُ صـ٣٧٧]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهزجيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة، وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو من باب عزيز شريف،لا يدخل منه إلا صادق حاذق الطلب، متضلع من العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيهمن يشاء. )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٨٧]لابن القيم
قال يحيى بن معاذ:
( القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك بما في قلبه، حلو وحامض، وعذبوأجاج، وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه )
[الداءُ والدواءُ صـ٣٨٨]لابن القيم
(كان بعض السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار، ويوم بارد)
[الداءُ والدواءُ صـ ٣٩٥]لابن القيم
قال ابن القيم لما تحدث عن أسباب الزنى:
( وأكثرُ أسبابه العشق )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٠٤]لابن القيم
قال ابن القيم :
( إن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاحأبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل مايعمل السم في البدن )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٠٥]لابن القيم
( بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنةً من الأرض، وقال: الذنوب أهون من هذا،وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة.
وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى )
[الداءُ والدواءُ صـ٤١٢]لابن القيم
.
قال ابن القيم عن مفسدة اللواط :
( جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماع
ا للصحابة، ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، كما سنبينه إنشاء الله تعالى)
[الداءُ والدواءُ صـ٤١٧]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته )
[الداءُ والدواءُ صـ٤١٨]لابن القيم
قال ابن القيم :
( ثبت عن خالد بن الوليد: أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة - رضي الله عنهم - فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة،وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه )
[الداءُ والدواءُ صـ٤١٨]لابن القيم
قال ابن القيم عن حد اللواط :
( أطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله، ولم يختلف فيه منهم رجلان وإنما اختلفت أقولهم في صفة قتله، فظَّن بعض الناس أن ذلك اختلافٌمنهم في قتله فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٢٠]لابن القيم
قال ابن القيم :
( أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله تعالى: {إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}
وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر، يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيرهفي الإثم والحكم )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٣٥]لابن القيم
وَقَفَ الْهَوَى بِي حَيْثُ أَنْتِ فَلَيْسَ
لِي مُتَأَخَّرٌ عَنْهُ وَلَا مُتَقَدَّمُ
وَأَهَنْتِنِي فَأَهَنْتُ نَفْسِي جَاهِدًا
مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مِمَّنْ يُكْرَمُ
أَشْبَهْتِ أَعْدَائِي فَصِرْتُ أُحِبُّهُمْ
إِذْ كَانَ حَظِّي مِنْكِ حَظِّي مِنْهُمْ
أَجِدُ الْمَلَامَةَ فِي هَوَاكِ لَذِيذَةً
حُبًّا لِذِكْرِكِ فَلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ
[الداءُ والدواءُ صـ٤٣٧]لابن القيم
قال ابن القيم عن منافع غض البصر:
الخامسة: أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة، ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال: {قل للمؤمنينيغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}
ثم قال إثر ذلك: {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح}
أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه
[الداءُ والدواءُ صـ٤٣٩]لابن القيم
قال ابن القيم :
(وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عنالشهوات، واغتذى بالحلال،لم تخطئ له فراسة.
وكان شاه بن شجاعا هذا لا تخطئُ له فراسة.)
[الداءُ والدواءُ صـ٤٤٠]لابن القيم
قَالَ الْحَسَنُ:
( إِنَّهُمْ وَإِنْ طَقْطَقَتْ بِهِمُ الْبِغَالُ، وَهَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَرَاذِينُ، إِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فِي رِقَابِهِمْ، أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٤٣]لابن القيم
وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته، ويمقته لذلك، ويبعده لا يحظيه بقربه، ويعده كاذبا في دعوىمحبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب علىصاحبها ووبال
[الداءُ والدواءُ صـ٤٤٨]لابن القيم
من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، ابتلاه بمحبة غيره؛ فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فإما أن يعذبه بمحبةالأوثان، أو بمحبة الصلبان، أو بمحبة المردان، أو بمحبة النسوان، أو بمحبة العشراء والإخوان، أو بمحبة ما دون ذلك مما هو في غايةالحقارة والهوان، فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل:
أنت القتيل بكل من أحببته
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي
فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه، كان إلهه هواه، قال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل علىبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون}
[الداءُ والدواءُ صـ٤٤٩]لابن القيم
خَيَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرُكَ فِي فَمِي
وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ
[الداءُ والدواءُ صـ٤٥٥]لابن القيم
وَمِنْ عَجَبٍ أَنِّي أَحِنُّ إِلَيْهِمُ
فَأَسْأَلُ عَنْهُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي
وَتَطْلُبُهُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا
وَيَشْتَاقُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَضْلُعِي
[الداءُ والدواءُ صـ٤٥٦]لابن القيم
أَنْتَ الْقَتِيلُ بِكُلِّ مَنْ أَحْبَبْتَهُ
فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ فِي الْهَوَى مَنْ تَصْطَفِي
[الداءُ والدواءُ صـ ٤٤٩]لابن القيم
( إن الرب تعالى ما أمر بشيء، ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بينيدي المناجاة، وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها، وقال: «ولا يبدل القول لدي، هي خمس في الفعل، وهي خمسونفي الأجر )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٦٨]لابن القيم
( وَالخُلَّةَ نِهَايَـةُ المَحَبَّةِ )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٦٩]لابن القيم
قال ابن القيم :
( فأعقل الناس من آثر لذته وراحته في الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة.
وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما، بلذة منقضية مشوبة بالآلاموالمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء)
[الداءُ والدواءُ صـ٤٧٣]لابن القيم
قال ابن القيم :
( إِنَّ مَحَبَّةَ الْمَحْبُوبِ تُوجِبُ مَحَبَّةَ مَا يُحِبُّهُ )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٧٥]لابن القيم
قال ابن القيم :
( الأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش، وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا، قال تعالى: {من عمل صالحامن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة}
وطيب الحياة جنة الدنيا )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٨٣]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وَكُلُّ حَرَكَةٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ فَأَصْلُهَا الْمَحَبَّةُ، فَهِيَ عَلَيْهَا الْفَاعِلِيَّةُ وَالْغَائِيَّةُ )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٩١]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد الملوك منالمسلمين واختلافهم، وانفراد كل منهم ببلاد، وطلب بعضهم العلو على بعض )
[الداءُ والدواءُ صـ٤٩٦]لابن القيم
قال ابن القيم عن قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز :
( وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ الْعِبَرِ وَالْفَوَائِدِ وَالْحِكَمِ مَا يَزِيدُ عَلَى الْأَلْفِ فَائِدَةٍ، لَعَلَّنَا إِنْ وَفَّقَ اللَّهُ أَنْ نُفْرِدَهَا فِي مُصَنَّفٍ مُسْتَقِلٍّ )
[الداءُ والدواءُ صـ٥١٢]لابن القيم
قال ابن القيم لما تحدث عن علاج العشق المحرم :
( وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادناالمخلصين﴾
فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه)
[الداءُ والدواءُ صـ٥١٦]لابن القيم
( والعشقُ وإن استعْذَبَهُ العاشِقُ فهو من أعظمِ عذاب القلب )
[الداءُ والدواءُ صـ٥١٧]لابن القيم
قال ابن القيم :
( وَالرَّغَبَاتُ تَسْتُرُ الْعُيُوبَ، فَالرَّاغِبُ فِي الشَّيْءِ لَا يَرَى عُيُوبَهُ، حَتَّى إِذْ زَالَتْ رَغْبَتُهُ فِيهِ أَبْصَرَ عُيُوبَهُ )
[الداءُ والدواءُ صـ٥٢١]لابن القيم
قال ابن القيم :
(فَلَوْلَا تَكْرَارُهُ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ مَعْشُوقِهِ وَطَمَعُهُ فِي وِصَالِهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ عِشْقُهُ مِنْ قَلْبِهِ)
[الداءُ والدواءُ صـ ٥٣١]لابن القيم
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
( أَرْوَاحُ الْعُشَّاقِ عَطِرَةٌ لَطِيفَةٌ، وَأَبْدَانُهُمْ رَقِيقَةٌ خَفِيفَةٌ، نُزْهَتُهُمُ الْمُؤَانَسَةُ، وَكَلَامُهُمْ يُحْيِي مَوَاتَ الْقُلُوبِ، وَيَزِيدُ فِي الْعُقُولِ، وَلَوْلَا الْعِشْقُ وَالْهَوَىلَبَطَلَ نَعِيمُ الدُّنْيَا )
[الداءُ والدواءُ صـ٥٣٥]لابن القيم
قال ابن القيم :
( فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا منه الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة )
[الداءُ والدواءُ صـ٥٦٨]لابن القيم
قال ابن القيم :
محبة كلام الله، فإنه من علامة حب الله، وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعهأعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم، فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه
[الداءُ والدواءُ صـ٥٧٣]لابن القيم
قال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -:
( لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله )
[الداءُ والدواءُ صـ٥٧٣]لابن القيم
فإذا رأيت الرجل، ذوقه، ووجده، وطربه، وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وسماع الألحان دون سماع القرآن، كما قيل:
تقرأ عليك الختمة
وأنت جامد كالحجر
وبيت من الشعر ينشد
تميل كالسكران.
فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه، وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء.
[الداءُ والدواءُ صـ ٥٧٤]لابن القيم
قال الإمام ابن القيم :
( فمحبة النساء من كمال الإنسان، قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء )
[الداءُ والدواءُ صـ٥٨٠]لابن القيم
صيد الفوائد -
بسم الله الرحمن الرحيم
[١] ﴿بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه. [ص١]
[٢] ﴿الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ (٢) الرَّحمنِ الرَّحيمِ (٣) مالِكِ يَومِ الدّينِ﴾من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم ليشرع في الطلب. [ص١]
[٣] ﴿إِيّاكَ نَعبُدُ وَإِيّاكَ نَستَعينُ﴾كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. [ص١]
[٤] ﴿الَّذينَ يُؤمِنونَ بِالغَيبِ﴾من أعظم مراتب الإيمانِ الإيمانُ بالغيب؛ لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب، ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. [ص٢]
[٥] ﴿وَيُقيمونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ﴾كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة؛ لأنَّ الصلاة إخلاص للمعبود، والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. [ص٢]
[٦] ﴿قالوا أَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها وَيَسفِكُ الدِّماءَ وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنّي أَعلَمُ ما لا تَعلَمونَ﴾الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأَمْرِهِ أن يسلِّم لله في خلقه وأَمْرِهِ. [ص٦]
[٧] ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى المَلائِكَةِ فَقالَ أَنبِئوني بِأَسماءِ هؤُلاءِ إِن كُنتُم صادِقينَ﴾رَفَعَ القرآن الكريم منزلة العلم، وجعله سببًا للتفضيل بين الخلق. [ص٦]
[٨] ﴿وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكَةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدوا إِلّا إِبليسَ أَبى وَاستَكبَرَ وَكانَ مِنَ الكافِرينَ﴾الكِبْرُ هو رأس المعاصي، وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عُصِيَ الله بها. [ص٦]
[٩] ﴿أَتَأمُرونَ النّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم تَتلونَ الكِتابَ أَفَلا تَعقِلونَ﴾من أعَظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر، وينسى نفسه. [ص٧]
[١٠] ﴿وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلّا عَلَى الخاشِعينَ﴾الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. [ص٧]
[١١] ﴿وَضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَسكَنَةُ وَباءوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُم كانوا يَكفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقتُلونَ النَّبِيّينَ بِغَيرِ الحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوا وَكانوا يَعتَدونَ﴾من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان، وتسلط الأعداء عليه. [ص٩]
[١٢] ﴿أَفَتُؤمِنونَ بِبَعضِ الكِتابِ وَتَكفُرونَ بِبَعضٍ فَما جَزاءُ مَن يَفعَلُ ذلِكَ مِنكُم إِلّا خِزيٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَيَومَ القِيامَةِ يُرَدّونَ إِلى أَشَدِّ العَذابِ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلونَ﴾من أعظم الكفر: الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه؛ لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه. [ص١٣]
[١٣] ﴿وَإِذا قيلَ لَهُم آمِنوا بِما أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نُؤمِنُ بِما أُنزِلَ عَلَينا وَيَكفُرونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا لِما مَعَهُم﴾الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أَنزل من كتب، وبجميع ما أرسل من رسل. [ص١٤]
[١٤] ﴿مَن كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبريلَ وَميكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلكافِرينَ﴾من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عادى الله تعالى. [ص١٥]
[١٥] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَقولوا راعِنا وَقولُوا انظُرنا﴾سد الذرائع من مقاصد الشريعة، فكل قول أو فعل يوهم أمورًا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. [ص١٦]
[١٦] ﴿وَمَن أَظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَن يُذكَرَ فيهَا اسمُهُ وَسَعى في خَرابِها﴾أعظم الناس جُرْمًا وأشدهم إثمًا من يصد عن سبيل الله، ويمنع من أراد فعل الخير. [ص١٨]
[١٧] ﴿وَإِذ يَرفَعُ إِبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ العَليمُ﴾المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة، بل يخاف أن ترد عليه، ولا تقبل منه، ولهذا يُكْثِرُ سؤالَ الله قَبولها. [ص٢٠]
[١٨] ﴿وَمَن يَرغَبُ عَن مِلَّةِ إِبراهيمَ إِلّا مَن سَفِهَ نَفسَهُ﴾دين إبراهيم عليه السلام هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة، لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. [ص٢٠]
[١٩] ﴿وَوَصّى بِها إِبراهيمُ بَنيهِ وَيَعقوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصطَفى لَكُمُ الدّينَ فَلا تَموتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمونَ﴾مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى، وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه. [ص٢٠]
[٢٠] ﴿سَيَقولُ السُّفَهاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلّاهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتي كانوا عَلَيها قُل لِلَّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ يَهدي مَن يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُستَقيمٍ﴾الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السَّفَه وقلَّة العقل. [ص٢٢]
[٢١] ﴿وَكَذلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا﴾فضلُ هذه الأمة وشرفها، حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم. [ص٢٢]
[٢٢] ﴿فَاذكُروني أَذكُركُم وَاشكُروا لي وَلا تَكفُرونِ﴾عظم شأن ذكر الله جلَّ وعلا حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملأ الأعلى. [ص٢٣]
[٢٣] ﴿وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصّابِرينَ﴾الابتلاء سُنَّة الله تعالى في عباده، وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. [ص٢٤]
[٢٤] ﴿إِنَّ الَّذينَ يَكتُمونَ ما أَنزَلنا مِنَ البَيِّناتِ وَالهُدى مِن بَعدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الكِتابِ أُولئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللّاعِنونَ﴾من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الَّذي أنزله الله، والتلبيس على الناس، وإضلالهم عن الهدى الَّذي جاءت به الرسل. [ص٢٤]
[٢٥] ﴿وَلَكُم فِي القِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ﴾من أعظم ما يحفظ الأنفس، ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبدأ القصاص الَّذي شرعه الله في النفس وما دونها. [ص٢٧]
[٢٦] ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ﴾وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن مُنِع عن الحرم. [ص٣٠]
[٢٧] ﴿فَإِذا قَضَيتُم مَناسِكَكُم فَاذكُرُوا اللَّهَ كَذِكرِكُم آباءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكرًا﴾مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. [ص٣١]
[٢٨] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادخُلوا فِي السِّلمِ كافَّةً﴾لا يكون المرء مسلمًا حقيقة لله تعالى حتَّى يُسَلِّم لهذا الدين كله، ويقبله ظاهرًا وباطنًا. [ص٣٢]
[٢٩] ﴿وَمَن يُبَدِّل نِعمَةَ اللَّهِ مِن بَعدِ ما جاءَتهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ﴾ترك شُكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاءً على صاحبها. [ص٣٣]
[٣٠] ﴿وَلا تَنكِحُوا المُشرِكاتِ حَتّى يُؤمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ وَلَو أَعجَبَتكُم وَلا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يُؤمِنوا وَلَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ وَلَو أَعجَبَكُم﴾تحريم النِّكَاح بين المسلمين والمشركين. [ص٣٥]
[٣١] ﴿وَلا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يُؤمِنوا﴾دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النِّكَاح؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء لمّا نهى عن تزويج المشركين. [ص٣٥]
[٣٢] ﴿نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم أَنّى شِئتُم وَقَدِّموا لِأَنفُسِكُم﴾ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله -حتَّى ما يتعلق بالملذات- إلى الدار الآخرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. [ص٣٥]
[٣٣] ﴿فَلا تَعضُلوهُنَّ أَن يَنكِحنَ أَزواجَهُنَّ﴾نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بِعَضْلِ مَوْلِيَّتِه عن الزواج، أو إجبارها على ما لا تريد. [ص٣٧]
[٣٤] ﴿وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ﴾حَفِظَ الشرع للأم حق الرضاع، وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. [ص٣٧]
[٣٥] ﴿حافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسطى وَقوموا لِلَّهِ قانِتينَ (٢٣٨) فَإِن خِفتُم فَرِجالًا أَو رُكبانًا﴾الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلَّى على ما تيسر له من الحال. [ص٣٩]
[٣٦] ﴿إِنَّ اللَّهَ اصطَفاهُ عَلَيكُم وَزادَهُ بَسطَةً فِي العِلمِ وَالجِسمِ﴾التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس؛ وهي العلم بما يكون قائدًا فيه، والقوة عليه. [ص٤٠]
[٣٧] ﴿اللَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ وَلا يَئودُهُ حِفظُهُما وَهُوَ العَلِيُّ العَظيمُ﴾آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه عز وجل. [ص٤٢]
[٣٨] ﴿أَلَم تَرَ إِلَى الَّذي حاجَّ إِبراهيمَ في رَبِّهِ أَن آتاهُ اللَّهُ المُلكَ إِذ قالَ إِبراهيمُ رَبِّيَ الَّذي يُحيي وَيُميتُ قالَ أَنا أُحيي وَأُميتُ قالَ إِبراهيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأتي بِالشَّمسِ مِنَ المَشرِقِ فَأتِ بِها مِنَ المَغرِبِ فَبُهِتَ الَّذي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ﴾مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق، وكشف ضلالهم عن الهدى. [ص٤٣]
[٣٩] ﴿الَّذينَ يُنفِقونَ أَموالَهُم في سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتبِعونَ ما أَنفَقوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه، إذا صاحبته النية الصالحة، ولم يلحقه أذى ولا مِنّة محبطة للعمل. [ص٤٤]
[٤٠] ﴿وَمَثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أَموالَهُمُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ وَتَثبيتًا مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَت أُكُلَها ضِعفَينِ فَإِن لَم يُصِبها وابِلٌ فَطَلٌّ﴾الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. [ص٤٥]
[٤١] ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تَكونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخيلٍ وَأَعنابٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ لَهُ فيها مِن كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعصارٌ فيهِ نارٌ فَاحتَرَقَت كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرونَ﴾حال المنفق ماله رياء للناس مثل هذا الرجل؛ يَرِدُ على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. [ص٤٥]
[٤٢] ﴿إِن تُبدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِن تُخفوها وَتُؤتوهَا الفُقَراءَ فَهُوَ خَيرٌ لَكُم وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُم وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ﴾إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرًا وثوابًا لأنها أقرب للإخلاص. [ص٤٦]
[٤٣] ﴿الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا لا يَقومونَ إِلّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ﴾، ﴿يَمحَقُ اللَّهُ الرِّبا﴾، ﴿فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ﴾من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. [ص٤٧]
[٤٤] ﴿وَإِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ﴾فضل الصبر على المعسر، والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدَّين أو كله. [ص٤٧]
[٤٥] ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتُبوهُ ﴾مشروعية توثيق الدَّين وسائر المعاملات المالية دفعًا للاختلاف والتنازع، ووجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وأنواع الإجارات. [ص٤٨]
[٤٦] ﴿فَإِن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا أَو ضَعيفًا أَو لا يَستَطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ﴾ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم، أو ضعف عقلهم، أو صغر سنهم. [ص٤٨]
[٤٧] ﴿وَإِن كُنتُم عَلى سَفَرٍ وَلَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهانٌ مَقبوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ أَمانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، إلا إذا وَثِقَ المتعاملون بعضهم ببعض. [ص٤٩]
[٤٨] ﴿وَلا تَكتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَن يَكتُمها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبُهُ﴾حُرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها. [ص٤٩]
[٤٩] ﴿آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤمِنونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ﴾في الآية تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله. [ص٤٩]
[٥٠] ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾قام هذا الدِّين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون. [ص٤٩]** والحمد لله رب العالمين **
صيد الفوائد
-
(1) ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أنه لا مجاملات فى العقائد، ولو مع أقرب الناس*
(( إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ))
(2)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أعظم الشرائع تكريمًا للمرأة شريعة الإسلام.*
فقد جعل الله سعي امرأة - هاجر - ركنًا من أركان الحج والعمرة، لا تصح بدونه
(3) ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أن (حسبنا الله ونعم الوكيل) كافية*
( قالها إبراهيم لما أُلقى فى النار، فكفاه الله )
(4) ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*الصبر على أذى الخلق*
قال لهم إبراهيم :
( اعبدوا الله واتقوه )
وهم قالوا :
( حَرِّقُوه )
(5) ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*من ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه*
قال تعالى (( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلًا جعلنا نبيًا ))
(6) ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أن الجزاء من جنس العمل*
فالذى قال:
( يا أبت لا تعبد الشيطان )
قِيلَ له:
( يا أبت افعل ما تؤمر )
تأمل !! نفس الألفاظ : ( يا أبت )
(7) تعلمت من قصة إبراهيم :
*أن أبدأ بدعوة أقرب الأقربين*
فقد بدأ إبراهيم لأبيه (آزر)
( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلهة )
(8)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*الأقدام التى أخلصت لله وعاشت له، يبقى أثرها.*
(( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ))
ومازالت أثر أقدام إبراهيم هناك !!
(9)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أن الناس يتفاوتون في الامتثال لطاعة لله ( عز وجل )*
يُقال للخليل: "اذبح ولدك"، فيضجعه للذبح
ويُقال لقوم موسى ( اذبحوا بقرة )
فذبحوها، وما كادوا يفعلون
*سبحان من فاوت بين الخلق !!*
(10)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أيها المريض، علق قلبك بالله.*
(( وإذا مرضت فهو يشفين ))
ليتهم يعلقونها على أبواب الصيدليات والمشافي !!
(11)- تعلمت من قصة إبراهيم :
*الامتثال لأوامر الله فيه كل خير.*
امتثل إبراهيم لأمر الله وأراد ذبح ولده، فجمع الله له ولده، وخَلَّد فعله .. الله أكبر !!
(12)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*الفزع للصلاة والدعاء حال الخوف*
لما سِيقت (سارة) للملك الجبار قام إبراهيم صلي الله عليه وسلم يصلى ويدعو، فرد الله كيد الفاجر، وأخدم هاجر
(13)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*ألا أغتر بكثرة أهل الباطل، وقلة أهل الحق*
(( فآمن له لوط ))
(14)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*بِناء المعالي فى الدنيا يجلب معالي الآخرة*
بنى إبراهيم الكعبة، فرآه نبينا مسندًا ظهره للبيت المعمور
(15)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*قد يكون هناك رجل بآلاف الرجال* .
(( إن إبراهيم كان أمة ))
يعني : إمامًا يُقتضى به، ويعلم الناس الخير
(16)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أهمية طلب الولد الصالح.*
(( رب هب لى من الصالحين ))
(17)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*إذا كنت مع الله وفعلت ما عليك، فقد تأتي أعظم النتائج مع انعدام السبب*
(( وأذن في الناس بالحج ))
نداء قاله الخليل ولا سامع، فأوصله الله لجميع المسامع !!
(18)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*الدعاء لذريتك التى لم تأتِ بعدُ من الوفاء.*
(( رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ))
(19)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*من أعظم ما يعين على الصلاة والمحافظة عليها وعدم تركها : (الدعاء)*
(( رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ))
(20)ـ تعلمت من قصة إبراهيم :
*أن تختار عتبة دارك ـ زوجتك ـ جيدًا.*
فالزوجة كثيرة الشِّكاية المُتَسخِّطة لا تصلح
( غيِّر عتبة دارك )
وكتبه / أبو عبد الله
محمد أنور مرسالصيد الفوائد
-
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60)
السؤال الأول:
المطلوب إجراء مقارنة بين قصة موسى في آيات البقرة ( 58ـ60) والقصة نفسها في آيات سورة الأعراف (160ـ 162) وهي قوله تعالى :
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ
؟
الجواب:
مقدمـــة :
سياق آيات سورة البقرة هو في تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل, بينما سياق آيات سورة الأعراف هو في مقام تقريع وتأنيب لما فعله بنو إسرائيل بعد أنْ أنجاهم الله من البحر وأغرق فرعون .
وإليك أهم الفروق التعبيرية بين السورتين :
.jpg&key=eb55167c548a55bb752800c9196ec0d5e8b61720da1f013369f391d433cad0da)
فما سر هذا الاختلاف ؟
البيان هو حسب التسلسل المذكور أعلاه :
1ـ قال في البقرة (وَإِذۡ قُلنا) [البقرة:58] وفي الأعراف (وَإِذۡ قِيلَ) [الأعراف:161] ببناء الفعل للمجهول , والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف والتكريم ومقام الخير العام والتفضل، بخلاف الشر والسوء، فإنه لا يذكر فيه نفسه تنزيهاً له عن فعل الشر وإرادة السوء.
ـ شواهد قرآنيةعلى ذكر نفسه تعالى :
المائدة [3]، النساء [72، 69] الإسراء [ 83] الفاتحة [7] الزخرف [59] الشعراء [ 78، 80] الجن [10] الكهف [79، 82 ] الحجرات [7 ] الصافات [ 6] الملك [ 5 ] الحجر [16].
ـ شواهد قرآنية على عدم ذكر نفسه تعالى :
البقرة [ 212] الرعد [33 ] الأنعام [ 122] فاطر [ 8 ] غافر [37] التوبة [37] الفتح [12].
ملاحظات :
ـ قد تجد (زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعملهُمۡ) [النمل:4] ولكن لا تجد (زينا لهم سوء أعمالهم)؛ لأنّ الله لا ينسب لنفسه السوء.
ـ تجد (ءَاتَينهُمُ ٱلكتَٰابَ) [البقرة:121] في مقام المدح والثناء، وتجد (أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ) [البقرة:101] في مقام الذم والتقريع.
ـ تجد (أَوۡرَثنَا) [فاطر:32] في مقام المدح، وتجد (أُورِثُواْ) [الشورى:14] في مقام الذم.
ـ شواهد قرآنية على (ءَاتَيۡنَا ) :
البقرة [53 ] الجاثية [16] البقرة [121، 146 ] الأنعام [20 ]الأنعام [114 ][89 ] الرعد[ 36] القصص[ 52] العنكبوت [47] النساء [54].
ـ شواهد قرآنية على (أُوتُواْ ) :
البقرة [ 101، 145] ـ آل عمران [ 19، 23، 100، 187] النساء [44، 47، 51 ] المائدة [ 57 ] التوبة [ 29 ] الحديد [16].
ـ شواهد قرآنية على (أَوۡرَثۡنَا ) :
فاطر [32 ] غافر [53]
ـ شواهد قرآنية على (أُورِثُواْ) :
الشورى [14].
وليس معنى هذا أنّ الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة، بل إنه يفعل ذلك لأنه من الخير العام , ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاً، فإنه من أكبر الخير أنْ يهلك الطغاة الظالمين (لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ) [إبراهيم:13] (ثُمَّ أَخَذۡتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ) [فاطر:26] .
2 و3 ـ قال في البقرة: (ٱدۡخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ) [البقرة:58] وقال في الأعراف : (ٱسۡكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ) [الأعراف:161] .
في البقرة المطلوب الدخول ثم الأكل مباشرة (فَكُلُواْ) [البقرة:58] بالفاء.
بينما المطلوب في الأعراف : السكن والاستقرار ثم الأكل (وَكُلُواْ) بالواو.
والدخول غير السكن؛ لأنّ السكن لا يكون إلا بعد الدخول، فجعل الطعام في البقرة مهيأ قبل السكن والاستقرار, وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب فقد يطول الزمن وقد يقصر، فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل .
4ـ قال في البقرة : (رَغَدٗا) [البقرة:58] ولم يقل ذلك في الأعراف تناسباً لتعداد النعم في البقرة ، مع ملاحظة أن كلمة (رَغَدٗا) تكررت مرتين في سورة البقرة مع قصتي آدم وموسى عليهما السلام؛ لأنّ جو البقرة جو تكريم لآدم وتكريم لذريته من بني إسرائيل, ولم تذكر الكلمة في الأعراف في القصتين؛ لأنّ جو السورة جو عقوبات وتأنيب.
ثم انظر كيف قدّم (رَغَدٗا) في الجنة وأخّرها في الدنيا، فقال في الجنة: (وَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا) [البقرة:35] وقال في الدنيا : (فَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ رَغَدٗا) [البقرة:58]؛ لأنّ الرغد في الدنيا قليل.
5 ـ في البقرة قدّم السجود على القول (وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ) [البقرة:58] وذلك لسببين:
آ ـ السجود أشرف من القول .
ب ـ السياق يقتضي ذلك، فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة، انظر آيات سورة البقرة( 43- 47 ) فناسب تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع , وكلا الأمرين مرفوع في سورة الأعراف فأخّر السجود.
6 ـ في البقرة قال: (نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡۚ) [البقرة:58] بجمع الكثرة وهو مناسب لمقام تعداد النعم , وقال في الأعراف : (خَطِيٓـَٰٔتِكُمۡۚ) [الأعراف:161] بجمع القلة وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب.
7ـ قال في البقرة: (وَسَنَزِيدُ) [البقرة:58] فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع ولم يجىء بها في سورة الأعراف.
8 ـ قال في سورة البقرة : (ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ) وقال في سورة الأعراف (ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ) وذلك لأنه سبق هذا القول في سورة الأعراف قوله تعالى : (وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٞ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ) [الأعراف:159] أي : ليسواجميعاً على هذه الشاكلة من السوء , فناسب هذا التبعيض في الآية. وجاء في ( التفسير الكبير ) أنّ سبب زيادة كلمة ( منهم ) في الأعراف أنّ أول القصة مبني على التخصيص بلفظ ( من ) كما في الآية (159 ) فذكر أنّ منهم من يفعل ذلك , ثم عدّد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم , فلمّا انتهت القصة قال تعالى : (ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ) فذكر لفظة ( منهم ) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر الكلام مطابقاً لأوله .
9ـ الفرق بين قوله تعالى في البقرة: (فَأَنزَلۡنَا) وبين قوله في الأعراف : (فَأَرۡسَلۡنَا ) أنّ الإنزال لا يشعر بالكثرة، والإرسال يشعر بها،والإرسال أشد في العقوبة من الإنزال , قال تعالى في أصحاب الفيل : (وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ٣ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۢ٥) فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيراً, والسبب أنّ سياق آيات سورة البقرة هو في تعداد النعم التي أنعم الله على بني إسرائيل, بينما مقام آيات سورة الأعراف هو مقام تقريع وتأنيب لما فعله بنو إسرائيل.
وللعلم فقد ورد لفظ ( الإرسال ) ومشتقاته في الأعراف حوالي ثلاثين مرة , وفي البقرة سبع عشرة مرة , فوضع كل لفظ في المكان الذي هو أليق بها .
10 ـ قال في البقرة: (عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٥٩) وقال في الأعراف: (عَلَيۡهِمۡ ١٦٢) وهو أعم من الأول , أي أنّ العقوبة أعم وأشمل وهو المناسب لمقام التقريع .
11ـ قال في البقرة: (يَفۡسُقُونَ ٥٩) وقال في الأعراف: (يَظۡلِمُونَ ١٦٢) والظلم أشد من الفسق، وهو المناسب لـ ( إرسال ) العذاب فذكر في كل سيلق ما يناسبه . وقد يظلم الإنسان نفسه وقد يظلم غيره، ولكنّ الفاسق هو الذي يظلم نفسه بخروجه عن طاعة الله وليس شرطاً أنْ يظلم غيره، وجاء في الحديث القدسي «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا» . والله أعلم.
تتمة النقاط وتفصيلات أخرى تجدها فيما يلي :
السؤال الثاني:
ما الفرق من الناحية البيانية بين (فَٱنفَجَرَتۡ) [البقرة:60] في سورة البقرة ، و(فَٱنۢبَجَسَتۡ) [الأعراف:160] في سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام؟
الجواب:
1ـ جاء في سورة البقرة (وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۖ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ) [البقرة:60] .
وجاء في سورة الأعراف (وَقَطَّعۡنَٰهُمُ ٱثۡنَتَيۡ عَشۡرَةَ أَسۡبَاطًا أُمَمٗاۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰهُ قَوۡمُهُۥٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۚ وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلۡغَمَٰمَ وَأَنزَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ) [الأعراف:160] .
والسؤال ماذا حدث فعلاً هل انفجرت أو انبجست؟ والجواب كلاهما، وحسب ما يقوله المفسرون: إنها انفجرت أولاً بالماء الكثير، ثم قلّ الماء بمعاصيهم.
في سياق الآيات في سورة البقرة الذي يذكر الثناء والمدح والتفضّل على بني إسرائيل جاء بالكلمة التي تدل على الكثير، فجاءت كلمة (فَٱنفَجَرَتۡ) [البقرة:60]، أمّا في سورة الأعراف فالسياق في ذمّ بني إسرائيل فذكر معها الانبجاس (فَٱنۢبَجَسَتۡ) وهو أقلّ من الانفجار, وهذا أمرٌ مشاهد فالعيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة، فقد تجفّ العيون والآبار، فذكر الانفجار في موطن والانبجاس في موطن آخر، وكلا المشهدين حصل بالفعل.
2 ـ سياق الآيات في البقرة هو في التكريم لبني إسرائيل، فذكر أموراً كثيرة في مقام التفضيل والتكرّم والتفضّل: (وَإِذۡ نَجَّيۡنَٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِيمٞ٤٩ وَإِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُٱلۡبَحۡرَ فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ وَأَغۡرَقۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ٥٠) [البقرة: 49 ،50] و (يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ) [البقرة:47] .
أمّا السياق في الأعراف فهو في ذكر ذنوبهم ومعاصيهم، والمقام مقام تقريع وتأنيب لبني إسرائيل: (وَجَٰوَزۡنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصۡنَامٖ لَّهُمۡۚ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ) [الأعراف:138] والفاء (فَأَتَوۡاْ) [الأعراف:138] هنا تفيد المباشرة، أي: بمجرد أنْ أنجاهم الله تعالى من الغرق أتوا على قوم يعبدون الأصنام فسألوا موسى أنْ يجعل لهم إلهاً مثل هؤلاء القوم.
3ـ قوم موسى استسقوه، فأوحى إليه ربه بضرب الحجر (وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ) [البقرة:60] وفيها تكريم لنبيّ الله موسى عليه السلام واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أنّ الضرب المباشر كان من الله تعالى, وفي الأعراف موسى عليه السلام هو الذي استسقى لقومه (إِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰهُ قَوۡمُهُۥٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ) [الأعراف:160].
4ـ قال في البقرة: (كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ) [البقرة:60] والشرب يحتاج إلى ماء أكثر، لذا انفجر الماء من الحجر في السياق الذي يتطلب الماء الكثير, بينما قال في الأعراف:( كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡۚ)[الأعراف:160] لم يذكر الشرب فجاء باللفظ الذي يدل على الماء الأقلّ (فَٱنۢبَجَسَتۡ) [الأعراف:160] .
5ـ في البقرة جعل الأكل عقب الدخول، وهذا من مقام النعمة والتكريم (ٱدۡخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ) [البقرة:58] والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، بينما في الأعراف لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة، وإنما أمرهم بالسكن أولاً ثم الأكل (ٱسۡكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ) [الأعراف:161] .
6ـ (رَغَدٗا) تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كما يدلّ سياق الآيات، وفي الأعراف لم يذكر (رغداً)؛ لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم .
7ـ في البقرة قال: (وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ) [البقرة:58] بُدئ به في مقام التكريم وتقديم السجود أمر مناسب للأمر بالصلاة الذي جاء في سياق السورة (وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ) [البقرة:43] والسجود هو من أشرف العبادات، بينما قال في الأعراف:
( وَقُولُواْ حِطَّةٞ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا) [الأعراف:161] لم يبدأ بالسجود هنا؛ لأنّ السجود من أقرب ما يكون العبد لربه ، وهم في السياق هنا مبعدون عن ربهم لمعاصيهم .
8ـ قال في البقرة: (نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡۚ) [البقرة:58] (الخطايا) جمع كثرة, وإذا غفر الخطايا فقد غفر الخطيئات قطعاً, وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في السورة، بينما قال في الأعراف: (نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطِيٓـَٰٔتِكُمۡۚ) [الأعراف:161] وخطيئات جمع قلّة، وجاء هنا في مقام التأنيب، وهو يتناسب مع مقام التأنيب والذّم في السورة .
9ـ (وَسَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ) [البقرة:58] إضافة الواو هنا تدل على الاهتمام والتنويع، ولذلك تأتي الواو في موطن التفضّل وذكر النعم، وفي الأعراف (سَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ) [الأعراف:161] لم ترد الواو هنا؛ لأنّ المقام ليس فيه تكريم ونعم وتفضّل.
10ـ في البقرة قال: (فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمۡ) [البقرة:59] وفي الأعراف (فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ) [الأعراف:162] هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول الآيات.
11ـ في البقرة قال:( فَأَنزَلۡنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ)[البقرة:59] وفي الأعراف قال: (فَأَرۡسَلۡنَا) [الأعراف:162] (أرسلنا) في العقوبة أشدّ من (أنزلنا)، وقد تردد الإرسال في السورة 30 مرة، أما في البقرة فتكرر 17 مرة .
12ـ في البقرة قال: (بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ) [البقرة:59] وفي الأعراف (بِمَا كَانُواْ يَظۡلِمُونَ) [الأعراف:162] والظلم أشدّ؛ لأنه يتعلّق بالنفس وبالغير.
لذلك (فَٱنفَجَرَتۡ) [البقرة:60] جاءت هنا في مقام التكريم والتفضّل، وهي دلالة على أنّ الماء بدأ بالانفجار بالماء الشديد فجاء بحالة الكثرة مع التنعيم، وجاءت (فَٱنۢبَجَسَتۡ) [الأعراف:160] في مقام التقريع؛ قلّ الماء بمعاصيهم، فناسب ذكر حالة قلّة الماء مع تقريعهم .
وخروج الماء كان كثيراً في البداية لكنه قلّ بسبب معاصيهم، وليس هذا تعارضاً كما يظن بعضهم، لكن ذكر الحالة بحسب الموقف الذي هم فيه، فلمّا كان فيهم صلاح قال: انفجرت، ولمّا كثرت معاصيهم قال: انبجست.
13ـ في الآية (وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ) [البقرة:60] موسى ضرب الحجر، لكنه لم يقل (فضرب) إذن الكلام فيه حذف، وهو مفهوم ولكن لم يذكره .
السؤال الثالث:
قال تعالى: (وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ) [البقرة:60] ولم يقل مثلاً : (وإذ استسقى موسى ربّه) ؟ أليس موسى أحد أفراد القوم ؟
الجواب:
في هذا السؤال دلالة على عناية الله تعالى بعباده الصالحين، فهذا الدعاء والاستسقاء يدلك على أنّ موسى عليه السلام لم يصبه العطش؛ لأنّ الله تعالى وقاه الجوع والظمأ، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم : «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني».
وانظر كيف كان الاستسقاء لموسى عليه السلام وحده دون قومه، فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى مثلاً : (وإذا استسقى موسى وقومه ربهم)، وذلك ليظهر لنا ربنا كرامة موسىِ عليه السلام وحده، ولئلا يظن القوم أنّ الله تعالى أجاب دعاءهم.
السؤال الرابع:
ما نوع الفاء في كلمة (فَقُلۡنَا) [البقرة:60] في الآية ؟
الجواب:
الفاء هي الفاء الفصيحة، وهي الفاء التي تبين وتفصح عن :
1 – محذوف وتدل على ما نشأ عنه مثل قوله تعالى: (وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ) [البقرة:60] وتقدير الكلام ( ... فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) .
2ـ أو تفصح عن جواب شرط محذوف، مثل قوله تعالى: (قَالَتۡ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ) [يوسف:32] و تقدير الكلام : إنْ كنتن لا تدرين فذلكن الذى لمتنني فيه .
3ـ الفاء الفصيحة لا محل لها من الإعراب .
والله أعلم .
-
الدعاء
الدكتور عثمان قدري مكانسي
الدعاء لغة : الرغبة والابتهال ورجاء الخير .
عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال :
(( . . . . . ثم صلى بنا ، ثم دعا لنا ـ أهل البيت ـ بكل خير من خير الدنيا والآخرة .
فقالت أمي : يا رسول الله ، خُويدمك ، ادع الله له . فدعا لي بكل خير . . . وكان في آخر دعائه أن قال : اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له ))( 1 ) .
فيجمل بالداعية أن يدعو لإخوانه ، ويرجو لهم الخير . . وليكن دعاؤه سراً وجهراً . . أما سراً : فلأنه أقرب للصدق ، وأبعد عن حظ النفس ، والداعية لا يبغي من دعائه للآخرين التقرب إليهم فقط ، إنما يريد أن يرضى الله عنهم حقاً ويجتهد في ذلك .
وأما جهراً : فليبيـّنَ لهم إنه يحبهم فتتآلف القلوب ، وتتوطد الصلة .
وفي هذا الحديث نجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل بيت أنس رضي الله عنه دون أن يطلبوا ذلك ، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه سكن للمسلمين ، وخير وبركة ، وهذا يسرهم ويزيدهم تعلقاً به ، وإيماناً بدعوته ، واستزادة من دعائه ،
ونرى ( أم أنس ) تسأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم أن يخص أنساً بالدعاء ، فيفعل ، ويدعو له بالبركة في العمر والمال .
ويظهر أثر ذلك الدعاء الكريم ، فقد عاش أنس رضي الله عنه فوق المائة ، ورأى أكثر من ثمانين من أحفاده ، وكان له بستان يثمر في السنة مرتين . . كل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم .
ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يزورهم ، لقد تعلم من ربه سبحانه ذلك :
فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى : طبتَ وطاب ممشاك ، وتبوأت منزلاً في الجنة ))(2) .
ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم من نطعم عنده بالدعاء والصلاة في بيته ، وكأنك تقول لمن دعاك : أحسنت إلى ضيفانك ، وأكرمتهم ، فجعل الله بيتك طاهراً ، وحياتك طاهرة ، والملائكة زوارَك ، وأبعد عنك السوء ، ووقاك الشياطين وأذاهم .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار ، فطعم عندهم طعاماً ، فلما خرج ، أمر بمكان من البيت ، فنضح له على بساط فصلى عليه ، ودعا لهم ( 3 ) .
ولو جاءك رجل لا تعرفه يعودك ـ وأنت مريض لا سمح الله ـ مع أخ لك عزيز ، وكلمك بأدب ، ولم يطل الجلوس عندك ، ولما قام مودعاً جلس قريباً منك ، ثم دعا الله أن يشفيك ويرد عافيتك ، ثم ابتسم وسلم ومضى ، أكنت تعجب لصنيعه ؟ ويكبر في عينك ؟ وتشكر له ما فعل ؟ .
لا شك في ذلك ، وأراك تسأل صاحبك عنه ، تريد أن تتعرف إليه ، هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ عاد مريضاً جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات (( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )) ( 4 ) .
دعاء مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العطوف المحب لأمته ، هاديهم إلى الجنة ، وذابّهم عن النار ، يجلس عند رأس المريض ، قريباً إلى قلبه ، يسأل رب العرش العظيم وفاطر السموات والأرض الرحيم بعباده ، أن يشفيه .
دعاء من كريم إلى كريم !! . . وتفتح السماء أبوابها. . وتحمل الملائكة الدعاء . . وتعود بالشفاء . . الشفاء لجسم المريض من العلة ، والشفاء لقلبه من أدران الدنيا . .
ويكبر النبي المعلم الأول في عيون أصحابه . . وهو كبير كبير . . وتتفتح قلوبهم لشرعته السمحاء ولصاحبها معلم الناس الخير .
وهذا فـَضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفضالة ؟
قال : نعم فضالة يا رسول الله .
قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ ( وكان الله تعالى قد أطلع نبيه على دخيلته ) .
قال : لا شيء . . كنت أذكر الله . ( كذب ليداري انفعاله من المفاجأة ) .
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ( ولم يفضَحه لأنه يريده مسلماً ) ثم قال : استغفِرِ الله . ثم وضع يده على صدره فسكن . ( يد رسول الله الشريفة الطاهرة تعكس زاوية الحقد في قلب فضالة مئة وثمانين درجة إلى الحب والإكبار ، ويدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية ) .
قال فضالة : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله أحبُّ إلي منه صلى الله عليه وسلم ـ .
ومع تغيير القلب من الحقد والبغضاء إلى الحب والإجلال ، تتغير الأفعال من الشر إلى الخير ، ومن الزنا إلى الطهر والعفاف : ألم يدْعُ رسول الله له ؟ ؟ ألم يضعْ يده الشريفة على صدره فسكن ؟؟ .
قال فضالة : فرجعت إلى أهلي ، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها ،
فقالت : هلم إلى الحديث . ( وأي حديث بين رجل وامرأة كل منهما غريب عن الآخر ؟! . . )
فقلت : لا . . ( قالها وهو يشعر بالإيمان يغمره ، والضياء يعمره ، فقد انقلب إنساناً آخر ، إنساناً مؤمناً يبعد عن الزنا بُعْدَ السماء عن الأرض ) ، فما له – بعد لقائه بالحبيب – أربٌ بالفساد ، وما عاد يُسيغُه .
وانبعث فضالة يقول ( معلناً حلاوة الإيمان ) :
قالت : هلم إلى الحديث فقلت : لا * يــأبـــى علــيــك الله والإســـــلام
لــو مـا رأيـت مـحـمـداً وقـبـيـلــه * بـالــفـتـح يـوم تـكســر الأصـنــام
لـرأيـت ديـن الله أضــحــى بـيـنـاً * والشرك يعلو وجهـه الإظلام ( 5 )
- وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يدعو بعضهم لبعض ، فما بينهم وبين الله حجاب ، فعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن خير التابعين رجل يقال له أوَيْس ، وله والدة ، كان به بياض ( أي برص ) فمروه فليستغفر لكم )) ( 6 ) .
وكان الرجل من اليمن . . وكلما جاء وفد من اليمن في خلافة الفاروق سأل أمير المؤمنين عمر عن أوَيْس ، حتى رآه ، ورآى فيه الصفات التي ذكرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ووصفه وأمره أن يدعو للمسلمين . .
ويدعو أويس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وللمسلمين . .
وأنا – الفقير إلى رحمة الله وعفوه - أرجو أن يدعو كل أخ لأخيه وللمسلمين . .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابـه
الـلـهـم انـصـر الإسلام والمسلـميـن
واعــز كــلــمــة الــحــق والــديـــن
خـــذ بــنــواصــــيــنــا إلـى الـحــق
وعـــوِّدْ ألـسـنـتـنـا قـول الـصــــدق
إلـيـك لـجـأنــا فـلا تـردنــا خـائـبـين
يــــــــا أرحـــــــم الــراحــــمـــيـــن
الهوامش :
( 1 ) رواه البخاري في الأدب المفرد الحديث / 88 / .
(2) رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، وابن حبان ، والبخاري في الأدب المفرد الحديث / 345 / .
( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه (( كتاب الأدب )) ، وفي الأدب المفرد الحديث / 347 / .
( 4 ) الأدب المفرد الحديث / 536 / .
( 5 ) مختصر سيرة ابن هشام : لعفيف الزعبي ، وعبد الحميد الأحدب ص/ 235 .
( 6 ) من رياض الصالحين ، رواه مسلم الحديث / 370 / . -
بكلمة أثابهم (فأَثابهم الله بما قالوا)وبكلمة لعنهم ( ولُعِنُوا بما قالوا )إحذر كلماتك
مهما بلغت قوتك وجبروتك؛ فقد تحتاج من هو أضعف منك؛ لينقذك من ورطتك، ويرسم لك سبيل الخلاص: “فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي”.
{فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا}اعلم أن النصر مع الصبر
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ)المحروم من إبصار الحق لا ينفع معه إيراد كل دليل ولا إظهار كل برهان، فمن عمي قلبه لا تدرك الحق عينه ..
(وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)كف عينك عن رزق غيرك .. تُرزق
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ..}كفارة الحنث باليمين بالترتيب :- إطعام عشرة مساكين
- أو كسوتهم
- أو عتق رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
اليمين يجب أن يصان عن الحلف الكاذب، وعن كثرة الأيمان، ويحفظ -إذا حلف- عن الحنث فيهـا
أشرف وأعز غاية وأعظم وجهةوجه الله ، سبحانه( يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام 52
ما تحصده أجسادنا من الطاعات تحرقه ألسنتنا من الزلات ، فالصمت والتغافل منهج الصالحين لذا قل خيراً أو أصمت فسلامة المرء بين فكيه(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
(ونبلوكم بالشر والخير فتنةً)
ما دمت في هذه الحياة فلن يفارقك البلاء؛ حتى في أجمل أوقاتك، فَوَطِن نفسك على الصبر دائماً..
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله).
فاللهم ارزقنا الشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنةٌ مضلة.
لا تظنّ أنّ التّذكير بالموت لتموت وأنت حي!
وإنما لتحيا حياة طيبة قبل الموت، وتحيا حياة النعيم بعد الموت.
تَذَكُّرُ الموتِ حياة والاغترار بالحياة موت.
(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)
{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. . وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ..}
الداء والدواء معًا في نفس الآية
كانوا في أول النهار سحرة!
وفي آخره شهداء!!وبعضنا يقرر عن الله أن فلان في النار وفلان في الجنة!الغيب لله وخواتيم الأمور لا نعلمها، أرجوك قل خيراً او اصمت..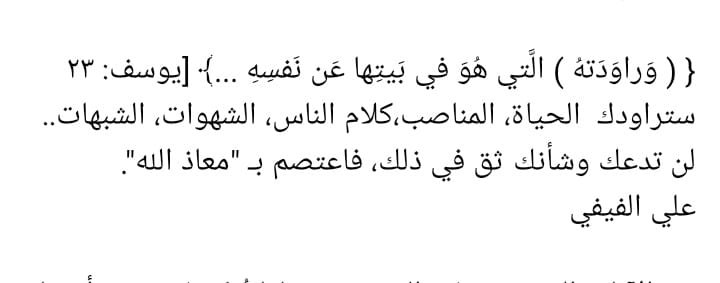
-
لأن خَلْق الله آيات، وكلامه آيات، وفِعله آيات؛ وَجَبَ علينا أن نتدبّر تلك الآيات، لنفهم ونعقل، ثم نعمل وفق ما فهمناه وعقلناه..
لم يبقَ أحدٌ من صغير أو كبير، في هذه الشدائد المتلاحقة، إلا سأل هذا السؤال:
لماذا؟
لماذا يقع كل هذا العذاب؟
ما الحكمة من تواتر الابتلاءات؟
ما المطلوب أن نفهمه مما عجزنا عن استيعابه؟
لن أبحث بعيداً، ولن أستعين بتحليلات خبراء السياسة والاقتصاد والأمن، بل سأمدّ يدي قريباً مني، وأمسك كتاب ربي، الذي يقول فيه: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء)، لأفتّش عن أجوبة تلك الأسئلة..
ما علّة حدوث تلك الهزات العنيفة؟! ولِمَ تظهر كل تلك "السيئات" في ساحتنا؟!
بحثتُ عن كلمة "فساد"، وعن كلمة "عذاب"، و"هلاك"، و"بلاء"، و"آية"، و"آيات"..
فتعالوا معي، لنرصدَ نتائج البحث، لعلنا نصل إلى الكلمة المفتاحية..
في سورة الأعراف الآية 168، يقول الله تعالى: (وبلوناهم بالحسنات والسيئات، لعلهم يرجعون)، وفي سورة الروم الآية 41، يقول تعالى: (ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس، لنُذيقهم بعض الذي عملوا، لعلهم يرجعون)، وفي سورة الزخرف الآية 48، يقول عزّ من قائل: (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب، لعلهم يرجعون)، وفي سورة الأحقاف الآية 27، يقول ربّنا: (ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وصرّفنا الآيات، لعلهم يرجعون)..
يبدو جليّاً لكل ذي بصرٍ وبصيرة، ونتيجة هذا البحث، أنّ العبرة من كل ما يحدث، قد اختُصِر في جملة مكررة، لا تحتمل التأويل، ولا تحتاج إلى تفسير، الجملة مفادها: (لعلهم يرجعون)..
وهنا يأتي السؤال المهم: نرجع إلى أين؟
نرجع إلى (ما كان) بصيغته الأصلية: إلى الفطرة التي فَطرَ اللهُ الناسَ عليها، وإلى الصبغة التي أحْسَنَها اللهُ فينا.. أن نرجع عن الشهادة التي زوّرناها، والإقرار الذي عارضناه، إلى العهد الذي نقضناه، إلى الاعتراف الذي نسيناه..
فهل تذكرون (ما كان)، حتى نرجع إليه؟!
وهنا أيضاً لن أستعين بكلام أحد من البشر، لأن في كلام رب البشر ما يُغني، فإنّ (ما كان) منصوص عليه بوضوح في قوله تعالى: (وإذْ أخذَ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريَّتهم، وأشهدهم على أنفسهم: ألستُ بربّكم؟، قالوا: بلى، شهدنا، أن تقولوا إنّا كنا عن هذا غافلين!)
إذن، (لعلهم يرجعون) إلى الله، إلى من شهدوا له بأنّه ربهم؛ عودة كاملة شاملة، لا مُجزّأة أو مقطّعة!
فمن رجع قلبه، ولم ترجع يداه، فما هو براجع!
ومن رجع عقله، ولم يرجع لسانه، فما هو براجع!
ومن رجع سمعه وبصره، ولم ترجع رجلاه فما هو براجع!
ومن رجع أمله، ولم يرجع عمله، فما هو براجع!
ومن رجع ضميره، ولم يُرجع حقوق الناس، فما هو براجع!
فإذا رجعنا، فإننا حتماً سنهدم الفساد، وسنحارب الظلم، وسنقف في وجه الطغاة، وسنقطع دابرالمعتدين، وسنردّ الحقوق، وسنقيم دولة العدالة والكرامة، في صدورنا، وعلى أرضنا..
ولكل من يريد أن يحقق الحكمة مما يحدث، فما عليه إلا أن يأخذ خطوات إلى "الوراء السليم"، على اعتبار أنّ كلّ الأحداث التي تمرّ بنا، إنما هي مفترقات طرق، تدفعنا دفعاً نحو الوراء السليم، الذي سنسلم معه جميعاً، بدل الواقع السقيم، الذي نعاني منه جميعاً أيضاً..
اختبارات متنوعة (حسنات وسيئات)، الهدف منها أن تعيدنا دوماً إلى الله، وأن ترجعنا إلى "سكة السلامة" من خلال "العذاب الأدنى"، قبل أن نصل إلى محطة اللاعودة، هناك حيث "العذاب الأكبر"، الذي لا مفرّ منه لمن لا يصحح مساره في الدنيا، ولمن لا يفهم الرسالة من مقادير الله..
وعلى الرغم من قساوة تصاريف الدهر، إلا أنها صور من الرحمة الربانية، واللطف الإلهي، لكل من تدبر ووعى: (ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون) السجدة- 21.
رابطة العلماء المسلمين
هنادي الشيخ نجيب
-
(وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ)
السؤال الأول:
ما دلالة الاختلاف في الشفاعة والعدل بين آيتي سورة البقرة (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) [البقرة:48] و (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ١٢٣) [البقرة:123] ؟
الجواب:
العدل معناه: ما يعادل الجُرم الذي هو الفدية.
وإيصال هذا المال أو المبلغ لمستحقه في حال قيام الإنسان بجريمة أو ما شابه لأهل المرتكب عليه الجريمة أو الشخص نفسه، هذا الإيصال له أسلوبان:
1ـ الأول أنْ يرسل وفدَ صُلحٍ وشفاعة حتى يقبلوا ما يقدِّمه لهم فيبدؤوا أولاً بإرسال الوفد ثم يذهب بالفدية أو المقابل.
2ـ والصورة الأخرى أنْ يذهب ابتداء فيقدم ما عنده، فإذا رفض يذهب ويأتي بوسطاء يشفعون له.
والآيتان كل واحدة منهما نظرت إلى صورة, فنفى الصورتين عن القبول فيما يتعلق بالأمم التي آمنت قبل اليهود بشكل خاص حتى يؤمنوا بالله تعالى ورسوله محمد وبكتابه:
آ ـ الآية الأولى (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) [البقرة:48] هذه الصورة الأولى تقدمون الشفاعة، و الشفاعة لا تقبل، والفدية لا تؤخذ.
ب ـ الآية (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ١٢٣) [البقرة:123] هذه الصورة الثانية.
والجمع بين الآيتين على بُعد ما بينهما أنه كل آية نظرت في صورة , فالأولى نظرت في صورة والثانية نظرت في صورة , ومع ذلك انتفت كلتا الصورتين, وهذا يعني أنه لا يمكن أنْ يقبل منكم إلا أنْ تتبعوا هذا النبي الكريم محمداً ﷺ, وبدون ذلك لا تقدموا الشفاعة ابتداء ولا تأتوا بالشفاعة لأنً هذا كله لا يُقبل , والذي يقبل منكم هو الإيمان بالرسول محمد عليه السلام والقرآن الكريم .
وكأنّ ذلك نوع من التيئيس؛ لأنّ الإنسان إذا ارتكب جرماً إمّا أن يذهب بالعدل ،أي: المال المقابل للجرم إلى القبيلة، فإذا رُفِض يذهب ويأتي بالشفعاء، أو العكس يأتي بالشفعاء أولاً حتى يقبلوا العدل منه.
والقرآن الكريم يأَّس بني إسرائيل من الحالتين: لا يقبل منكم عدل ابتداء وبعده شفاعة, ولا شفاعة ابتداء ثم يأتي العدل بعد ذلك , ولا ينفعكم إلا أنْ تتبعوا محمداً ﷺ.
ملخص الجواب للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى :
1ـ المعنى العام :
بشكل عام الخطاب للكفار والآية نازلة فيهم , أمّا المؤمنون فلهم الشفاعة رزقنا الله تعالى إياها وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة .
والعربي الذي يقع في كريهة يحاول أعوانه الدفاع عنه بمقتضى الحمية، فإنْ لم يستطيعوا حاولوا بالملاينة بدل المخاشنة، فإنْ لم تغن عنه الحالتان لم يبق عنده إلا فداء الشيء بالمال, فإنْ تعذر ذلك تعلل بما يرجوه من شفاعة الأخلاء والإخوان .
ومن كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفدية، ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة.
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغني شيء من هذه الأمور عن المجرمين في الآخرة.
2ـ المعاني اللغوية :
آـ (يَوۡمٗا) [البقرة:48] : هو يوم القيامة وهو بذاته لا يُتَّقى فلا بد منه, وإنما المقصود اتقاء ما يحصل في ذلك اليوم من الشدائد والعقاب.
ب ـ الشفاعة: ضم غيره إلى وسيلته, والشفع ضد الوتر؛ لأنّ الشفيع ينضم إلى الطالب في تحصيل ما يطلب فيصبح شفعاً بعد أنْ كان وتراً .
ج ـ العَدل : هو الفدية، وأصله ما يساوي الشيء قيمة وقدراً وإنْ لم يكن من جنسه.
والعِدل والعديل : هو المِثلُ أو هو المساوي للشيءِ في الجنسِ والجرمِ، تقول : عندي عِدلُ شاتِكَ أو عِدلُ غلامِكَ إذا كان شاة تعدل شاة، وغلاماً يعدل غلاماً , فإن أردت قيمَتَه من غير جنسه فتحتَ العَين.
والعَدلُ ضِدُّ الجورِ، والعديلُ الذي يعادِلُك في القدر والوزن.
د ـ (وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) : أي ليس لهم من يمنعهم وينجّيهم من عذاب الله.
هـ ـ جزى : بمعنى قضى، وقضاء الحقوق يوم القيامة إنما يقع في الحسنات.
سؤال :
هل الفائدة من قوله تعالى (لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا) [البقرة:48] هي نفس الفائدة من قوله: (وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨﴾ [البقرة:48] ؟
جواب :
معنى القسم الأول من الآية (لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا) [البقرة:48] أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء , وأمّا النصرة فهي أنْ يحاول تخليصه من حكم المعاقِب.
سؤال :
قدّم المولى عز وجل (الشفاعة ) على ( العدل ) في الآية ( 48 )، بينما قدّم (العدل ) على ( الشفاعة ) في الآية (123 )، فما الحكمة من التقديم والتأخير؟
جواب :
آ ـ الآيتان المذكورتان في نفس السورة، وهما :
الآية الأولى (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) [البقرة:48].
الآية الثانية (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ١٢٣) [البقرة:123].
والملاحظ أنّ صدر الآيتين واحدٌ وعجزهما مختلف أي :
.jpg&key=7250536a197e07ddacd63e5b04f8543dee6433bf5c1ab8c7915762daad2814ad)
ب ـ الآيتان [ 48 ] و[123 ] سبق كلٌ منهما نفس الآية أي أنّ الآية [ 47 ] و [122 ] هي نفسها؛ وبيان ذلك: قال تعالى:
(يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ٤٧) [البقرة:47].
(َٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ١٢٢) [البقرة:122].
والمقصود بـ (وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ) أي: على عالمي زمانكم , وهو من باب عطف الخاص على العام؛ لأنّ النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكور على عالمي زمانهم بما أعطوا من الملك والرسل والكتب في زمانهم ؛ فإن لكل زمان عالماً .
ج ـ والحق أن أمة الرسول ﷺ هي أفضل منهم؛ لأنّ الله أشهد بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال: (وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ) وأشهد المسلمين فضل نفسه؛ قال تعالى: (قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ٥٨) [يونس:58] وشتان مَن مشهوده فضل ربه، ومن مشهوده فضل نفسه .
قال رسول الله ﷺ : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» .
والله يقول : (كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ ١١٠) [آل عمران:110] .
فالحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً.
د ـ سياق الآيات التي قبلها :
لقد سبق الآية 48 الآيات من [48:40] وهي قوله تعالى :
(يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ٤٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۢ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بَِٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ٤١ وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ٤٢ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ٤٣ ۞أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ٤٤ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ٤٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ٤٦ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ٤٧ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) [البقرة:48:40] .
وهذه الآيات تؤكد كمال غفلة بني إسرائيل عن القيام بحقوق النعم التي أنعم الله عليهم بها وليربط بما بعده من الوعيد الشديد بالترغيب والترهيب , فذكّرهم بنعمه أولاً ثم عطف على تحذيرهم من طول نقمه بهم يوم القيامة إنْ لم يؤمنوا برسوله ﷺ ويتابعوه على ما بعثه به , فإنه لا تنفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباً، كما قال تعالى: ( مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ ٢٥٤) [البقرة:254] .
أمّا الآية الآية[122] المذكورة سابقا؛ ففيها تكرير التذكير لبني إسرائيل وحثهم على اتباع الرسول الأمي ﷺ الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه، وأنْ لا يحملهم الحسد للعرب على مخالفته وتكذيبه .
هـ ـ نعود الآن إلى أصل السؤال :
1ـ نلاحظ في قوله تعالى (لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا) [البقرة:48] أي: هناك نفسان نفس جازية، والثانية مجزي عنها .
2ـ ففي الآية [48] المعنى العام لها أنه سيأتي إنسان صالح ـ حتى تقبل شفاعته عند الله ـ فيقول: يا رب أنا سأشفع لفلان أو أقضي حق فلان .
فنفس الإنسان الصالح جازية والأخرى مجزي عنها, لكن لا تقبل شفاعته؛ لأنه يشفع لكافر وبالتالي لا يؤخذ منه عدل، أي: فدية، ولا يسمح بأي مساومة أخرى .
ففي هذه الآية بدأ عجزها بالشفاعة، وهي تعود على النفس الأولى في الآية .
3ـ أما الآية الثانية [123] فيتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزي عنها قبل أنْ تستشفع بغيرها وتطلب منه أنْ يشفع لها, بعد أنْ يكون قد ضاق بالكافر الحيل وهذا اعتراف بعجزه فيقول يارب : ماذا أفعل حتى أكّفر عن ذنوبي، فلا يقبل منه , كما في قوله تعالى في سورة السجدة الآية [12]: (وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَٱرۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ١٢) [السجدة:12] فيكون رد الحق سبحانه كما في الآية [14] (فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَٰكُمۡۖ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡخُلۡدِ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ١٤) [السجدة:14] .
فهم عرضوا على ربهم أن يكّفروا عن سيئاتهم بأنْ يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فلم يقبل الله منهم هذا العرض, وكما في قوله تعالى في سورة الأعراف: ( فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ قَدۡ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ٥٣) [الأعراف:53] حيث خرج الاستفهام إلى النفي، أي: ما لنا من شفعاء .
وجاء بـ (قد) والفعل الماضي (قَدۡ خَسِرُوٓاْ) لتأكيد النتيجة النهائية، وهي الخسران.
لذلك هنا النفس المجزي عنها هي التي تطلب التكفير والفداء فبدأ عجزها بـ(عَدۡلٞ) .
4ـ الملخص:
النفس الأولى: الجازية يناسبها الآية الأولى؛ لأنها بدأت بطلب الشفاعة ,أمّا النفس الثانية: المجزي عنها, فيناسبها الآية الثانية؛ لأنها بدأت بتقديـم الفداء .
5ـ والمعنى العام للآيتين أنّ الله تعالى لا يقبل ممن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذ ولا يخلّص منه أحد ولا يجير منه أحد , وصار الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه للكافرين الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها , وكما قال تعالى في القران الكريم :
(إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ١٦١) [البقرة:161].
(إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفۡتَدُواْ بِهِۦ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنۡهُمۡۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ٣٦) [المائدة:36].
(فَٱلۡيَوۡمَ لَا يُؤۡخَذُ مِنكُمۡ فِدۡيَةٞ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ مَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُۖ هِيَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ١٥) [الحديد:15].
( َإِن تَعۡدِلۡ كُلَّ عَدۡلٖ لَّا يُؤۡخَذۡ مِنۡهَآۗ ٧٠) [الأنعام:70].
(فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ١٠) [الطارق:10] .
( وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ ٨٨) [المؤمنون:88].
(فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ٢٥ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ٢٦) [الفجر:25-26] .
(مَا لَكُمۡ لَا تَنَاصَرُونَ٢٥ بَلۡ هُمُ ٱلۡيَوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ٢٦) [الصافات:25-26].
(فَلَوۡلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرۡبَانًا ءَالِهَةَۢۖ بَلۡ ضَلُّواْ عَنۡهُمۡۚ ٢٨) [الأحقاف:28] .
(وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) [البقرة:48].
(وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَٱرۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ١٢) [السجدة:12] .
السؤال الثاني:
ماذا عن تذكير وتأنيث لفظة (شَفَٰعَةٞ) في القرآن الكريم ؟
الجواب:
1ـ في آية البقرة [48] قوله تعالى (وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ) [البقرة:48].
آ ـ ذكّر الفعل (يُقۡبَلُ) مع الشفاعة؛ لأنّ الشفاعة هنا لمن سيشفع، أي: للشافع وهو مذكر .
ب ـ الشفاعة ليست مؤنثة حتى تكون الشفاعة مطلقة .
ج ـ إذا فصلت بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي يجوز التذكير والتأنيث، تقول : ذهب إلى الجامعة فاطمة, وذهبت إلى الجامعة فاطمة، هكذا إذا كان هناك فصل، لكنْ : ذهبت فاطمة لا يجوز غير هذا: ذهبت فاطمة.
د ـ أمّا المؤنث المجازي، فتقول: طلعت الشمس، وطلع الشمس، ابتداء فهذا مؤنث مجازي .
2ـ في آية البقرة[ 123] أنّث الفعل، فقال: ( وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ ١٢٣) [البقرة:123] ؛لأنّ المقصود هي الشفاعة نفسها وليس الكلام عن الشفيع .
3ـ في آيات يس 23 قوله تعالى: ( لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ٢٣) [يس:23] والنجم [26] قوله تعالى : ( لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيًۡٔا ٓ٢٦) [النجم:26] أنّث الفعل؛ لأنّ المقصود هي الشفاعة نفسها.
السؤال الثالث:
قال تعالى فى سورة لقمان: ( وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمٗا لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ ٣٣) [لقمان:33] وفي البقرة قال: (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا) [البقرة:48] . فما الفرق بين الوالد والولد والنفس؟
الجواب:
1ـ لا ننسى أنه في سورة لقمان ذكر الوالدين والوصية بهما ( وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ ١٥) [لقمان:15] والسورة تحمل اسم لقمان (وَالِدٌ) وهي مأخوذة من موقف لقمان وموعظته لابنه وكيف أوصاه, ووصية ربنا بالوالدين ، وقد وردت ضمن وصية لقمان لابنه، إذن هذه أنسب أولاً مع اسم السورة ومع ما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفاً .
2ـ في البقرة لم يذكر هذا، وإنما جاءت كلمة (نفس) عامة تقع على الروح وعلى الذات .
3ـ وذكر الوالد والولد في آية لقمان مناسب لما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر، مع ملاحظة أن قوله تعالى: ( وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ) [لقمان:15] خاص بالدنيا، بينما في هذه الآية (لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ) [لقمان:33] الأمر متعلق بالآخرة الآخرة, لذلك يتبين أنّ المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما وما وصّى به في السورة لا يمتد إلى الآخرة, وأنّ هذه المصاحبة ستنقطع في الدنيا، وهي ليست في أمور الآخرة .
إذن هذه مناسبة لقطع أطماع الوالدين المشركين في الحصول على نفع ولدهما إن كان مؤمنا أو دفعه شيئا عنهما في الآخرة, إضافة إلى أنها مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الوالدين والأمر بالمصاحبة لهما ونحوه.
السؤال الرابع:
ما دلالة حذف العائد المقدر (فيه) مع الآيات عندما يستعمل الفعل (يجزي) كما في آية البقرة[ 48] (لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ) [البقرة:48] وآية لقمان (وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمٗا لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ ٣٣ ) [لقمان:33] وآية البقرة [123] (لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ) [البقرة:123] بينما ذُكرت (فيه) مع آيات أخرى، كما في آية البقرة (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١ ) [البقرة:281] وآية النور (يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ٣٧) [النور:37] فما الفرق ؟
الجواب:
آ ـ جملة الصفة عادة يكون فيها عائد أي (ضمير) يعود على الموصوف قد يكون مذكوراً وقد يكون مقدّراً، وهنا مقدر, أي: أن النحاة يقدرون : لا يجزي فيه, هذا من حيث التقدير، وهو جائز الذكر وجائز التقدير؛لأنه ذكرها في مواطن أخرى: (وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ) [البقرة:281] فالأمران جائزان، وقد ذكرا في مواطن.
ب ـ يبقى لماذا اختار عدم الذكر؟ والجواب أنّ الحذف عادة يفيد الإطلاق عموماً، فعندما تقول : فلان يسمعك أو فلان يسمع، (يسمع) أعم، يقول الحق أو يقول، (يقول): أعم، يعطي المال أو يعطي، يعطي أعمّ. وعدم ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق، إذن هو الآن أظهر التعبير بمظهر الإطلاق ولم يذكر (فيه)؛ لأنه أظهره بمظهر الإطلاق.
ج ـ يبقى السؤال لماذا لم يذكر هنا و ذكر في مواطن أخرى؟
والجواب: لو (جزى فيه) والد عن ولده , أي لو دفع ( في ) يوم القيامة هل هذا الجزاء يختص بهذا اليوم أو بما بعده؟ والجواب: هو بذلك اليوم.
ولو (جزى) والد عن ولده بدون( فيه) لو جزى عنه يعني لو قضى عنه ما عليه، هذا الجزاء سيكون الجنة , والجزاء ليس في ذلك الوقت وإنما أثر الجزاء سيمتد، أي أنّ الجزاء سيكون في هذا اليوم ولكنّ الأثر هو باق، ولذلك حيث قال: (لَّا يَجۡزِي) لم يقل فيه ) في كل القرآن.
فيه ) في كل القرآن.
شواهد قرآنية بدون ( فيه
(وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ٤٨) [البقرة:48] ما قال (فيه).
(وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ١٢٣) [البقرة:123] ما قال (فيه).
شواهد قرآنية مع ( فيه
(وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١) [البقرة:281] أي تُوَفَّى في ذلك اليوم ؛ فإمّا يذهب للجنة وإمّا إلى النار.
(يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ٣٧) [النور:37] في ذلك اليوم وبعدها ليس فيه تقلب؛ لأنه يذهب للجنة، وذِكر (فيه) خصصها باليوم فقط .
ولمّا قال: (ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ) [البقرة:281] هذا في يوم القيامة وليس مستمراً يومياً، والذي في الجنة تُوُفِّيَ عمله والذي في النار تُوُفِّيَ عمله، والتَّوفِّي هو في يوم القيامة وأثر التَّوفيةِ إمّا يذهب إلى الجنة وإمّا إلى النار، وتقلُّبُ القلوب والأبصار هو في يوم القيامة ثم يذهب أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النارإلى النار، ولا يعود هناك تقلب قلوب ولا أبصار.
ولو جزى والدٌ عن ولده لكان أثر الجزاء ليس خاصاً في ذلك اليوم، وإنما يمتد إلى الخلود إلى الأبد، ولذلك لم يذكر (فيه) وأخرجه مخرج الإطلاق، لذلك حيث قال: (لا تجزي) ولم يقل (فيه) يكون لنفي المتعلق وإطلاق الأمر.والله أعلم .
-
القاعدة الثلاثون : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ }
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية، وقاعدة إيمانية، تمتد جذورها في قلوب الموحدين، في غابر الزمان وحاضره، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق:3] والمعنى:
أن من توكل على ربه ومولاه في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وفعل ما أمر به من الأسباب، مع كمال الثقة بتسهيل ذلك، وتيسيره { فَهُوَ حَسْبُهُ } أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به [ينظر: تفسير السعدي: [869]].
أيها القراء الكرام:
إن هذه القاعدة القرآنية: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } جاءت في سياق الحديث عن آيات الطلاق في سورة الطلاق، لبيان جملة من المبشرات التي تنتظر من طبق شرع الله في أمر الطلاق، فقال تعالى:
{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)} [الطلاق].
وأما مناسبة مجيء هذا المعنى بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق، فلعل السر ـوالله أعلم ـ هو تضمنها للتحذير والتطمين!
أما التحذير، فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له نفسه مجاوزة حدود الله تعالى في أمر الطلاق، سواء فيما يتعلق بالعدة، أو النفقة، أو غير ذلك، خصوصًا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونةً، وغير منضبطةٍ في تصرفاتها، وقد تتصرف بما تمليه حالة الغضب، بلا تجرد ولا إنصاف!
وأما تضمن هذه القاعدة للتطمين، فهي لمن صدق مع الله في تطبيق شرع ربه في أمر الطلاق، وأنه وإن كيد به أو له، فإن الله معه، وناصره، وحافظ حقه، ودافع كيد من يريد به كيداً، والله أعلم بمراده.
ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق ـكما أسلفتُ ـ إلا أن معناها أعم وأشمل من أن يختصر في هذا الموضوع، وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث عن التوكل، وفضله، والثناء على أهله، وأثره على حياة العبد، وقبل الإشارة المجملة إلى ذلك، يحسن التذكير بأن النصوص دلّت على أن من كمال التوكلِ فعلَ الأسباب، وهذا بين ظاهرٌ، لكن نبه عليه؛ لأن بعض الناس قد يظن خطأ أن التوكل يعني تعطيل الأسباب، وهذا غلط بيّن، ومن تأمل قصة موسى عليه السلام لما واجه البحر، وقصة مريم عليها السلام لما ولدت، وغيرهم من الأولياء والصالحين، يجد أنهم جميعًا أمروا بفعل أدنى سبب، فموسى أمر بضرب الحجر، ومريم أمرت بهز الجذع، وما أحسن ما قيل:
"الالتفاتُ إلى الأسباب بالكلية شركٌ منافٍ للتوحيد، وإنكار أن تكون أسبابًا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، والإعراضُ عنها ـمع العلم بكونها أسبابًا نقصان في العقل ـ وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة" [المصدر السابق [1/244] بتصرف].
معشر القراء الفضلاء:
إنّ التّوكّل على اللّه عزّ وجلّ مطلوب في كلّ شئون الحياة، بيد أنّ هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحضّ على التّوكّل والأمر به للمصطفى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين!
فيا أيها المؤمن :
1- إن طلبت النّصر والفرج فتوكّل عليه:
{ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)} [آل عمران].
2- إذا أعرضتَ عن أعدائك فليكن رفيقك التّوكّل:
{ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81)} [النساء].
3- إذا أعرضَ عنك الخلقُ، فتوكّل على ربك:
{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } [التوبة:129].
4- إذا تلي القرآن عليك، أو تلوته فاستند على التّوكّل:
{ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)} [الأنفال].
5- إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إلّا بالتّوكّل:
{ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } [الأنفال:61].
6- إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتّوكّل:
{ قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)} [التوبة].
7- وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التّوكّل:
{ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ } [يونس:71].
8- وإذا عرفت أنّ مرجع الكلّ إلى اللّه وتقدير الكلّ فيها للّه فوطّن نفسك على فرش التّوكّل:
{ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ } [هود:123].
9- وإذا علمت أنّ اللّه هو الواحد على الحقيقة، فلا يكن اتّكالك إلّا عليه:
{ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30)} [الرعد].
10- وإذا كانت الهداية من اللّه، فاستقبلها بالشّكر والتّوكّل:
{ وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12)} [إبراهيم].
11- وإذا خشيت بأس أعداء اللّه والشّيطان والغدّار فلا تلتجئ إلّا إلى باب اللّه:
{ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99)} [النحل].
12- وإذا أردت أن يكون اللّه وكيلك في كلّ حال، فتمسّك بالتّوكّل في كلّ حال:
{ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81)} [النساء].
13- وإذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التّوكّل:
{ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)} [النحل].
14- وإن شئت أن تنال محبّة اللّه فانزل أوّلا في مقام التّوكّل:
{ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)} [آل عمران].
15- وإذا أردت أن يكون اللّه لك، وتكون للّه خالصا فعليك بالتّوكّل:
{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق:3]،
{ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79)} [النمل]
[جميع ما تقدم من [1 – 15] من كلام الإمام اللغوي المفسر الفيروز آباديّ:، في كتابه: بصائر ذوي التمييز (2/313-315)].
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله من أن كثيرًا من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله!
وبيان ذلك كما يقول رحمه الله: "أنك ترى بعض الناس يصرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شيء، وفي المقابل ينسى أو يغفل عن تفريغ قلبه للتوكل في: زيادة الإيمان، والعلم، ونصرة الدين، والتأثير في العالم خيرًا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف، أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين، وقمع المبتدعين، وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين" [ينظر: المصدر السابق [2/225] بتصرف] انتهى.
وههنا ملحظ مهم يستفاد من كلامه رحمه الله، وهو: أن الواحد منا ـفي حال نشاطه وقوة إيمانه ـ قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوكل على الله، اعتمادًا على ما في القلب من قوة ونشاط، وهذا غلط ينبغي التنبه إليه، والحذر منه، ومن تأمل في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجده دائم الافتقار إلى ربه، ضارعًا إلى ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، حتى ربى أمته على هذا المعنى في شيءٍ قد يظنه البعض بسيطًا أو سهلًا، وهو أن يقولوا: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند سماع المؤذن في الحيعلتين! [أخرجه الشيخان : البخاري ح [588] ومسلم ح [385]، ولم أشأ أن أستشهد بالحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما: من حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأَبِيهِ : يَا أَبَةِ إِنِّى أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَدَنِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى سَمْعِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَصَرِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاَثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِى. فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ. قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاَثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِى فَتَدْعُو بِهِنَّ فَأُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِى شَأْنِى كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ »؛ لأن إسناده ضعيف، وينظر في تخريجه: مسند أبي داود الطيالسي [2/200] ح [909]، [910] ، والله أعلم].
وقد أجمع العلماء على أن التوفيق، ألّا يكل اللّه العبد إلى نفسه، وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه!
اللهم إنا نبرأ من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتك، اللهم إنا نعوذ بك أن نوكل إلى أنفسنا طرفة
يتبع -
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةالخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، جعل المسلمين أخوةً متحابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحقُ المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادقُ الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، سلَّم تسليماً كثيراً أما بعد
أيُّها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله جعل المؤمنين أخوةً متحابين، من أول الخليقة إلى آخرها { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }، وأنزل الله جلَّ وعلا سورة الحجرات بيَّن فيها كُل ما يُفسد هذه المحبة، ونهى عنه، وحذر منه،
قال سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }، إن جاءكم فاسق الفاسق هو الذي لا تُقبل شهادته، ولا يُقبل خبره بسبب نقصه في دينه، وارتكابه لكبائر الذنوب، هذا هو الفاسق، وأيضاً الذي ينقل الإشاعات، وينقل الأخبار الكاذبة، ويمشي بالنميمة ليُشوش بين المسلمين، ويُفرق ما بينهم، هذا فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، فهذا خارجُ عن طاعة الله، الذي أمر بالمحبة والتواصل والاجتماع، وقوله { فَتَبَيَّنُوا } يعني: تثبتوا من خبره هل هو صدقٌ أو كذب؟ فإن كان كذاباً فردوه، وإن كان صدقاً فلا تُشيعوه، ولا تنشُروه، بل عالجوه بالذي هو أحسن، وكتموه، إبقاءًا على المحبة بين المسلمين، وسداً لباب الفتنة، وردعاً للسعاة المفسدين، ولهذا قال: { أَنْ تُصِيبُوا } أيَّ لئلا { تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ } تجهلون هذا الخبر وتؤخذونهم وهو بُرآء { فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } على ما فعلتم من إصابة الأبرياء بناءاً على هذا الخبر الكاذب والشائعة نادمين على ما حصل منكم، ولا ينفع الندم بعد ذلك، لأن القلوب إذا تدابرت فيما بينها وتباغضت لا يمكن ردها عما حصل فيها، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى،
ثم قال جلَّ وعلا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ } كذلك السُخرية بالنَّاس، تنقص النَّاس، هذا مما يسبب التباغض، والتنقص، وازدراء الآخرين مع أن المؤمن له قدرٌ عند الله ومكانةٌ عظيمة لا يجوز انتهاكها، ولا يجوز السُخرية به وما يحرم على الرجال من ذلك يحرم على النَّساء، والنَّساء أكثر وقوعاً في هذا، أكثر وقوعاً فيما بينهن وهن أخوات في الإيمان فلا يتخذنا السُخرية، وتنقص الأخريات حرفةً لهنَّ، فالله أمر النَّساء بما أمر به الرجال، لأنَّ النساء شقائق الرجال، ولأنهنَّ إذا صلحن صلحت الأسر والمجتمع، وإذا فسدن فسدت الأسر وفسد المجتمع، لأنهنَّ الأساس الذي ينبني عليه المجتمع ولأنهنَّ ضعيفات عقول تُأثر فيهنَّ الشائعات، وتؤثر فيهنَّ السُخرية والتنقص { لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ }، { وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ } لأنه قد يكون المسخور منه خيراً من الساخر وهذا هو الواقع، فإن الذين يسخرون من الناس ويتنقصونهم لما فيهم هم من النقص العظيم، وإلا لو لم يكنَّ فيهم نقص لما تنقصوا النَّاس،
ثم قال جلَّ وعلا: { وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ } اللمز هو التنقص أيضاً { أَنفُسَكُمْ } يعني: بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كالنَّفس الواحدة، وإلا فالإنسان لا يلمزُ نفسه، وإنَّما يلمزُ أخاه، وأخوه من نفسه لأن المؤمنين كنفس واحدة، وكجسد واحد، وكبنيان واحد، { وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ }، الألقاب جمع لقب وهو ما أشعر بمدحٍ أو ذم، فهذا نهيُ عن الألقاب التي فيه ذم، كالتنقص كالبخيل، والجاهل، وغير ذلك من العُيوب، حتى ولو كان الإنسانُ فيه شيءٌ من ذلك، فإنه يُستر عليه ولا يُبين، { وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ }،
ثم قال جلَّ وعلا: { بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ } فسمى التنابز بالألقاب فُسوقاً { بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ } والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عزَّ وجلَّ بعد الإيمان، دلَّ على أن التنابز بالألقاب يُنافي كمال الإيمان، ويُنقص الإيمان، ثم قال جلَّ وعلا: { وَمَنْ لَمْ يَتُبْ } اعتبره ذنباً تجب التوبة منه { وَمَنْ لَمْ يَتُبْ } من اللمز بالألقاب { فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ } سماه ظالماً، لأن الظلم هو التعدي على النّاس، وبخس حقوق النَّاس، فاللامز بالألقاب مُتنقص لحقوق النَّاس كالذي يتنقص أموالهم، وهذا أشد من انتقاص الأموال، انتقاص الأعراض، وانتقاص المنزلة، وانتقاص أشد على الإنسان من أن يفقد شيء من ماله، ولهذا نهى عن اللمز بالألقاب وسماه فسوقاً، ومُنقصاً للأيمان، وأمر بالتوبة منه، ومن لم يتب منه فإنَّه ظالم، والظالم مصيره مظلم والعياذ بالله { وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ }،
ثم قال جلَّ وعلا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ }، الظنون هذه هي التي أيضاً تؤثر على النَّاس، أن تظنَّ بأخيك سوءًا والأصل في المؤمن العدالة والخير فلا تظن به إلا الخير، ولا تظن به السوء { اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ }، فيجتنب الكثير من أجل القليل لقُبح هذا، لقبُح هذا الذنب { اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } فكيف إذا كثر الظن السيئ؟ والعياذ بالله،
ثم قال جلَّ وعلا: { وَلا تَجَسَّسُوا } لا تتبعوا عورات الناس الخفية، لا تجسسوا على النَّاس، استروا عليهم، وإذا انتقدتم عليهم شيئاً فناصحوهم سراً، أمَّا تتبع عورات النَّاس والتحدث عنها، فالله نهى عن ذلك،
وفي الحديث: " من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الأشهاد "، فإذا تتبعت عورات النَّاس لتظهرها وتنشرها، فإنَّ الله يتتبع عوراتك وهو أعلم بك سبحانه وتعالى، وينشر مخازيك على الناس عقوبةً لك، نسأل الله العافية { وَلا تَجَسَّسُوا }،
ثم قال تعالى: { وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً } هذا من أسباب القطيعة، ومن أسباب التفرق، والتباغض، والغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟
بينها النَّبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " هي ذكرك أخاك بما يكره "، في مغيبه تتحدث عن ما يكره من أخلاقه، تتحدث عنه وهو غايب في المجالس " ذكرك أخاك بما يكره "، قال يا رسول الله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته "، يعني: كذبت عليه،
فأمسك لسانك يا أخيَّ عن الغيبة، ثم بيَّن سوء الغيبة { أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً } لو جئت إلى جنازة ميتة هل تستسيغ أن تأكل من لحمها؟ لا يستسيغ هذا أحد مكروه، الذي يغتاب النَّاس يأكل لحومهم { أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ }،
وإذا حصل بين المسلمين إذا حصل بينهم فتنَّة أو انقسام فإنَّه يجب الإصلاح، إذا حصل بينهم فتنَّة وقتال يجب الإصلاح { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } هذا هو العلاج الأول الصُلح وقد قال الله جلَّ وعلا: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } والصلح هي تسوية النزاع بين المتنازعين حتى يرضى بعضهم عن بعض، ويزول النزاع والشقاق، ولا سيما إذا كان نزاعاً مُسلحًا فيه سفك للدماء، فإنَّه يجب التدخل بالإصلاح فيما بينهم، ولا نتركهم، ولا نتركهم يتقاتلون، بل ندخل في الصلح بينهم مهما أمكن ولو تحملنا أمولًا في مقابل ذلك نُصلح بينهم،
ثم الخطوة الثانية : { فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ } إذا أبت إحدى الطائفتان أن تقبل الصلح { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي } يجب على المسلمين أن يقاتلوا الفئة الباغية التي لا تقبل الصلح { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } أيَّ: ترجع عمَّا هي عليه إلى أمر الله { فَإِنْ فَاءَتْ } أيَّ: رجعت، { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ } أنصفوا المظلوم من الظالم، وأنصفوا المُخطئ عليه من المخطئ، { فأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } أيَّ: العادلين،
ثم قال جلَّ وعلا: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } أخوة في النَّسب لا، قد يكون هذا من أقصى الأرض وهذا من أقصاها ولا يعرف بعضهم بعضا، لكن الإيمان يجمع بينهم { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } في أيَّ مكان، فالمؤمن أخو المؤمن، في أي مكان ومن أيَّ جنس فالعربي أخو للعجمي المسلم، والأبيض أخو للأسود، المسلم لا فرق بين المسلمين والمؤمنين لا في الأوطان، ولا في الألوان، ولا في النسب، لأنَّهم أخوة في الإيمان جمع الإيمان بينهم، هذه هي الأخوة الصحيحة، أمَّا الأخوة في النَّسب فهي إذا تعارضت مع الأخوة في الإيمان فإنَّها ترفض الأخوة في النسب { لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ }، فالمحبة إنَّما هي بالإيمان وحده لا بالأطماع، ولا بالإنحيازات، والعنصرية الجاهلية، إنَّما هو بالإيمان الذي منَّ الله على عباده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم، أقولٌ قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيرا
قال الله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } خاطب النَّاس جميعاً، بعدما خاطب المؤمنين خاصة، خاطب النَّاس جميعاً وبيَّن لهم أصلهم أنَّه خلقهم من آدم وحواء، من ذكر وأنثى، لا فضل لبعضهم على بعض في النسب، كُلهم من بني آدم، وإنَّما الفضل بالإسلام والإيمان والخصال الطيبة، هذا هو الذي فيه الفضل { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }، فلا يُقرب عند الله إلا التقوى، لا يُقرب النَّسب ولو كان من أرفع النَّاس نسبًا { فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ }، نَّسأل الله العافية، فالنَّسب إنَّما هو في الدنيا فقط تعارف، تعرف أنَّك من بني فلان لأجل الصلة إليهم، لأجل الصلة بهم تصلهم، ولأجل انضباط القبائل يعرفُ بعضها بعضا، أمَّا من جهة النسب يرفع أو يخفض فليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }، { وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ } أيَّن أنَّسابهم؟ ذهبت أنَّسابهم ولم يبقى إلا أعمالهم، ولم يبقى إلا التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى.
فاتقوا الله، عباد الله، وعلموا أنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهديَّ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتها، وكُلَ بدعةٍ ضلالة.
وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار قال تعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }.
اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيَّنا محمد، وارضَ اللَّهُمَّ عن خُلفائِه الراشدين، الأئمة المهديين، أبي بكر، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وعَن الصحابة أجمعين، وعن التابِعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
اللَّهُمَّ أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين، اللَّهُمَّ أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين، اللَّهُمَّ أحمي حوزة الدين، اللَّهُمَّ أحمي بلاد المسلمين، اللَّهُمَّ احمي بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللَّهُمَّ من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، وصرف كيده في نحره، وكفنا شره إنَّك على كل شيء قدير.
عبادَ الله، { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }،{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } ، فاذكروا اللهَ يذكُرْكم، واشكُروه على نعمِه يزِدْكم ، { ولذِكْرُ اللهِ أكبرُ واللهُ يعلمُ ما تصنعون }.
عن موقع الشيخ صالح الفوزان -
(وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)التوبة
عندما نبحث في سبب نزول هذه الآية، نجدُ أنه لما ذكر الله تعالى أحوالَ المنافقين المتخلِّفين عن الجهاد والمثبِّطين عنه، ذكر صفات المؤمنين المجاهدين الذين باعوا أنفسَهم لله، ثم ذكر قصة الثلاثة الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك، وتوبة الله عليهم، وختَم السورة بتذكير المؤمنين بنِعَمِه العظيمة؛ ببعْثِة السراج المنير النبيِّ العربيِّ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين.
لو أردنا أن نذكر شرحًا يسيرًا للآيات لقلنا الآتي:
﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة: 118]: الذين أُخِّروا عن التوبة.
(قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة، والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خُلِّفوا؛ أي: عن التوبة)؛ تفسير ابن كثير، ت: سلامة (4/ 210).
﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾: أي: ضاقت عليهم مع سَعتها، ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُم ﴾: أي: ضاقت أنفسهم بما اعتراها من الغمِّ والهمِّ، بحيث لا يسعُها أنسٌ ولا سرورٌ، وذلك بسبب أن الرسولَ عليه الصلاة والسلام دعا لمقاطعتِهم؛ فكان أحدُهم يلقي السلام على أقرب أقربائه فلا يردُّ عليه، وهجرَتْهم نساؤهم وأهلوهم حتى تاب الله عليهم.
﴿ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾: أيقنوا أنه لا معتصمَ لهم من الله، وعن عذابه إلا بالرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.
﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [التوبة: 118]: أي: رجع عليهم بالقبول والرحمة؛ ليستقيموا على التوبة، ويداوموا عليها.
﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾: أي: المبالِغ في قَبول التوبة وإن كثرت الجِنايات وعَظُمت.
ماذا نستفيد من هذه الآية وتفسيرها؟
نستفيدُ أنه يجب على الإنسان المسلمِ ألَّا يُغرِّد خارج السرب؛ لأن الذئب يأكلُ الغَنَم القاصية، وكذلك يجبُ على الفرد أن يَلْتزِمَ بقرار الجماعةِ، ولا يَخرُجَ عليها بتصرُّفٍ أو سلوكٍ خاطئ، غير محمودٍ عُقباه، وبدون رويَّة وتمعُّنٍ، ويجب أن يعرف ذلك المُخطِئُ المتصرِّف بالسلوك غير المسؤول أن عاقبةَ التصرف ليست بالهَيِّنةِ، وعليه أيضًا أن يُقرَّ بخطئه، وأن يستمِعَ من إخوانه ولا يُكابِر، ويجب عليه أن يعترفَ أن الطاعة شيءٌ عظيم، ومنتقده خاسر.
وفي السياق نفسه يجب على المسؤول - رغم كلِّ المنغِّصات والعقبات - أن يتصرَّف بالحكمة، وأن يَصبِرَ على الأذى، ويصفح عن الذنب.
لقد كان الدرس والعقوبة التي تعرَّض لها الصحابه الثلاثة: (كعب، وهلال، ومُرَارَةُ) - صعبة على النفس البشرية، خاصةً أن رسول الله قد سكت عن المنافقين الذين تخلَّفوا عن الغزوة، ولكن لم يَسكُتْ عن هؤلاء الثلاثة، ولعلَّ رسولَ الله أراد أن يُهذِّب نفوسهم، ويُقوِّم طريقهم؛ لأن رسول الله يدرك أن الإيمان في قلوب هؤلاء الصحابة، فكان لا بدَّ من حسابهم؛ لأنهم رجال الغد الذين سيَحمِلون الإسلام للبشرية.
وعندما استجابوا وصبروا، جاءت التوبة من عند الله، الذي لم يكن هنالك ملجأٌ لهم إلا إليه سبحانه.
﴿ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: 118]
(وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)التوبة
1- }و على الثلاثة الذين خُلِّفوا{ خُلّفوا ليس المقصود تخلفهم عن القتال ولكنها بمعنى أُخِّروا عمن اعتذر فلم تقبل توبتهم في الحال تصحيح_التفسير" / عهود بنت سعد
2- ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) ضاقت علي الصادقين لتسوقهم لفرج التوبة ولم تضق على المنافقين أحزانك مفاتيح الفرج . / عبد الله بلقاسم
3- "وضاقت عليكم الأرض" دون توفيق الله أوسع البقاع .. أضيق الرقاع . / إشراقات براءة
4- ( وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) لحـظة اليأس واستحـالة زوال الغمّ ، إلا من الله ، بداية الفرج وقدوم النِعمّ . / عايض المطيري
5- ثم تاب عليهم ليتوبوا" تحتاج أن يتوب عليك لتتوب إليه .. التوبة ليست قرارا شجاعا .. بل هداية ورحمة/ علي الفيفي
6- التوبة توفيق من الله، يجب أن يَسألها الإنسانُ ربَه، لا أن ينتظرها من نفسه (ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم) / عبد العزيز الطريفي
7- مهما ضاقت على المؤمن أرضه ونفسه فإن السماء لا تضيق عليه(حتى إذا ضاقت عليهم اﻷرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه) / سعود الشريم
8- وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه" حين نشعر بعجزنا وعجز اﻵخرين حولنا نصبح أقرب ما يكون للفرج. / عبدالله بن بلقاسم
9- (حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم) "من مفهومها : (النفس الواسعة تغني عن سعة الأرض) ." / د.عقيل الشمري
10- "وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه" المدينة مفعمة بالأصحاب والكرماء والأوفياء ولكنهم أدركوا أنه ليس لضيق النفس أحد سواه . / عبد الله بلقاسم
11- (ضاقت عليهم الأرض بما رحُبَت!) عندما يحاصرك هم المعصية وأنت مؤمن،،/ وليد العاصمي
12- ( ضاقت عليهم الأرض ...وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه) الأرض ضاقت فلجأوا لله . (إذا ضاقت الأرض عليك اتسعت السماء ليديك)" / عقيل الشمري
13- من عمر قلبه بالإيمان،استشعر فقدًا مؤلمًا متى قصر في طاعة أو اقترف معصية ولو كانت صغيرة. (ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم)" / ابتسام الجابري
14- ﴿ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ﴾ تخلف 3 عن النبي #ﷺ في غزوة واحدة فجرى لهم ما سمعت، فكيف بمن قضى عُمره في التخلف عنه ؟! ابن_القيم / حمد بن علي المزروعي
شبكة الالوكة
و
حصاد التدبر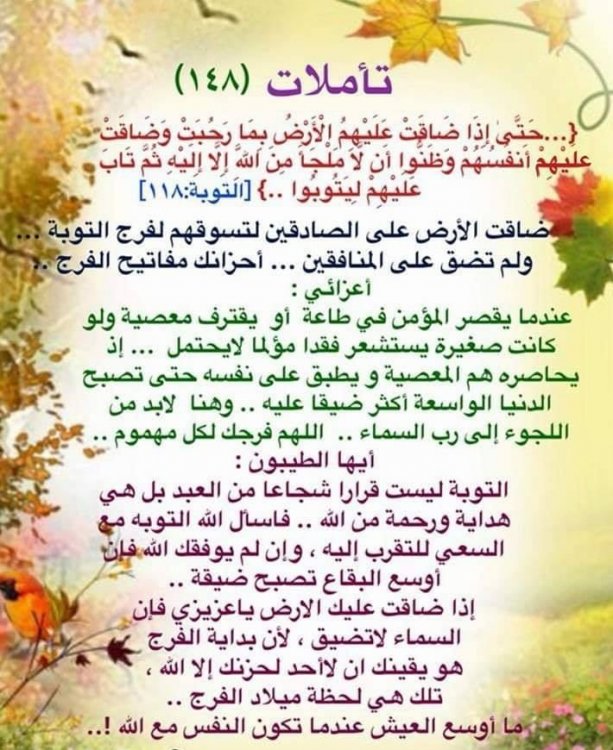
-
{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:29]
السؤال الأول:
ما دلالة اللام في قوله تعالى : {خَلَقَ لَكُمْ} ؟
الجواب:
قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ} هذه اللام كأنها للمِلك, فالله سبحانه وتعالى يخاطب هذا الإنسان حتى يرى كيف أكرمه الله عز وجل، وأنه خلق من أجله كل ما في الكون.
علماؤنا يقولون: إنّ هناك شيئين في الكون هما لأجلك؛ أحدهما لتنتفع به مباشرة كالماء والنبات والحيوان، والآخر للاعتبار: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} [الروم:8] فهذا أيضاً لك حتى يحوزك إلى الإيمان، فإذن {خَلَقَ لَكُمْ} أي: لأجلكم للانتفاع أو للاعتبار.
لذلك يكون المعنى {خَلَقَ لَكُمْ} أي: من أجلكم للانتفاع والاعتبار.
السؤال الثاني:
ما دلالة قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة:29] ؟
الجواب:
{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة:29] المفسرون يقولون : استوى، أي: عمد إلى خلقها, أي: ثم عمد إلى خلق السماء بإرادته سبحانه وتعالى، و(الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب)، وقول المفسرين( عمد إلى خلقها) نوع من التأويل المقبول الآن، نحن بحاجة إليه لكي نترجم التفسير القرآني إلى الآخرين.
السؤال الثالث:
هل السماء تدل على المفرد أو الجمع ؟
الجواب:
السماء لفظها لفظ الواحد وكل ما علاك فهو سماء, لكنّ معناها معنى الجمع، ولذلك قال: {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ} [البقرة:29] إشارة إلى تفصيلاتها.
والسماء الدنيا بكل مليارات نجومها هي كحلقة في فلاة قياساً إلى السماء الثانية.
السؤال الرابع:
لِمَ قال تعالى: {فَسَوَّاهُنَّ } [البقرة:29] ولم يقل: خلقهنّ ؟
الجواب:
لأنّ التسوية خلقٌ وبناءٌ وتزيين, أمّا كلمة (خلق)، فهي تدل على الإيجاد والبناء، ولو تأملت السموات لرأيت بدعة الخلق ودقّته ونظاماً لا يختلُّ ولا يغيب.
السؤال الخامس:
الظاهر من الآية تقدم خلق الأقوات، وظاهر آية النازعات: {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات:30] تأخره، فما القول في ذلك ؟
الجواب:
لفظة (ثم) في آية البقرة لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع، ولا يلزم من ترتيب الإخبار ترتيب الوقوع, كما في آية الأنعام (153ـ154) في قوله تعالى : {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(153) ثُمَّ آَتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ } [الأنعام:154] ولا ريب في تقديم إيتاء الكتاب على وصيته للأمة .
السؤال السادس:
ما حكمة الرقم (7) في عدد السماوات؟
الجواب:
عدد السماوات هو اختيار الله تعالى لذلك , والحكمة من هذا العدد لا يعلمها إلا الله سبحانه , لكنّ اللافت للنظر هو تكرار العدد (7) في أمور كثيرة منها :
1ـ عدد طبقات السماء .
2ـ عدد أيام الأسبوع .
3ـ عدد أشواط الطواف حول الكعبة .
4ـ عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة .
5ـ عدد أبواب جهنم .
6ـ عدد عجائب الدنيا .
7ـ عدد آيات سورة الفاتحة .
8ـ عدد ألوان ما يسمى (قوس القزح ) .
9ـ عدد كلمات شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).
10ـ عدد المستويات المدارية للإلكترون .
11ـ عدد حصى الجمرات التي يرمي بها الحاج في منى خلال الحج .
12ـ يأمر الله تعالى تعليم الصلاة للطفل عند بلوغه سن السابعة .
13ـ للضوء المرئي سبعة ألوان , وهناك سبعة إشعاعات للضوء غير المرئي .
14ـ تهاجر الطيور بسرب على شكل سبعة .
15ـ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .
اللهم اجعلنا منهم . والله أعلم .
-
القاعدة التاسعة والعشرون : { وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ }
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأحيي الإخوة القراء ، بتحية أهل الجنة يوم يلقونه: فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس، وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار، وكثر فيها تكالب الأعداء بصنفيهم: المعلن والخفي، تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: { وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ } [النساء:45].
ولكي تفهم هذه القاعدة جيدًا، فلا بد من ذكر السياق الذي وردت فيه في سورة النساء، يقول تعالى:
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46)} [النساء].
وهذا كما هو ظاهر: "ذم لمن { أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ } وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم، والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم { يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ } أي: يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه. فيؤثرون الضلال على الهدى، والكفر على الإيمان، والشقاء على السعادة، ومع هذا { يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ } فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك.
ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم، بيَّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال:
{ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا } أي: يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم،
{ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا } ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال الشر، ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال:
{ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا } أي: اليهود وهم علماء الضلال منهم { يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ }... الخ تلك الجرائم التي تلطخوا بها.
أيها القارئ الفطن:
هؤلاء العلماء الضُلّال من أهل الكتاب صنف من أصناف الأعداء الذين حذرنا الله منهم، وإذا كان الله عز وجل يخبرنا هذا الخبر الصادق في هذه القاعدة القرآنية: { وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ } فحري بنا أن نتأمل جيدًا فيمن وصفهم ربنا بأنهم أعداء لنا، فليس أصدق من الله قيلًا، ولا أصدق من الله حديثًا.
وعلى رأس أولئك الأعداء:
1 ـ عدو الله إبليس، الذي لم يأت تحذير من عدو كما جاء من التحذير منه، فكم في القرآن من وصفه بأنه عدو مبين؟ بل إن من أبلغ الآيات وضوحًا في بيان حقيقته وما يجب أن يكون موقفنا منه، هو قوله تعالى:
{ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6)} [فاطر]!
وقد جاء التعجب الصريح، والذم القبيح لمن قلب عداوة إبليس إلى ولاية، كما في قوله سبحانه:
{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50)} [الكهف]؟!
2 ـ الكفار المحاربون لنا، ومن كان في حكمهم ممن يريد تبديل ديننا، أو طمس معالم شريعتنا، قال تعالى -في سياق آيات صلاة الخوف من سورة النساء-:
{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)} [النساء].
قال أهل العلم: "والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة والآن قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم وبسبب شدة العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في قتلكم" [ينظر: تفسير الرازي (19/11)].
وفي سورة الممتحنة ما يجلي هذا النوع من الأعداء، يقول تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2)} [الممتحنة].
فهذا النوع من الكفار حرم الله علينا مودتهم، وموالاتهم، وعلل القرآن هذا بقوله عز وجل :
{ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ...} الآيات .
ومن كمال الشريعة أنها فرقت بين أنواع الكفار، فقال الله تعالى في نفس سورة الممتحنة -التي حذرنا ربنا فيها من موالاة الصنف السابق-:
{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)} [الممتحنة].
3 ـ والصنف الثالث الذين نص القرآن على عداوتهم، بل وشدتها هم المنافقون، الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وتتجلى شدة عداوة هذا الصنف في أمور:
أولًا: أنه لم يوصف في القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته شخص أو فئة بأنه "العدو" معرفًا بـ(أل) إلا المنافقون، قال تعالى:
{ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)} [المنافقون].
ثانيًا: لم يأت تفصيل في القرآن والسنة لصفات طائفةٍ أو مذهب كما جاء في حق المنافقين، وتأمل أوائل سورة البقرة يكشف لك هذا المعنى بوضوح.
يقول ابن القيم رحمه الله:
"وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر.
وذكر طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة:
المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم، وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة.
يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد!
فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه!
وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه!
وكم من علم له قد طمسوه!
وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه!
وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها!
وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها!
فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون ، { أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12)}[البقرة]، [مدارج السالكين [347/1]] انتهى.
إذا تبين هذا، اتضح لنا أهمية تأمل هذه القاعدة القرآنية: { وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ }، وأن لا تخدعنا عن معرفة حقائق أعدائنا ظروف استثنائية، أو أحوال خاصة، فإن الذي أخبرنا بهؤلاء الأعداء هو الله الذي خلقهم وخلقنا، ويعلم ما تكنه صدور العالمين أجمعين، قال سبحانه :
{ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10)} [العنكبوت]؟،وقال عز وجل :
{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [الملك]؟!
اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.
-
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
اسعدك الله في الدارين و حفظك الله من كل مكروه وانار الرحمن دربك بالايمان وشرح صدرك بالقران ورفع الله قدرك بين خلقه وغفر ذنبك
-
في هذه السورة المباركة آيات عديدة فيها سخرية من المنافقين الذين سميت السورة باسمهم .
1- يقول الله تعالى في الآية الأولى في هذه السورة :
{ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } ،
فقد سماهم المنافقين ، وهذه التسمية فضيحة لهم – ابتداء- فقد عرّاهم وهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوّة : إنهم منافقون كاذبون، فلا تأمن لهم ولا تصدِّقهم. ولا أقوى من هذا التحذير الذي يسبق مقالتهم.
واستعمل أداة الشرط ( إذا) الدالّة على المستقبل، فضحهم ولمّا يقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهدوا له شهادتهم الكاذبة الدالة على خبثهم وأنهم يقولون ما لا يؤمنون به .
وللتعمية على كذبهم أكدوا كلامهم بالأسلوب الإنكاري – إذ شهدوا – والشهادة توكيد- وأكدوا بـ( إنَّ واللام المزحلقة) فاجتمعت تأكيدات ثلاث ، دحضها القرآن الكريم بثلاثة مثلها : { وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } وتوسطها العلم بالحقيقة الأزلية – حتمية الرسالة – ولا تُقبَل الشهادة إلا مسبوقة بالعلم ، فقال الله تعالى { وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ } . وأولئك لا يعلمون حقيقة ما يقولون لعماية قلبهم عن إدراك الحقيقة .
2- في الآية الثانية : فضحهم فالقرآن في قوله: { اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) } ولن تنفعهم أيْمانُهم هذه فهي مكشوفة يتسترون بها ويختبؤون وراءها كما تُخبئ النعامة رأسها في الرمال { اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً }، ففي سورة التوبة يحلفون كذباً:
{... وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42)}،
{ وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56)}،
{ يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (62)}،
{ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (74)}.
{ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)}،
والآيات كثيرة في هذا الباب.
واقرأ قوله تعالى { إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }لترى السخرية العميقة ممتزجة بالتهديد والوعيد ، فمن أساء لقي جزاء إساءته.
3- في الآية الثالثة التدرج في العقوبة :
{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ }
1- آمنوا - 2- كفروا 3- طبع على قلوبهم . 4- لا يفقهون .
ولا يكون الجهل وعدم الفهم وفقه العاقبة إلا بعد أن يطبع على قاوبهم. وكيف يكفر المرء بعد أن ذاق حلاوة الإيمان؟! فإذا رضُوا الكفرَ واستساغوه فلْيُطبع على قلوبهم جزاءً وِفاقاً . وجاءت كلمة ( ذلك) توضيحاً لسوء فعلهم في الاية السابقة.
4- في الآية الرابعة :
{ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ }
نجد السخرية من المنظر الذي لا يتناسق والمخبر ،وقليلُ الخبرة بالرجال مَن يحكم عليهم بمنظرهم ولباسهم ومعسول كلامهم، فهؤلاء المنافقون مظهرهُم غير مخبرهم ، أجسام جسيمةٌ عليها الثياب الفاخرة ، خبراء في حياتهم الدنيوية يتحدثون فيُسمع لهم ،ويحضرون فيجلسون في صدر المجلس ،فإذا اختبرْتَ معادنهم بان المستور وانجلى الغبار عن قوم لا همّ لهم سوى حياتهم التي يعيشونها ، ويرجونها ، أما القتال فليسوا من أهله ، الصيحة تخيفهم ،والنداء يُكفِئهم، والجُبن يحكُمُهم،والجهاد يرعبهم، والبذل يؤخرهم. ، ولنتأمل الدعاء عليهم : { قَاتَلَهُمُ اللهُ } إنه سخرية واضحة ، فلا يفقهون ولا يتدبرون ، بل يفخرون بما ليس فيهم ويدّعون.
5- في الآية الخامسة : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ } ،
ومن دواعي السخرية منهم أنهم يصرون على النقيصة لا يبرحونها، فإذا دُعوا إلى الاعتراف بالتقصير والتوبة ليدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم، ويلحقوا بركب الإيمان أصروا على ما هم فيه من الاستكبار ، وانظر إلى (ليِّ رؤوسهم) عناداً وصدّاً عن الحق { لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ } أنفة وكبرياءً.، فهم (منافيخ) لا وعي ولا إدراك.
6- في الآية السادسة :
{ سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ }
، السخرية تتجلى في فسقهم وهوانهم على الله ، فلن يغفر الله لهم فهم لا يستحقونه. { سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ }
ما السبب؟ إنهم خرجوا عن الحق إلى الضلال واستمرأوه فوصلوا إلى درجة الفسق ،ومن فسق ورضي الفسقَ واستمرأه حرمه الله تعالى الهداية، ولجَّ في العماية
7- في الآية السابعة :
{ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ }
السخرية من المنافقين سببه الإغراق في الاعتماد على المادّة في محاربة الإسلام وأهله ، فالمنافقون يعتقدون أن المهاجرين ما جاءوا المدينة إلا لانهم وجدوا فيها سبل العيش وأدواته ، فإذا مُنع عنهم المالُ انقطعت المعونة وعادوا من حيثُ أتوا ، { هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا } ونسُوا أو جهلوا أن الذي يجمع المسلمين حول رسولهم الكريم إيمانُهم بالله وثقتهم به وحبهم لدينه والعيش في ظلال الإيمان الذي دخل قلوبهم فأحياها ،
ومتى كان المنافق يتطوّع ويتصدّق على المسلمين كي يقطع نائله عنهم؟!إن خزائن الله تعالى لا تنفدُ { وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } هو الإله الرازق، { وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ }...سخرية ما بعدها سخريّة.
8- في الآية الثامنة : { يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ }
تتجلى السخرية حين يعلن المنافقون كرههم للمسلمين وأنهم قادرون على إخراجهم من المدينة فهم:
أ- يصرِّحون بما لا يستطيعون.ويظهرون خبيئة نفوسهم ،ولن يبلغوا مآربهم .وهذا من ضعف تفكيرهم وسوء تدبيرهم.
بـ- ولو كانوا أقوياء وصادقين فيما يدّعون لأعلنوا وهم خارج المدينة عائدين من غزوة بني المصطلق الانفصام عن المسلمين، وحاربوهم ليمنعوهم من الوصول إلى المدينة .والتسويف دليل ضعفٍ { لَئِن رَّجَعْنَا ..}
جـ- وكيف يسمحون للمسلمين بالدخول ثم يخرجونهم ؟َ ماهو إلا تنفيسٌ لحقدهم المحتدم في نفوسهم ولقد تنِدُّ عن الضعيف الجبان كلمة ترسم أمنياته الخبيئة في صدره مهما رغب بالتكتّم والسرية.
د- وفعلاً أخرج الأعزّ- هو رسول الله صلى الله عليه وسلم – الاذلَّ- هو ابن سلول – من دائرة العز التي ادّعاها وأتباعُه حين وقف ابنه المسلم ( عبد الله) يمنعه دخول المدينة إلا بإذن العزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم،{ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } ، ثم تجيء السخرية من المنافقين جلية مجلجلة : { وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } ، وكيف يعلمون وقد طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون؟!.
-
{ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ }
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، أمر بشكره وذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف ربه فقدره حق قدره، وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله، بلغ عن ربه نهيه وأمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين لازموه وأطاعوه في حالة عسره ويسره، وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد:
أيُّها النَّاس، اتقوا الله تعالى، تدبروا كتاب ربكم قال الله جلَّ وعلا:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ * لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ }
في هذه الآيات الكريمات ينادي الله عباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، كما أنه ينادي الناس عموماً ليقيم عليهم الحجة، أما المؤمنون فإنه يناديهم بإيمانهم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } نداء تشريف وتكليف لأنهم يمتثلون أوامر الله بمقتضى إيمانهم بالله عز وجل، ثم قال تعالى { اتَّقُوا اللَّهَ } أمرهم بأمرين الأمر الأول: فيما بينهم وبين الله وذلك بتقواه سبحانه وتعالى { اتَّقُوا اللَّهَ } أي: أجعلوا بينكم وبين غضب الله وقايةً تقيكم منها، وتقيكم من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره وترك ما نهى الله عنه هذه هي الوقاية التي تقي من عذاب الله، ثم أمرهم لأنفسهم فقال: { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } فلتنظر كل نفس ما قدمت لغد من العمل والمراد بالغد يوم القيامة، سماه الله غداً لقربه لأنه قريب كل ما هو أتٍ قريب، وإن غداً لناظره قريب، ما أقربه من كل عبد بموته، وانتقاله إلى الدار الآخرة، وما أقربه من الجميع بقيام الساعة: { وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً } ، { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ } من الأعمال، فكروا في أعمالكم، حاسبوا أنفسكم فإنكم لستم على حد إقامة، وإنما أنتم على أهبت سفر، فانظروا ما معكم من العمل لهذا السفر { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى } تزودوا للآخرة بالتقوى { فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى }، انظروا في أعمالكم فما كان منها صالحاً فاحمدوا الله عليه وازدادوا منه وداوموا عليه، وما كان منها سيئاً وما أكثره فاستغفروا الله وتوبوا إليه، فإن الله يغفر لمن تاب { ويَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ }
، { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } انظروا في أعمالكم، الإنسان منا إنما يفكر بما يدخره في الدنيا إلا من رحم الله فهو يقول أنا أؤمن مستقبلي فيجمع المال ويجمع الاكتساب لأجل أن يؤمن مستقبله بزعمه ولا يدري لعله ينتقل ويتركه لغيره ولا يدرك ما أمنه، إنما الذي يبقى هو ما تقدمه لآخرتك، أما الذي تجمعه لدنياك فأنت راحل وتاركه لغيرك ولهذا قال: { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } ولم يقل ولتنظر نفس ما ادخرته للدنيا، بل تنظر ما قدمت للآخرة { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } فلا تنشغلوا عن ذلك لأمور الدنيا، لا تترك الدنيا وطيباتها وما أباح الله ولكن لا تنشغلوا بها، خذوا منها منا يعينكم على طاعة الله عز وجل، وما تتقربون به إلى الله من الصدقات والزكوات وغير ذلك من الأعمال الصالحة المالية فهذا للآخرة، هذا يقدم للآخرة أنت تقدم من مالك للآخرة كما أنك تقدم من عملك البدني من الصلاة والصيام وغير ذلك أيضاً للآخرة، فأنت تقدم من أعمالك البدنية وأعمالك المالية تقدم لآخرتك هو الذي سيبقى لك وتنتفع به، وأما ما زاد عن ذلك فإنه ليس لك وإنما هو لغيرك، اجتهد فيما هو لك،
{ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } حاسب نفسك يا أخي، بعض الناس ينظر إلى عيوب الناس ولا ينظر إلى عيبه فيتحدث عن الناس فلان مقصر وفلان غافل وفلان كذا وفلان كذا ... ولا ينظر إلى نفسه ويحاسب نفسه، نعم إذا رأيت على أخيك خطأً أو غفلةً ذكره ولكن أبدأ بنفسك، ذكر نفسك أولاً { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } ولا تنظر إلى ما قدمه الناس لآخرتهم فقط، أبدأ بنفسك ثم أنصح لغيرك حتى يقبل منك ما تقول وحتى ينفع الله بك، أما الذي ينظر إلى عيوب الناس وينسى عيب نفسه فهذا مثل الشمعة تحترق وتضيء لغيرها، السراج يضيء لغيره وهو يحرق نفسه، فالذي ينظر إلى عيوب الناس ويحصيها عليهم وينسى عيوب نفسه هذا مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، فعليك يا أخي أن تتقي الله في نفسك أولاً ،
{ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } ، ثم قال جل وعلا في ختام الآية: { وَاتَّقُوا اللَّهَ } أعاد الأمر بالتقوى لأهميتها
{ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } راقب الله سبحانه وتعالى فيما تعمل ولا تزكي نفسك { فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى } فاتقِ الله واعلم أنه مطلع عليك، راقب الله سبحانه وتعالى { إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } من خير أو شر وسيحاسبكم عليه وسيجازيكم عليه يوم القيامة، فأنتم ما دمتم في زمن الإمكان، في زمن الدنيا والحياة التي منحكم الله إياها وأمهلكم فيها بادروا بالمحاسبة، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر { يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ }، فاتقِ الله واعلم أنه مطلع عليك سواء عملت خيراً أو عملت شراً ويحصي ذلك عليك، واعلم أنه يعلم نيتك وقصدك، فليس العبرة بالظاهر إنما العبرة بالنيات والسرائر فأخلص نيتك لله، أما العمل الذي ليس لله فالله لا يقبله سبحانه وتعالى ويكون وبالاً عليك وإن ظننت أنه عمل صالح، لأنه لم يؤسس على نية خالصة لله عز وجل، فأنت اعمل وأخلص النية لا تعمل فقط أخلص النية لله، فالعمل الذي لله وإن كان قليلاً ينفع الله به فقد يدخلك الله به الجنة حتى بشق التمرة: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "، فالعمل الصالح الذي أخلص نيته فيه لله هو الذي يقبله الله وإن كان قليلا: { إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً } إن تكن الذرة حسنة ذرة مثقال ذرة حسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضاعفاً كثيرة ويدخل بها صاحبها الجنة، فليست العبرة بكثرة الأعمال، العبرة بالأعمال الخالصة لله عز وجل، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجه، وصواباً على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا شرط آخر، أن يكون هذا العمل موافق لسنة الرسول، أما إن كان مبتدعاً فإن الله لا يقبله لأنه لم يشرعه، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما شرعه وما أخلص العامل نيته فيه له قال صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ "، فأنت أنظر في عملك يا أخي، أوصيك ونفسي وجميع المسلمين بالنظر في أعمالنا، وأن لا تشغلنا عنها الدنيا، وأن لا يشغلنا عنها الشيطان، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الناس، وننظر إلى عيوب أنفسنا قبل أن ننظر إلى عيوب الناس.
فاتقوا الله، عباد الله، وتذكروا هذه الآية دائماً وأبدا ولهذا قال: { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ } نسوا ذكر الله عز وجل، ونسوا العمل الصالح، وانشغلوا بالدنيا مشغلاتها وملذاتها { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ } عاقبهم الله سبحانه وتعالى لما نسوه عاقبهم أن أنساهم أنفسهم فلم يعملوا لها خيراً ولم يقدموا لها عملاً صالحاً عقوبةً لهم: " لأَنَّ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْعَمَل "، فعلينا أن نتقي الله جلَّ وعلا، وما أعظم مواعظ القرآن الكريم لو أننا تدبرناه وعقلناه قال تعالى: { لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ } فلو أن الله خاطب بهذا القرآن الجبال الصم لتصدعت من خشية الله، وهو خاطبنا بها ولكن الكثير منا لم يرفع بها رأسه ولم يتأثروا بها وإن كانوا يقرؤونه ويسمعونه، فصارت قلوبنا أقسى من الجبال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكرِ الحكيم، أقولٌ قولي هذا واستغفرُ الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد:
أيُّها الناس، إن من الناس من هو مفلس قال صلى الله عليه وسلم: " أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ؟"
قَالُوا يا رسول الله: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا دينار،
قَالَ: " الْمُفْلِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأعمال أمثال الجبال" يعني: أعمال صالحة " ثم يَأْتِي وقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فيأخذ لهذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَلهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ سيئات المظلومين فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فطُرِحَ فِي النَّارِ "،
حافظوا على أعمالكم الصالحة إذا عملتم عملاً صالحاً فحافظوا عليه، حافظوا عليه من التلف وأعظم ما يتلف الأعمال هو ظلم الناس والعياذ بالله، ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فتجنبوا الظلم، ومن كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، قد لا يسلم الإنسان من ظلم الناس قليلا أو كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَتْ عِنْدَه لأَخِيهِ مَظْلَمَةٌ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْه اليوم قبل أن لا يكون دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إن كانت له حسنات أخذت مِنْ حَسَنَاتِهِ وأعطيت للمظلومين وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ المظلومين فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فطُرِحَ فِي النَّارِ " هذا هو المفلس يوم القيامة عمل عملا وتعب فيه وأخذ منه، فاحذروا أن تتلفوا أعمالكم وأن تضيعوها بالظلم والطغيان أو الإعجاب بالعمل لا يعجب الإنسان بعمله ولا يستكثر عمله مهما عمل فإنه قليل، لأن حق الله عليه عظيم ولكن الله غفور رحيم، يغفر ويزيد من فضله لكن لابد من الأسباب النافعة والأسباب الواقية من المحظور.
فاتقوا الله، عباد الله، واعلموا أنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهديَّ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
وعليكم بالجماعة، فإنَّ يد الله على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار،{ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيَّنا محمد، وارضَ اللَّهُمَّ عن خُلفائِه الراشدين، الأئمةَ المهديين، أبي بكرَ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وعَن الصحابةِ أجمعين، وعن التابِعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
اللَّهُمَّ أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وجعل هذا البلد آمناً مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، اللَّهُمَّ من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، وصرف عنا كيده، وكفنا شره، وجعل كيده في نحره، وجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير، اللَّهُمَّ إن الكفار طغوا وبغوا في هذا الزمان وتجرؤوا على عبادك الصالحين قتلوهم وشردوهم ونشروا فيهم الفتنة فيما بينهم فصار الأخ يقتل أخاه وصار الجار يقتل جاره بتحريض من المنافقين ومن المشركين ومن الملاحدة، اللَّهُمَّ دمرهم تدميرا، اللَّهُمَّ كف بأسهم عنا فأنت { أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً }، اللَّهُمَّ عجل بعقوبتهم حتى يسلم المسلمون من شرهم، اللَّهُمَّ انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان واجعل لهم فرجاً ومخرجا، اللَّهُمَّ زلزل أقدام الظلمة، اللَّهُمَّ شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللَّهُمَّ سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين يا قوي يا عزيز يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء، اللَّهُمَّ أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ إن نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين وجعل لنا جنات وجعل لنا أنهارا إنك على كل شيء قدير، اللَّهُمَّ إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللَّهُمَّ أحي عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا سميع الدعاء.
عبادَ الله، { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }،{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }، فذكروا الله يذكركم، واشكُروه على نعمِه يزِدْكم، { ولذِكْرُ اللهِ أكبرَ واللهُ يعلمُ ما تصنعون }.
عن موقع الشيخ صالح الفوزان -
{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:25]
السؤال الأول:
في آية سورة البقرة يقول تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} [البقرة:25] وفي آية الكهف يقول: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ} [الكهف:31] فما الفرق ؟
الجواب:
فى سورة البقرة : {مِنْ تَحْتِهَا} [البقرة:25] الكلام عن الجنة قال تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:25] وفى سورة الكهف: {مِنْ تَحْتِهِمُ} [الكهف:31] يتكلم عن ساكني الجنة المؤمنين: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا(30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)}. [الكهف:30-31] .
فإذا كان الكلام عن المؤمنين يقول: {مِنْ تَحْتِهِمُ} [الكهف:31] وإذا كان الكلام عن الجنة يقول: {مِنْ تَحْتِهَا} [البقرة:25] .
وقد يقول بعض المستشرقين : إنّ في القرآن تعارضاً، مرةً تجري من تحتها، ومرةً من تحتهم لكنا نقول: إنّ الأنهار تجري من تحت الجنة ومن تحت المؤمنين فليس فيها إشكال ولا تعارض، ولكنّ الأمر مرتبط بالسياق.
السؤال الثاني:
قال تعالى في سورة النساء: [بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا] [النساء:138] وفي سورة البقرة: [وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] [البقرة:25] ذكر الباء في الآية الأولى: {بِأّنَّ} [النساء:138] وحذفها في الثانية: {أَنَّ} [البقرة:25] مع أنّ التقدير هو: {بأنّ} فلماذا؟
الجواب:
1ـ لفظة {بأنّ} [النساء:138] أكثر من {أَنَّ} [البقرة:25] فالباء الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزائهم.
2ـ إنّ تبشير المنافقين في سورة النساء آكد من تبشير المؤمنين في سورة البقرة، ففي سورة النساء أكّد وفصّل في عذاب المنافقين في عشر آيات ابتداء من قوله في الآية [136] [وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ] [النساء:136] وحتى ما بعد الآية[ 145].
أمّا في آية البقرة فهي الآية الوحيدة في تلك السورة التي ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين.
3ـ وكذلك جاء بـ (بأنّ) في قوله تعالى في سورة الأحزاب: [وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا] [الأحزاب:47]؛ لأنه تعالى فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم.
السؤال الثالث:
ما دلالة (المطهّرون )و (المتطهرون )؟
الجواب:
1ـ الذي يبدو ـ والله أعلم ـ أنّ (المطهّرون) هم الملائكة؛ لأنه لم ترد في القرآن كلمة المطهّرين لغير الملائكة، والمُطهَّر اسم مفعول وهي تعني مُطهَّر من قِبَل الله تعالى.
2ـ وبالنسبة للمسلمين يقال لهم: متطهرين أو مطّهِّرين، كما في قوله تعالى: [إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ] [البقرة:222] و: [وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ] [التوبة:108] و(متطهرين) أو (مطّهّرين) هي بفعل أنفسهم، أي: هم يطهرون أنفسهم.
3ـ ولمّا وصف الله تعالى نساء الجنة وصفهم بقوله تعالى: [وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] [البقرة:25] وكذلك وصفت صحف القرآن الكريم بالمطهّرة: [رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً] [البينة:2] فلم ترد إذن كلمة (مطهّرون) إلا للملائكة .
ولذلك فإن هذا المعنى يقوّي القول بأنّ المقصود في الآية: [فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ] [الواقعة:78] هو الذي في اللوح المحفوظ ، وليس القرآن الذي بين أيدينا لأكثر من سبب والله أعلم.
السؤال الرابع:
ما دلالة البناء للمجهول فى قوله تعالى: {رُزِقُواْ} [البقرة:25] ؟
الجواب:
الله تعالى ينسب النعمة والخير إلى نفسه ولا ينسب الشر لنفسه: [وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا] [الإسراء:83]، أمّا في الجنة فإنه لا حساب ولا عقاب يقول تعالى: [وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] [البقرة:25] .
السؤال الخامس:
لماذا لم تذكر الحور العين في هذه الآية مع نعيم الجنة ؟
الجواب:
كثير من السور لم يذكر فيها الحور العين بالرغم من ذكر الجنات، وللعلم فقد وردت الكلمات التالية في القرآن الكريم :
ـ الحور : أربع مرات في الآيات : الدخان[ 54] الطور [20] الواقعة [22] الرحمن [72].
ـ عين : أربع مرات في الآيات : الدخان [54] الطور [20] الواقعة[ 22] الصافات[ 48]
- {الجَنَّةَ} 66 مرة.
- {جَنَّاتٌ} 69 مرة.
- {جَنَّتَكَ} مرتان.
- {جَنَّتَهُ} مرة واحدة.
- {جَنَّتيِ} مرة واحدة.
- {جَنَّتَانِ} 3 مرات.
- {جَنَّتَيِنِ} 4 مرات
ونلاحظ أنه عندما يذكر القرآن الكريم أزواج أهل الجنة لا يذكر معها الحور العين مراعاة لنفسية المرأة , كما في قوله تعالى: [وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ] [البقرة:25] كما في الآيات : البقرة [25] آل عمران [15] النساء [ 57] فلم يذكر الحور العين مع الأزواج.
السؤال السادس:
لماذا جاء الظرف: {مِن قَبْلُ} في الآية مبنياً على الضم ؟
الجواب:
هناك ظروف يسميها النحويون ( الظروف المقصودة ) منها : قبل , بعد, فوق , تحت, أمام , خلف ويذكر النحاة أنّ لها أربعة أحوال :
1ـ ألاّ تضاف وهي في ذلك نكرات كقول الشاعر :
فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص بالماء الفرات
فمعنى ( قبلاً ) : فيما مضى من الزمان.
2ـ أنْ تضاف نحو قوله تعالى : [مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ] [النور:58] و [قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ] [آل عمران:144] .
3ـ أنْ يحذف المضاف إليه ويُنوى لفظه , وهذا قليل كقوله :
ومن قبلِ نادى كلُ مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف
أي : ومن قبل ذلك , ويعامل المضاف كأنّ المضاف إليه مذكور .
4ـ أنْ يحذف المضاف ويُنوى معناه , وتكون عند ذاك مبنية على الضم , وتكون في هذه الحالة معرفة من دون معرّف لفظي, وإنما هي معرفة بمعرّف معنوي , وهو القصد إليها , فبنيت على الضم لمخالفة حالاتها الإعرابية الأخرى التي تكون فيه نكرة أو معرّفة بالإضافة .
شواهد قرآنية :
[للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ] [الرُّوم:4]
[وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ] [يوسف:80].
[وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا] [مريم:9] .
[إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ] [يوسف:77] .
[أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ] [القصص:48] .
وقد ورد التعبير {مِن قَبْلُ} كثيراً في القرآن الكريم . وإعراب {مِن قَبْلُ}
من : حرف جر . و { قَبْلُ } ظرف مبني على الضم في محل جر . -
من أساليب التربية النبوية
التلميح دون التصريح
الدكتور عثمان قدري مكانسي
قد يتصرف أحد المسلمين ـ وهو يبغي الخير لنفسه ـ تصرفاً لا يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، والرسول معلم مربٍ يأخذ بأيدي أصحابه إلى الطريق الصحيح والسبيل القويم ، فهل ينبهه مباشرة ؟ ..
قد يفعل ذلك بعيداً عن أعين الناس إن كان الأمر خاصاً ، أو دفعاً للإحراج ، فالنصيحة في السر أبلغ . وقد ينبه إلى الأمر بطريق غير مباشر :
1ـ إذا كان الأمر مُهِمّاً ينبغي أن يعلمه الجميع .
2ـ ويُستحسَنُ أن يُترَك مَنْ فعل الخطأ بعيداً عن عيون الآخرين ، فيظل الاحترام سائداً بين جميع المسلمين .
- فقد جاء ثلاثة من الصحابة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ، فلما أخبروا ، كأنهم تقالّوها(1) ، وقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر !.
قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً .
وقال الآخر : وأنا أصوم فلا أفطر .
وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً .
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ .
أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني(2) .
هنا نجده صلى الله عليه وسلم يجمعهم . . . وينبههم إلى وجوب اتباع سنته مباشرة . ولكنه يرى ما فعلوه أمراً مهماً يجب أن يبلغَ الناسَ ، فيعلموا أن الدين يسرٌ وليس بعسر ، فيذكر الحادثة دون أسماء أصحابها ، فيقول :
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ . . ( ويذكر ما قالوه ) ، ثم يقول : ولكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني(3) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ ماء وجوه أصحابه الثلاثة ، ونبه الآخرين إلى وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم .
- وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد اصحابه يجمع الزكاة من بعض القبائل ، فعاد الرجل بالزكاة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وترك أشياء معه ، وقال : إنها أهديت إليه . فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم منه ، وجمع أصحابه ونبههم إلى ضرورة البعد عن الرشا واستغلال المنصب للوصول إلى منافع ماكان يصل إليها لولا عمله هذا .
فعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( ما بال العامل نبعثه فيقول : هذا لك ، وهذا لي ؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه ، فينظرَ أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ، ألا هل بلغت ؟ ثلاثاً (4) .
فأنت ترى استخدام تعبير ( ما بال العامل ) ، وفي الحديث السابق ( ما بال أقوام ) . . .
فليست العبرة بمعرفة الأشخاص ، إنما بمعرفة الحادثة ، والتنبه لها ، والحذر من الوقوع فيها .
ورحم الله الإمام الشافعي العالم الإمامَ والتربويّ الفذ ينبه إلى النصيحة بطريقة لبقة لا تجرح المشار إليه فيقول :تغـَمـّدني النـّصـيحـة بانفـراد * وجنّبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس ضربٌ * من التوبيخ لا أرضى استماعه
الهوامش:
(1) تقالّوها : عدوها قليلة .
(2) في رياض الصالحين ، الحديث / 643 / .
(3) متفق عليه ، والرجال الثلاثة هم : علي بن أبي طالب ، عثمان بن مظغون ، وعبد الله بن عمرو بن العاص .
(4) رواه الشيخان . -
{قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ}[البقرة:32].
السؤال الأول:
أحياناً تختم الآيات بـ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء:26] وفى آيات أخرى {حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام:83] فما الفرق بينهما؟
الجواب:
إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدّم العلم، وإلا يقدّم الحكمة، وإذا كان الأمر في التشريع أو في الجزاء يقدّم الحكمة.
و حتى تتضح المسألة نقدم هذه الشواهد القرآنية:
في تقديم العلم :
آ ـ قوله تعالى: {قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ} [البقرة:32] السياق في العلم، فقدّم العلم.
ب ـ قوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء:26] هذا تبيين، معناه هذا علم.
ج ـ قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [يوسف:6] فيها علم، فقدّم {عَليم}.
د ـ قال في المنافقين: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[الأنفال:71] هذه أمور قلبية .
هـ ـ قوله تعالى: {لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:110] من الذي يطلع على القلوب؟ الله، فقدّم العليم.
شواهد قرآنية في تقديم الحكمة :
الجزاء حكمة وحُكم , و من الذي يجازي ويعاقب؟ هو الحاكم،و تقدير الجزاء حكمة .
آـ قوله تعالى: {قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام:128] هذا جزاء، هذا حاكم يحكم ويقدر الجزاء والحكم, فقدّم الحكمة، وليس بالضرورة أنْ يكون العالم حاكماً، وليس كل عالم حاكماً.
ب ـ قوله تعالى:{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام:139] هذا تشريع والتشريع حاكم فمن الذي يشرع ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي وهو الذي يشرع .
ج ـ قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ(83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيمُ(84)} [الزُّخرُف: 83 - 84].
ولذلك عندما يكون السياق في العلم يقدّم العلم، وعندما لا يكون السياق في العلم يقدّم الحكمة.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِي ٱلسَّبۡتِ فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِِٔينَ٦٥)[البقرة: 65]
السؤال الأول:
الفعل (كونوا) هو فعل أمر، وفعل الأمر له معانٍ متعددة، فما أشهر معانيه؟
الجواب:
فعل الأمر هو طلب الفعل بصيغة مخصوصة , ومن أشهر معانيه :
1ـ الإباحة: (وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ) [المائدة:2] .
2ـ الدعاء : (رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ) [نوح:28] .
3ـ التهديد : (ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ) [فُصِّلَت:40] .
4ـ التوجيه والإرشاد : (وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ) [البقرة:45] .
5ـ الإكرام : (ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ) [الحِجر:46] .
6ـ الإهانة : (ذُقۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ) [الدخان:49] .
7ـ الاحتقار : (فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ) [طه:72] .
8ـ التسوية : (ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ) [الطور:16] .
9ـ الامتنان : (فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِ) [المُلك:15] .
10 ـ التعجب : (ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ) [الإسراء:48] .
11 ـ التكذيب : (قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ) [آل عمران:93] .
12ـ التعجيز : (فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ) [البقرة:23] .
13ـ الإذلال : (كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِِٔينَ) [البقرة:65] .
14ـ إظهار القدرة : (قُلۡ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا) [الإسراء:50] .
وزمن فعل الأمر للمستقبل , لكنه أوسع من ذلك فقد يكون دالاً على :
آـ الاستقبال المطلق قريباً أو بعيداً: (فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ) [البقرة:68] للقريب، (رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ) [الفرقان:65] للبعيد.
ب ـ الحال:( ثُمَّ صُبُّواْ فَوۡقَ رَأۡسِهِۦ مِنۡ عَذَابِ ٱلۡحَمِيمِ * ذُقۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ) [الدخان: 48 ، 49] فـ (ذق) من الذوق مصاحب لصب الحميم .
ج ـ الأمر الحاصل في الماضي، فقوله :( ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ) [يوسف:99] كان بعد دخولهم إياها فهو أمر يفيد الماضي. وكذلك قوله تعالى: (إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ٤٥ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ٤٦﴾) [الحِجر:45-46] فقوله: (ٱدۡخُلُوهَا) كان بعد دخولهم الجنة، وكذلك قوله: (وَلَقَدۡ صَبَّحَهُم بُكۡرَةً عَذَابٞ مُّسۡتَقِرّٞ٣٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ٣٩) [القمر:38-39] فقوله: (فَذُوقُواْ) كان بعد تصبيحهم بالعذاب.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج» فهذا من باب إقرار ما حصل في الماضي.
د ـ الأمر المستمر (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا) [البقرة:83] .
(قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوۡنُهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ صَفۡرَآءُ فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ٦٩)[البقرة: 69]
السؤال الأول:
ما دلالة (فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا) [البقرة:69] في الآية؟
الجواب:
لو قال تعالى: (بقرة صفراء) لعلِم بنو إسرائيل أنه لون الصُفرة لاسيما أنّ هذا اللون نادر في البقر، فلِمَ قيّد الصفرة بصفة فاقع؟
في هذا التعبير مزيد من التعجيز، والتقييد والتحديد لبقرة بعينها دون سواها وهنا تضييق على بني إسرائيل، فعندما شدّدوا شدّد الله تعالى عليهم.
السؤال الثاني:
ما دلالات الألوان التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ؟
الجواب:
الألوان التي وردت في القرآن الكريم هي : الأصفر ـ الأبيض ـ الأسود ـ الأخضر ـ الأزرق ـ الأحمر ـ الوردي ـ الأخضر الغامق . وأهم دلالات هذه الألوان هي :
1ـ اللون الأصفر :
و هو أول لون ذُكِرَ في القرآن , فقد ورد (5) مرات في (5) آيات , ومن دلالاته :
آ ـ إدخال السرور:
﴿ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ صَفۡرَآءُ فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ} [ البقرة:69].
ب ـ اﻹفساد والدمار:
﴿ وَلَئِنۡ أَرۡسَلۡنَا رِيحٗا فَرَأَوۡهُ مُصۡفَرّٗا} [ الروم:51].
ج ـ الفناء واليبوسة:
﴿ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ} [ الحديد:20].
2- اللون الأبيض :
وهو ثاني اﻷلوان ذكراً في القرآن , وقد ذُكٍرَ (12) مرة في (12) آية, ومن دﻻﻻته:
آ ـ الضياء وإشراق الشمس ووقت الفجر والصباح:
﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ} [ البقرة:187].
ب ـ لون وجوه أهل الجنة:
﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} [ آل عمران:107].
ج ـ مرض في العين من شدة الحزن:
﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيمٞ} [ يوسف:84].
د ـ لون يد موسى في معجزته :
﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ} [ الأعراف:108].
هـ ـ لون الطرق بين الجبال:
﴿ وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيضٞ} [ فاطر:27].
و ـ لون شراب أهل الجنة:
﴿ بَيۡضَآءَ لَذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ} [ الصافات:46].
وللعلم فإنّ اللون الأبيض هو الأساس لجميع الألوان، وإذا تم تحليله ينتج عنه ألوان الطيف السبعة . ( انظر آية آل عمران 107).
3ـ اللون الأسود :
وهوثالث لون ذُكِرَ في القرآن , وقد ورد ( 7) مرات على عدد أبواب النارفي الآيات :
[ البقرة 187 ـ آل عمران مرتان 106 ـ النحل 58 ـ فاطر 27 ـ الزمر 60 ـ الزخرف 17 ] , ومن دﻻﻻته:
آ ـ ظلمة الليل:
﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ } [ البقرة:187].
ب ـ لون وجوه أهل النار:
{وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ١}[ آل عمران:106].
ج ـ الكرب والهم والحزن:
{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ} [ النحل:58].
د ـ اليبوسة والفناء:
{فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ} [ الأعلى:5].
ومعنى (أَحْوَىٰ) أي: أسود أي: جعله هشيمًا رميمًامسوداً.
هـ ـ لون بعض الجبال:
{وَغَرَابِيبُ سُودٞ} [ فاطر:27].
4ـ اللون اﻷخضر:
وهورابع لون ذكر في القرآن, وقد ذكر 8 مرات على عدد أبواب الجنة الثمانية في الآيات :
[ الأنعام 99 ـ يوسف 43 , 46 ـ الكهف 31 ـ الحج 63 ـ يس 80 ـ الرحمن 76 ـ الإنسان 21 ] , وأهم دﻻﻻته:
آ ـ لون الشجر والزرع والأرض بعد المطر:
{وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖۖ} [ يوسف:43].
ب ـ لباس أهل الجنة:
{عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ} [ الإنسان:21].
ج ـ لون أغطية وسائد الجنة:
{مُتَّكِِٔينَ عَلَىٰ رَفۡرَفٍ خُضۡرٖ وَعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٖ} [ الرحمن:76].
5ـ اللون الأزرق :
وهوخامس اﻷلوان ذكراً في القرآن الكريم , وذُكَرَ مرة واحدة , ودﻻﻻته
لون وجوه الكفار عند الحشر من شدة أهوال اليوم، والخوف والرهبة.
{يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِۚ وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ زُرۡقٗا}[ طه:102].
6ـ اللون اﻷحمر:
وهو سادس اﻷلوان ذكراً في القرآن , وذُكِرَ مرة واحدة , ودﻻﻻته لون الطرق بين الجبال وألوان بعض الثمار:
{وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيضٞ وَحُمۡرٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُود} [فاطر:27].
7 ـ اللون الوردي :
وهو سابع اﻷلوان ذكراً في القرآن , وذُكِرَ مرة واحدة, ودلالته لون السماء عند انشقاقها وتفطرها يوم القيامة:
{فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلدِّهَانِ} [الرحمن:37].
8 ـ اللون الأخضر الغامق :
وهوثامن اﻷلوان ذكراً في القرآن، وذُكِرَ مرة واحدة , ودﻻلته لون أشجار الجنة المتكاثفة:
{مُدۡهَآمَّتَانِ} [الرحمن:64].
والله أعلم .
يتبع
مثنى محمد الهيبان
رابطة العلماء السوريين
-
نظرة الناس للكوارث الكونية:إننا نرى كثيرا من الناس ينظر إليها بمنظار علمي بحت يتحدث عن الأسباب الطبيعة والخسائر المادية، والتحليلات العلمية.ولا بأس بهذه النظرة إذا ردت الأسباب لمسببها سبحانه وتعالى، وعلمت أن فوق علم البشر وقوتهم القوي العليم عز وجل.وربما نسمع من البعض خاصة في وسائل الإعلام من يتحدث عن غضب الطبيعة، وتمرد الأرض على سكانها، أو غير ذلك مما نسمعه مما يدل على ضعف الإيمان بالله تعالى ، أو الغفلة التامة عن حقيقة الأمور،وما ينبغي أن يكون عليه المسلم المؤمن بقدر الله تعالى، الذي يعرف كيف يتعامل مع الأمور بميزان شرع الله تعالى ، ويتحدث عنها من منطلق عقيدته وإيمانه.إن هذه الكوارث التي تحدث يجب أن تنبه الغافل وأن توقظ النائم، وأن تجعل بليد الإحساس الذي بعد عن الله تعالى يعود من قريب ويفكر بعقل رشيد وقلب يقظ، قبل أن يأتيه قدر الله الذي لا مرد له ولا مفر منه.يجب أن تكون لنا نظرتنا ورؤيتنا التي نحسن بها التعامل مع مثل هذه الأحداث وأهم ما ينبغي علي المسلم التنبه له:أولا : الكون ملك الله تعالى يصرفه كيف يشاء ويدبر أمره حسبما يريدقال الله تعالى {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران : 26وقال تعالى{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد : 22فإذا حدث زلزال أو بركان أو سيل أو فيضان أو إعصار فذلك أولا وآخرا بقدر الله تعالى وقدرته، يقلب الأمر كيفما يشاء ويدبر الأمر سبحانه وتعالى بما أراد.وفي ذلك تنبيه لكل بني الإنسان أن يتعظوا ويعتبروا، ويعلموا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى منحهم شيئا من القدرة والإرادة على ظهر الأرض ليقوموا بمراد الله تعالى ، ويعبدوا الله تعالى بما أمر به جل في علاه.لكن قدرة الإنسان محدودة ، وإرادته لا تساوي شيئا بجانب قدرة الله تعالى القوي المتين.من هنا ينبغي للإنسان أن لا يغتر بعلمه ولا بقوته ولا بسلطانه ولا بأي عرض من أعراض الدنيا مهما كان فردا أو جماعة أو دولة.إنما يسلم لله تعالى في قدره ويرضي بحكمه ويخضع لأمره جل في علاه.ثانيا: الكوارث ابتلاء واختبار للناس:هذه الكوارث والأحداث التي تحدث لا تقتصر على منطقة من المناطق ولا تختص بجنس من الأجناس، إنما قد تحدث هنا أو هناك في بلد مسلم أو غير مسلم.فإذا حلت ببلد من بلدان المسلمين أو نزلت بقوم وأهله على الإيمان الصادق، والعمل الصالح فهي لا شك ابتلاء واختبار من الله تعالى لهؤلاء فيها التمحيص لهم، والرفع لدرجتهم ، والتكفير لخطاياهم وسيئاتهم{قال الله تعالى {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة : 155وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ : (مَا يُصِيب الْمُؤمن من وصب وَلَا نصب حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها إِلَّا كفر الله من خطاياه).ثالثا: الكوارث انتقام من العصاة والجاحدين :ففي هذه الكوارث والأحداث من النقمة للمخالفين والجاحدين لأمر الله تعالى ، حينما يزداد عصيانهم، وينتشر فجورهم، ويعم كفرهم، فتأتيهم نقمة الله تعالى ، ويحل بهم سخطه وعذابهقال الله تعالى {وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد} [الرعد : 31وكم من أمم في تاريخ البشرية لما خالفت أمر الله تعالى واتبعت أهوائها حلت بها نقمة الله ونزل عليها عقابه الأليم قال الله تعالى : {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [العنكبوت : 40وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم يبين لنا الحق تبارك وتعالى أنه قادر على أن ينزل عقابه الذي لا يرد عن القوم الكافرين وأنه سبحانه يمكن أن يسلط عليهم العذاب من كل مكان ومن حيث لم يحتسبوا، قال الله تعالى : {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ} [الأنعام : 65ولذلك يجب على أهل الإسلام وأتباع الدين الحق أن يجهدوا أنفسهم في بيان دين الله للناس ودعوتهم إليه، وإخبارهم بأن في الإعراض عن صراط الله المستقيم ودينه القويم الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، وأن في انتشار المنكرات وظهور الفسق والطغيان، والاستعلاء والاستبداد والظلم في الأرض بلا مقاومة لذلك أو عمل على تغييره إيذان بحلول النقمة والسخط من الله تعالى على المرتكبين لذلك ، ومن رضي بفعلهم وشاركهم فيه.رابعاً العلم لا يغني عن الإيمان:فالإنسان الذي فتح الله تعالى له من أبواب العلم بظاهر الحياة الدنيا الكثير، فظن كثير من أهل الأرض أن العلم الذي وصلوا إليه وأن الأسرار التي فتحت لهم فركبوا الهواء، وغاصوا في أعماق البحار وتحت الماء، وصعدوا إلى الكواكب وجابوا في الفضاء، وتحكموا في كثير من مجريات الأمور على ظاهر الأرض، ظنوا أن الدنيا قدا دانت لهم وأن الحياة قد خضعت لأمرهم ، وأصبح العلم عند البعض إلها يعبد، وآمرا مطاعا لا يخالف أمره.فتأتي مثل هذه الأحداث لتقول لنا بما قاله الله تعالى لخلقه {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء : 85ويبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن الذين اتخذوا العلم بديلا عن الإيمان، ومعبودا من دون الرحمن ، ومنهاجا خلاف القرآن أنهم ضلوا سواء السبيل، وحادوا عن الطريق المستقيم وأنهم لن ينفعهم علم ولا غيره إذا حلت بهم نقمة الله تعالى وباء بهم سخطه قال الله تعالى {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غافر : 85إن الأصل في العلم أن يوصل الإنسان إلى ربه، وأن يزداد خشية من خالقه، وأن يكون العلم دليلا للإيمان ، ومساندا للعمل بشرع الله تعالى، وبرهانا على الحق الذي جاءنا من عند الله قال الله تعالى {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} [فاطر : 28خامساً: حقيقة الإنسان:ما نراه بأم أعيننا من أحداث يدل دلالة قاطعة على ضعف الإنسان ، وافتقاره الذاتي إلى ربه ، وأنه لا حول له ولا قوة إلا به ومن رأى ضعف الناس أثناء الكارثة وبعدها أمام هذا الكوارث من الزلازل وغيرهاعلم قبح الكبر والغرور فلا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وقوة ربه سبحانه وتعالى، فيفتقر إليه في أحواله كلها، وينطرح بين يديه طالبا المعونة والتسديد والتوفيق ولا يستكبر عن عبادته ولا يتولى عن العمل بأمره (إن الله قوي عزيزُ).(وخلق الإنسان ضعيفا))إن الإنسان حينما يمتلك الثروة أو القوة أو العلم تجده يطغى وينسى فضل الله تعالى عليه ومنته على البشرية بأسرها. قال الله تعالى {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى} [العلق : 6فيستغل كثير من الناس النعم في محاربة المنعم ، ومخالفة منهاجه فتأتي هذه الأحداث لتقول للإنسان مهما بلغت من قوة وعلم ومعرفة وثروة، فإن كل ذلك لن يمنعك، ولن ينفعك، إنما عليك دوما أن تسير في الطريق المستقيم الذي رضيه الله لخلقه.قال الله تعالى (( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ)) (النحل:46,45) .سادسا: تذكروا تبدل يوم القيامة:هذه التحول والتبدل التي يرتعد فيه الكون بأسره سماؤه وأرضه بره وبحره، نجومه وكواكبه، كل المخلوقات في آن واحد قال الله تعالى { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)} وقال تعالى{ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6)}فالكون كله كما وصفه خالقه في هذا الوقت عند قيام الساعة يضطرب ويتبدل فماذا يفعل الإنسان عندئذوكيف يتحمل هول زلزلة يوم القيامة{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} [الحج : 1،2وقال تعالى{ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8}فهنا ينبغي أن يتنبه الإنسان ويستعد لهول هذا اليوم وما فيه من أحداث جسام لا يعلم حقيقة أمرها إلا الله تعالى.سابعا: المسارعة بالتوبة والعمل الصالح حتى يرفع البلاء عن العبادقال تعالى {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف : 56وقال الله تعالى {أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ} [التوبة : 126]فالأصل أن المسلم سريع العودة والتوبة إلى الله تعالى يخشى من عقوبة الله وسخطه، ويخاف أن تحل كارثة أو تنزل جائحة فيكون مع الهالكين فيها وربما يكون على معصية أو بعد عن الله تعالى أو تفريط في أمره.فكم من كوارث حلت ببلاد فكان فيها آجال آلاف بل مئات الآلاف من البشر .حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على ما ماتوا عليه فقد ورد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الله إذا انزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم فقال يا عائشة إن الله إذا انزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم صحيح ابن حبان:ج16/ص305 ح7314وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من الآيات الكونية، قال أنس: ( كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). رواه البخاري (1034)ثامنا: أهمية الأخذ بالأسباب لتفادي الكوارث أو التقليل من آثارها:مع إيماننا التام بقدرة الله تعالى وقدره لكن هذا لا يمنع الإنسان المسلم أن يأخذ بأسباب الحيطة والحذر وأن يستفيد من التقدم العلمي، والتفوق التقني وما وصل إليه الناس من وسائل تقلل الخسائر.فذلك من الأخذ بالأسباب التي نتعبد لله تعالى بها ولا ينافي الإيمان بالقدر إنما نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. كما قال رسول الله تعالى للصحابي: ( أعقلها وتوكل). أخرجه الترمذيإن بعض الكوارث التي تحدث في بعض بلاد المسلمين يكون كثير منها ناتج عن الإهمال، وسوء التخطيط، والاستخفاف بحياة الناس وممتلكاتهم.وهذا مع الإيمان بقدر الله تعالى وقدرته لا يغني عن محاسبة المسئولين، ومعاقبة المهملين.هذا فضلا عن أهمية الاستعداد لمواجهة مثل هذه الظروف ومعرفة كيفية التعامل معها قدر المستطاع.قال الله تعالى { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( آل عمران 165)تاسعا: أهمية التعاون والتكافل بين سائر البشر في وقت المصائب:فالأصل أن المسلم يهب لنجدة المكروبين ، وإغاثة الملهوفين في أي مكان في الأرض متي استطاع ذلك وتمكن منه.فهذه من مهام الأمة المسلة أن تقدم الخير بعمومه وشموله لكل الناس على ظهر الأرض قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران : 110وخير الناس هو الذي يكون أكثر الناس نفعا لهم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس )مختصر مسند الشهاب:ج2/ص223والله الموفق والهادي إلى سواء السبيلالشيخ الدكتور/ علاء محمد سعيدرابطة العلماء السوريين

85 فائدة منتقاة من: «كتاب الوضوء» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر
في قبس من نور النبوة
قامت بالمشاركة · تم تعديل بواسطة امانى يسرى محمد · Report reply
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، بين يديك 85 فائدة منتقاة من: «كتاب الوضوء» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله
وقد اعتمدتُ في العزو على طبعة دار طيبة، بتحقيق: أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي.
قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين
[ 1 ] الوَُضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يُتوضَّأ به، وهو مُشتقٌّ مِن الوَضاءَة، وسُمِّي بذلك لأنَّ المصلي يتنظَّف به فيصير وَضِيئًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/١ ]
[ 2 ] حديث أُبَي بن كعب: «أنَّ النبي ﷺ دعا بماء فتوضَّأ مرةً مرةً، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به» حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، وله طُرق أخرى كلها ضعيفة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/١ ]
[ 3 ] لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه ﷺ أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه ﷺ ذم من زاد عليها: «توضأ ﷺ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» رواه أبو داود بإسناد جيد.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/١ ]
[ 4 ] ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث -في الوضوء- وهو محجوج بالإجماع!
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/١ ]
[ 5 ] حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنتَ على نهرٍ جار» أخرجه أحمد وابن ماجه بسند ليِّن.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٦/١ ]
[ 6 ] حديث: «الوضوء على الوضوء نور» حديث ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٦/١ ]
[ 7 ] قال ابن عمر: لأن تُقبَل لي صلاة واحدة أحبُّ إليَّ من جميع الدنيا؛ لأن الله تعالى قال: {إنما يتقبل الله من المتقين}
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٧/١ ]
[ 8 ] سُئِل أبو هريرة ما الحَدَث؟ فقال: «فُساءٌ أو ضُراطٌ». قال ابن حجر: فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بباقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمسِّ الذَّكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٧/١ ]
[ 9 ] «نُعَيم المُجمِر» وُصِف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يُبخِّران مسجد النبي ﷺ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/١ ]
[ 10 ] حديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٩/١ ]
[ 11 ] قوله: «شكا عبدالله بن زيد بن عاصم إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يُخيَّل إليه أنه "يجد الشيء" في الصلاة» أي: الحدث. قال ابن حجر: فيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٢/١ ]
[ 12 ] قوله: «اضطجع ﷺ فنام ثم قام فصلى ولم يتوضأ» فيه دليل على أن النوم ليس حدثًا بل مظنة الحدث؛ لأنه ﷺ كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك ولهذا كان ربما توضَّأ إذا قام من النوم، وربما لم يتوضأ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٥/١ ]
[ 13 ] روى ابن المنذر بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات» وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي حُفَاة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٦/١ ]
[ 14 ] قوله: «نزل فتوضَّأ ﷺ -في مزدلفة- فأسبغ الوضوء» قال ابن حجر: الماء الذي توضأ به ﷺ ليلتئذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب، فيُستَفاد منه: الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٦/١ ]
[ 15 ] قال جمعٌ من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه، وقد أبديتُ في هذا الشرح -أي: فتح الباري- من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٠/١ ]
[ 16 ] تفنَّن البخاري في ترتيب «كتاب الصلاة» في كتابه الصحيح.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢١/١ ]
[ 17 ] ذِكر دخول الخلاء فيه تفصيل: إذا كان سيقضي حاجته في أمكنة معدة لذلك -كالحمام- فيأتي بالذكر قبل الدخول، فإن نسي: قاله بقلبه لا بلسانه. وأما إذا لم يكن في مكان معدٍّ لقضاء الحاجة -كالفلاة- فيقوله في أول الشروع، كتشمير ثيابه مثلًا، وهذا مذهب الجمهور.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/١ ]
[ 18 ] العمل بالدليلين -الَّذَينِ ظاهرهما التعارض- أولى من إلغاء أحدهما.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/١ ]
[ 19 ] حديث معقل الأسدي: «نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٦/١ ]
[ 20 ] تنبيه: وقع في طبعة دار طيبة [ ٤٤٨/١ ]: «وله في الصيام من رواية معمر: من توضأ وضوئي هذ» وصوابه: «هذا».
[ 21 ] قوله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» لأنه قد يخرج مع النفس بُصَاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيُكسِبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٣٨/١ ]
[ 22 ] النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُصَّ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٣٨/١ ]
[ 23 ] ذُكِر أن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء: اعتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يُدرَك بالبصر، والطعم يُدرَك بالفم، والريح يُدرَك بالأنف، فقُدِّمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان، قبل الوجه وهو مفروض، احتياطًا للعبادة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٤٧/١ ]
[ 24 ] قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي ﷺ في المسح مرة واحدة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٤٨/١ ]
[ 25 ] قال ﷺ: «من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال ﷺ: «لا تغتروا» قال ابن حجر: أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله وأنّى للعبد بالاطلاع على ذلك !!
[ فتح الباري لابن حجر ٤٤٩/١ ]
[ 26 ] ولم يَحكِ أحد ممن وصف وضوءه ﷺ على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٢/١ ]
[ 27 ] قوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه» على هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف، لِما فيه من المعونة على القراءة؛ لأنَّ بتنقية مجرى النفس تصحُّ مخارج الحروف، ويُرَاد للمستيقظ بأنَّ ذلك لطرد الشيطان.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٢/١ ]
[ 28 ] قال ابن حجر تعليقًا على حديثٍ عطفَهُ البخاري على حديث آخر وساقهما كحديث واحد: «كأن البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتَّحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حُكمَين مُستقلين»
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٣/١ ]
[ 29 ] قال إسحاق وداود والطبري: من غمس يده في الإناء بعد استيقاظه من النوم فإن الماء ينجس، واسْتُدِلَّ لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٤/١ ]
[ 30 ] قوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» مفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لفَّ عليها خرقة مثلًا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٥/١ ]
[ 31 ] قال ابن عمر: جعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى رسول الله ﷺ بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» قال ابن خزيمة: «لو كان الماسح مؤدِّيًا للفرض لما تُوعِّد بالنار»
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/١ ]
[ 32 ] قوله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» اختلف في معنى «ويل» على أقوال، أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ويل، وادٍ في جهنم»
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/١ ]
[ 33 ] تواترت الأخبار عن النبي ﷺ في صفة وضوئه: أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٨/١ ]
[ 34 ] قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور، وادَّعى الطحاوي وابن حزم أن مسح القدمين منسوخ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٨/١ ]
[ 35 ] حديث: «كان النبي ﷺ إذا توضأ حرّك خاتمه» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٩/١ ]
[ 36 ] قال أبو هريرة: «فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار» فيه ذكر رسول الله ﷺ بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٠/١ ]
[ 37 ] حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٠/١ ]
[ 38 ] قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٥/١ ]
[ 39 ] قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٥/١ ]
[ 40 ] قال البخاري: «باب الماء الذي يُغسَل به شعر الإنسان ... وسؤر الكلاب» قال ابن حجر: الظاهر من تصرُّف المُصنِّف -أي: البخاري- أنه يقول بطهارة سؤر الكلاب.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٩/١ ]
[ 41 ] قال النبي ﷺ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» قال ابن حجر :اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فلمسلم عنه: «أولاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وقال أبان عن قتادة: «السابعة». ورواية: «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٧٤/١ ]
[ 42 ] ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٧٥/١ ]
[ 43 ] الظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٨٢/١ ]
[ 44 ] قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دمًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٨٢/١ ]
[ 45 ] قال الأعمش: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف، فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٨٣/١ ]
[ 46 ] بوَّب البخاري: «باب الرجل يُوضِّئ صاحبه» ثم ذكر حديث أسامة بن زيد قال: «فجعلت أصبُّ على رسول الله ﷺ ويتوضأ» قال ابن حجر: وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: «أتيت النبي ﷺ بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه» وهذا صريح في عدم الكراهة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٩١/١ ]
[ 47 ] قال ابن بطال: الإغماء ينقض الوضوء بالإجماع.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٩٥/١ ]
[ 48 ] قال عمرو بن أبي حسن لعبدالله بن زيد: «أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟» فيه ملاطفة الطالب للشيخ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٩٨/١ ]
[ 49 ] حديث جابر: «كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» إسناده ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠٠/١ ]
[ 50 ] قال الشافعي في الأم: لا أعلم مُخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠١/١ ]
[ 51 ] المِرفَق هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سُمِّي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠١/١ ]
[ 52 ] قال ابن المنذر: صحَّ عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس -أي: في الوضوء- وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك!!
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠٢/١ ]
[ 53 ] قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أنَّ البَلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهرٌ دليلٌ قويٌ على طهارة الماء المستعمل.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠٨/١ ]
[ 54 ] قال ابن عمر: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا» يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع.
[ فتح الباري لابن حجر ٥١٣/١ ]
[ 55 ] اختلف العلماء في حكم وضوء الرجل بفضل المرأة: فذهب النووي إلى الجواز مطلقًا، وذهب عبدالله بن سرجس وابن المسيَّب والحسن البصري إلى المنع مطلقًا، وذهب ابن عمر والشعبي والأوزاعي إلى الجواز ما لك تكن حائضًا، وذهب أحمد وإسحاق إلى الجواز إذا لم تَخلُ به.
[ فتح الباري لابن حجر ٥١٣/١ - ٥١٤/١ ]
[ 56 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري طبعة دار طيبة [ ٥١٤/١ ]: «وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا "صلت" به ...» وصوابه: «خَلت».
[ 57 ] نقل ابن المنذر عن بن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]
[ 58 ] قال ابن عبد البر: لا أعلم رُوِي عن أحدٍ من فقهاء السَّلف إنكاره -أي: المسح على الخفين- إلا عن مالك مع أنَّ الروايات الصحيحة عنه مُصرِّحة بإثباته.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]
[ 59 ] قال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال والذي أختارُه: أنَّ المسح أفضل؛ لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]
[ 60 ] صرَّح جمعٌ من الحُفَّاظ بأنَّ المسح على الخفين متواتر، وجمعَ بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة، وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]
[ 61 ] قال ابن المنذر ثبت ذلك -أي: المسح على العمامة- عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي ﷺ قال : «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/١ ]
[ 62 ] قال المغيرة بن شعبة: «كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه» قال ابن بطال: فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/١ ]
[ 63 ] المسح على الخفين خاصٌّ بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٠/١ ]
[ 64 ] «رأى عمرو بن أمية النبي ﷺ يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ» استدل البخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العَشَاء على الصلاة خاصٌّ بغير الإمام الرَّاتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/١ ]
[ 65 ] حديث عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ» رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/١ ]
[ 66 ] مسألة نقض النوم للوضوء:
• عدم النقض مطلقًا، وهو اختيار ابو موسى الاشعري، وابن عمر، وسعيد بن المسيب.
• التفرقة بين قليله وكثيره، وهو اختيار مالك والزهري
• التفرقة بين المضطجع وغيره، وهو اختيار سفيان الثوري
• التفرقة بين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو اختيار أصحاب الرأي
• التفرقة بين الساجد وغيره بشرط قصده النوم، وهو اختيار ابو يوسف
• القاعد المتمكن لا ينقض، وغيره ينقض، وهو اختيار الشافعي في الجديد.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٨/١ ]
[ 67 ] صحَّ عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وفي صحيح مسلم وأبي داود «وكان أصحاب النبي ﷺ ينتظرون الصلاة مع النبي ﷺ فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون فحمل على أن ذلك كان وهم قعود».
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٨/١ ]
[ 68 ] قال أنس بن مالك: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ ...» فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادًا ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٥/١ ]
[ 69 ] في حديث زينب بنت جحش عند الطبراني: «أنه -أي: الحسين- جاء وهو يحبو والنبي ﷺ نائم فصعد على بطنه ووضع ذَكَره في سرته فبال»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٦/١ ]
[ 70 ] بوَّب البخاري: باب البول قائمًا وقاعدًا، ثم أورد حديث حذيفة قال: «أتى النبي ﷺ سُبَاطة قوم، فبال قائمًا»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٩/١ ]
[ 71 ] حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائمًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٦/١ ]
[ 72 ] اختلف العلماء في سبب بول النبي قائمًا:
• قال ابن حبان: لم يجد مكانًا يصلح للقعود فقام.
• وقيل إنما بال قائمًا لأنها حالة يُؤمَن معها خروج الريح بصوت.
• وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به.
• وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال «إنما بال رسول الله ﷺ قائمًا لجرح كان في مأبضه» والمأبض وهو باطن الركبة. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
• والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز
[ فتح الباري لابن حجر ٥٦٣/١ ]
[ 73 ] ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وغيرهم، أنهم بالوا قيامًا، وهو دال على الجواز من غير كراهة، إذا أمن الرشاش والله أعلم، ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٦٣/١ ]
[ 74 ] من ليس معه ماء إلا لطهارته، ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم! بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا )
[ فتح الباري لابن حجر ٥٨١/١ ]
[ 75 ] حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الماء لا يُنَجِّسُه شيء إلا ما غَلَب على ريحه، وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وفيه إضطرابٌ أيضًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٨٣/١ ]
[ 76 ] بوَّب البخاري: «باب: إذا أُلقِي على ظهر المصلِّي قَذَرٌ أو جِيفةٌ لم تَفسُد عليه صلاته». ثم ذكر أثرًا مُعلقًا عن ابن عمر: «أنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلِّي وضعه ومضى في صلاته» قال ابن حجر: هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٩٣/١ ]
[ 77 ] قال: إسرائيل -هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي-: «كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٩٨/١ ]
[ 78 ] ذكر أصحاب المغازي أن عمارة بن الوليد مات بأرض الحبشة، وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته، فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عُمارة -أي: في ذَكَره- من سحره عقوبة له، فتوحَّش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة!
[ فتح الباري لابن حجر ٥٩٨/١ ]
[ 79 ] لما وضع كفار قريش: سلى الجزور على ظهر النبي ﷺ وهو ساجد، عجز ابن مسعود أن يغيِّر شيئًا لخوفه منهم، فجاءت فاطمة وطرحته عن ظهر رسول الله ﷺ، وأقبلت عليهم تشتمهم فلم يردوا عليها شيئًا. قال ابن حجر: «فيه قوة نفس فاطمة من صغرها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رءوس قريش فلم يردوا عليها»
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٠/١ ]
[ 80 ] النُّخَامة هي النُّخَاعة، وقيل بالميم ما يخرج من الفم، وبالعين ما يخرج من الحلق.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠١/١ ]
[ 81 ] نقل بعضهم الإجماع على طهارة الريق، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر، وقال ابن حزم: صحَّ عن سلمان الفارسي، وإبراهيم النخعي، أنَّ اللعاب نجس إذا فارق الفم.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠١/١ ]
[ 82 ] قال النبي ﷺ لابن مسعود ليلة الجِنِّ «ما في إداوتك» قال: نبيذ، قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي وزاد: «فتوضأ به» وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل على تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} إنما كان بالمدينة بلا خلاف.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٣/١ ]
[ 83 ] قال أبو موسى الأشعري: «أتيت النبي ﷺ، فوجدته يستن بسواك بيده يقول: "أُعْ أُعْ" والسواك في فيه كأنه يتهوَّع» يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طُولًا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا، وفيه حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٦/١ ]
[ 84 ] روى أبو داود في السنن عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه» وهذا دالٌّ على عظيم أدبها وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه ﷺ ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٨/١ ]
[ 85 ] ختم البخاري كتاب الوضوء بحديث البراء بن عازب، قال: قال النبي ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك ... واجعلهن آخر ما تتكلم به» والنكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أُمِرَ به المُكلَّف في اليقظة، ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تقول» فأشعر ذلك بختم الكتاب.
[ فتح الباري لابن حجر ٦١٠/١ ]
صيد الفوائد