
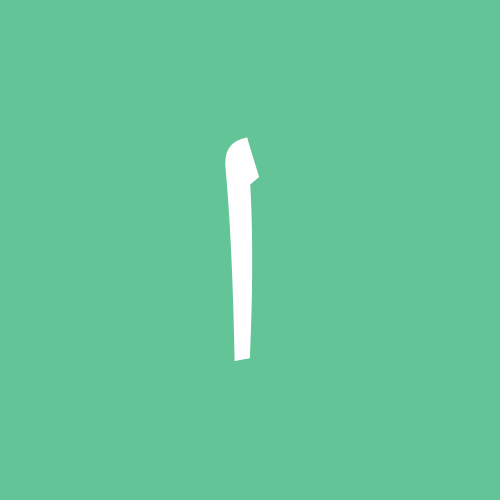
امانى يسرى محمد
-
عدد المشاركات
8535 -
تاريخ الانضمام
-
تاريخ آخر زيارة
-
الأيام التي فازت فيها
60
مشاركات المكتوبهة بواسطة امانى يسرى محمد
-
-
إلَّا غرورًا:
س 483: سئل ابن مجاهد: كم في القرآن من قوله: ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴾؟
فأجاب: في أربعة مواضع، فما هي؟
ج 483: قوله تعالى: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء: 120]، وقوله تعالى: ﴿ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: 64]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: 12]، وقوله تعالى: ﴿ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ [فاطر: 40].
آية فيها اسم الله [17] مرة:
س 484: آية كريمة من آيات القرآن الكريم اشتملت على سبعة عشر موضعًا فيها اسم الله ظاهرًا في بعضها، ومستكنًا في بعض، فما هي؟
ج 484: آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255].
الإيمان:
س 485: كم مرة ورد ذكر الإيمان بجميع مشتقاته في القرآن الكريم؟
ج 485: 811 مرة «ثمانمائة وإحدى عشرة مرة».
تلك أمة قد خلت:
س 486: قال تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.
هذه الآية قد تكررت مرتين- وبنفس الحروف والكلمات- في سياق واحد، هو إبطال مزاعم اليهود حول ما هم عليه من الباطل. فما اسم السورة التي تضمنت هذه الآية؟ وما رقم الآية في الموقعين؟
ج 486: سورة البقرة، والآية أخذت رقمي 134، 141.
سورة المائدة:
س 487: سورة المائدة مدنية، إلَّا آية واحدة منها فإنها نزلت بمكة يوم عرفة، من حجة الوداع يوم الجمعة، فما هي هذه الآية؟
ج 487: قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].
قل:
س 488: لتصدير الآيات الكريمة بعبارة "قل" مغزى لطيف يفهمه العربي بالسليقة، وهو توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليمه ما ينبغي أن يقول، فهو لا ينطق عن هواه؛ بل يتبع ما يوحى إليه. فكم مرة تكرر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة "قل"؟
ج 488: 332 مرة.
آية نزلت بعسفان:
س 489: ما هي الآية الكريمة التي نزلت بعسفان؟
ج 489: قوله تعالى: ﴿ وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: 102] نزلت هذه الآية بعسفان بين الظهر والعصر كما أخرجه أحمد عن أبي عياش الزرقي؛ [الإتقان للسيوطي].
سورة نزلت في حجة الوداع:
س 490: ما هي السورة الكريمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوسط أيام التشريق؟
ج 490: سورة النصر ﴿ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾.
أخرجه البزار والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة ﴿ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر بناقته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة؛ [الإتقان للسيوطي].
سورة نزلت بمكة ليلًا جملةً:
س 491: ما هي السورة الكريمة التي نزلت بمكة ليلًا جملةً حولها سبعون ألف ملك؟
ج 491: أخرج الطبراني وأبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلًا جملةً حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح؛ [الإتقان للسيوطي].
سورة مدنية نزلت عام الحديبية:
س 492: سورة كريمة من سور القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وهو في طريقه إلى المدينة المنورة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، فما هي هذه السورة؟
ج 492: سورة المائدة.
روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها.
آية نزلت في مِنى في حجة الوداع:
س 493: آية كريمة من آيات القرآن الكريم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِنى في حجة الوداع، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 493: قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 281]، وأرجح الأقوال أنَّ هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن.
آية نزلت ومعها عشرون ألف مَلَك:
س 494: آية كريمة من آيات القرآن الكريم نزلت مرة واحدة، شيَّعها عشرون ألف ملك، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 494: قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: 45]، قاله ابن حبيب واتَّبعه ابن النقيب؛ [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي].
آية نزلت بحمراء الأسد:
س 495: ما هي الآية الكريمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، عقب غزوة أُحُد؟
ج 495: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: 172]؛ [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي].
آية نزلت شيَّعها ثلاثون ألف مَلَك:
س 496: آية كريمة من آيات القرآن الكريم نزلت مرة واحدة شيَّعها ثلاثون ألف ملك، فما هي؟
ج 496: آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255]؛ [البرهان للزركشي 1/ 199].
سورة نزلت ومعها ثمانون ألف مَلَك:
س 497: سورة كريمة من سور القرآن الكريم نزلت مرة واحدة شيَّعها ثمانون ألف ملك، فما هي؟
ج 497: فاتحة الكتاب؛ [البرهان للزركشي 1/ 199].
سورة نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك:
س 498: سورة كريمة من سور القرآن الكريم نزلت مرة واحدة وشيَّعها ثلاثون ألف مَلَك، فما هي؟
ج 498: سورة يونس؛ [البرهان للزركشي 1/ 199].
آية نزلت بالحديبية:
س 499: آية كريمة من آيات القرآن الكريم نزلت بالحديبية حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، ولو نعلم أنك رسول الله لاتَّبعناك، فأنزل الله تعالى آية، فما هي؟
ج 499: قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ [الرعد: 30].
آية واحدة نزلت في مكة من سورة النساء:
س 500: قال الماوردي في سورة النساء: هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس، فما هي الآية؟
ج 500: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].
أول ما نزل من آل عمران:
س 501: ما أول ما نزل من سورة آل عمران؟
ج 501: أخرج من طريق سفيان وغيره، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، قال: أول ما نزل من آل عمران: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 138]، ثم أنزلت بقيتها يوم أُحُد.
سورة ملأت ما بين السماء والأرض:
س 502: ما هي السورة الكريمة التي شيَّعها سبعون ألف مَلَك لما نزلت، ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض؟
ج 502: قال ابن الضريس في فضائله: أخبرنا يزيد بن عبدالعزيز الطيالسي، حدثنا إسماعيل بن عباس عن إسماعيل بن رافع قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بسورة ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض شيَّعها سبعون ألف ملك؟ سورة الكهف»؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 51].
أول سورة وآخر سورة نزلتا بمكة:
س 503: ما أول سورة، وما آخر سورة نزلتا بمكة؟
ج 503: أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: أول سورة نزلت بمكة ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ وآخر سورة نزلت بها المؤمنون، ويقال: العنكبوت؛ [الإتقان للسيوطي].
أول سورة وآخر سورة نزلتا بالمدينة:
س 504: ما أول سورة، وما آخر سورة نزلتا بالمدينة؟
ج 504: أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: أول سورة نزلت بالمدينة ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾، وآخر سورة نزلت بها براءة؛ أي: التوبة. وفي شرح البخاري لابن حجر: اتفقوا على أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت بالمدينة؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 33].
أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة:
س 505: ما هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟
ج 505: سورة النجم.
أخرج الواحدي من طريق الحسين بن واقد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 33].
آية مدنية في سورة النجم:
س 506: سورة النجم من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 506: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى ﴾ [النجم: 32]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة المرسلات:
س 507: سورة المرسلات من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 507: قوله تعالى: ﴿ وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: 48]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة [ق]:
س 508: سورة ق من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 508: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ [سورة ق: 38]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة يس:
س 509: سورة يس من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 509: قوله تعالى: ﴿ وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [سورة يس: 45]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة الحجر:
س 510: سورة الحجر من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 510: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: 87]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة سبأ:
س 511: سورة سبأ من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 511: قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [سبأ: 6]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة الزخرف:
س 512: سورة الزخرف من السور المكية التنزيل إلا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 512: قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ ﴾ [الزخرف: 54]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة الجاثية:
س 513: سورة الجاثية من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 513: قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الجاثية: 14]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
آية مدنية في سورة الروم:
س 514: سورة الروم من السور المكية التنزيل إلَّا آية واحدة نزلت بالمدينة، فما هي؟
ج 514: قوله تعالى: ﴿ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: 17]؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
هل في القرآن ألفاظ غير عربية:
س 515: من المقطوع به أنَّ القرآن نزل بلسان العرب، وأنه كتاب عربي،
نزل على أمة عربية، بلسان عربي مبين، وقد تضافرت النصوص القرآنية الكثيرة، على أن القرآن عربي في نظمه وفي لفظه، وفي أسلوبه، وفي تركيبه، وأنه ليس فيه ما يخالف طريقة العرب في المفردات والجمل والأسلوب، فما هي هذه النصوص القرآنية الكريمة؟
ج 515: قوله تعالى: ﴿ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل: 103]، وقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: 193 - 195]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: 2]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: 37]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [طه: 113]، وقوله تعالى: ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الزمر: 28] وقوله تعالى: ﴿ كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: 3]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [الشورى: 7]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: 3]، وقوله تعالى: ﴿ وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِسانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الأحقاف: 12].
نون التوكيد المخففة في القرآن:
س 516: نون التوكيد المشددة وردت كثيرًا في القرآن الكريم، أمَّا نون التوكيد المخففة فلم ترد إلا مرتين في القرآن الكريم، في سورتين مختلفتين، فما الآيتان اللتان جاء فيهما نون التوكيد المخففة؟
ج 516: قوله تعالى: ﴿ قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ [يوسف: 32]، وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق: 15].
عسى:
س 517: عسى فعل ماضٍ جامد يفيد الترجي، وردت مجردة ثمانيًا وعشرين مرة، ووردت مسندة إلى الضمير مرتين: عسيتم، ووردت مرة واحدة للتهديد، ولم يتحقق الموضوع الذي دخلت عليه، فما الآية الكريمة التي وردت فيها عسى للتهديد ولم تقع؟
ج 517: قوله تعالى: ﴿ عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ [التحريم: 5].
كاد في القرآن:
س 518: وردت كاد وتصريفاتها أربعًا وعشرين مرة في القرآن الكريم، منها ست مرات مسبوقة بحرف النفي، وخبرها منفي، ووردت مثبتة ثماني عشرة مرة، هات مثلًا واحدًا فقط على كاد المنفية، وكاد المثبتة؟
ج 518: كاد المنفية: قوله تعالى: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: 52]، وهي هنا منفية ونفيها إثبات.
كاد المثبتة: قوله تعالى: ﴿ يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ ﴾ [البقرة: 20]، وهي هنا مثبتة وإثباتها نفي.
أمين الله على وحيه:
س 519: من هو أمين الله على وحيه الذي كان يتنزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟
ج 519: هو جبريل عليه السلام باتفاق جميع المفسرين.
قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: 193 - 195]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 102].
سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة:
س 520: بعث صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة صحابيَّيْن إلى أهل المدينة يعلمانهم الإسلام، ويقرئانهم القرآن، فمن هما؟
ج 520: مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم.
سبب جمع القرآن:
س 521: ما هو سبب جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق؟
ج 521: سبب جمع القرآن على يد أبي بكر الصديق هو استشهاد الحُفَّاظ السبعين في معركة اليمامة.
الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان:
س 522: ما هو الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان؟
ج 522: الجمع في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات، وكان سبب الجمع موت الحفاظ. أمَّا جمع عثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى الآفاق الإسلامية، وكان سبب الجمع إنما هو اختلاف القُراء في قراءة القرآن.
أحسن القصص:
س 523: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، سماها الله تعالى أحسن القصص؛ لاشتمالها على ذكر حاسد ومحسود، ومالك ومملوك، وشاهد ومشهود، وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق، وسجن وخلاص، وخصب وجدب، وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق، فما هي؟
ج 523: سورة يوسف؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 207].
أجمع آية للخير والشر:
س 524: قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية وذكرها؛ أخرجه في المستدرك. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن أنه قرأها يومًا ثم وقف فقال: إنَّ الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فما هي هذه الآية؟
ج 524: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 70].
أرجى آية عند عبدالله بن عمرو بن العاص:
س 525: التقى ابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس: أيّ آية في كتاب الله أرجى عندك؟
ج 525: فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: ﴿ قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53]؛ [البرهان للزركشي 1/ 447].
أرجى آية عند ابن عباس:
س 526: ما أرجى آية عند الصحابي الجليل عبدالله بن عباس؟
ج 526: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد: 6]؛ [البرهان للزركشي 1/ 448].
أخوف آية عند أبي حنيفة:
س 527: ما أخوف آية عند الإمام أبي حنيفة؟
ج 527: قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 131].
أرجى آية عند الإمام الشافعي:
س 528: ما أرجى آية عند الإمام الشافعي؟
ج 528: قوله تعالى: ﴿ يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: 15، 16]؛ [البرهان للزركشي 1/ 447].
أعدل آية في القرآن:
س 529: ما أعدل آية في القرآن الكريم؟
ج 529: أخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود قال: أعدل آية في القرآن ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 205].
أحكم آية في القرآن:
س 530: ما أحكم آية في القرآن الكريم؟
ج 530: أخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود قال: أحكم آية في القرآن: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7، 8]؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 205].
أعظم آية فرجًا في القرآن:
س 531: ما هي أعظم آية فرجًا في القرآن الكريم؟
ج 531: أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: ما في القرآن آية أعظم فرجًا من آية في سورة الغُرَف: ﴿ قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].
أكثر آية تفويضًا:
س 532: ما هي أكثر آية تفويضًا وتوكلًا على الله تعالى؟
ج 532: أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: وما في القرآن آية أكثر تفويضًا من آية في سورة النساء الصغرى: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: 3].
فواتح السور:
س 533: كل سورة في أوائلها حروف التهجِّي، فإنَّ في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿ الم* ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 1-2] وقوله تعالى: ﴿ يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ [يس: 1-2]، وقوله تعالى: ﴿ حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ [غافر: 1، 2]، إلا ثلاث سور، فما هي؟
ج 533:
1 - سورة مريم: ﴿ كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾.
2 - سورة العنكبوت: ﴿ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾.
3 - سورة الروم: ﴿ ال م* غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ﴾.
سورة ختمت بالوصايا العشر:
س 534: إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان، تناولت السورة القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة وأركان الإيمان، وهذه القضايا هي: قضية الألوهية، وقضية الوحي والرسالة، وقضية البعث والجزاء، وختمت السورة بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السماوية، ودعا إليها جميع الأنبياء، فما هي؟
ج 534: سورة الأنعام.
سورة مدنية لها طابع السور المكية:
س 535: سورة كريمة من السور المدنية، تناولت أحكام الحج، وأحكام الهدي، وأحكام القتال، وغيرها. نزلت بعد سورة النور، وفيها بعض الآيات المكية، ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية. تبتدئ السورة بمطلع عنيف مخيف، ترتجف لهوله القلوب، تحدثت السورة عن نموذج من البشر يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة، وكأنها صفقة مادية.
تضرب السورة مثلًا للأصنام والآلهة المزعومة بأنها أعجز من أن تخلق ذبابة، وتختم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله الواحد الأحد، وتذكرهم بنعمة الإسلام التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، فما هي هذه السورة؟
ج 535: سورة الحج.
سورة النعم:
س 536: سورة كريمة من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى، ولكثرة ما ذكره الله تعالى فيها من النعم التي أفاضها على عباده، سمَّاها بعضهم: سورة النعم تناولت السورة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين، جاءت السورة تخاطب العين لترى، والأذن لتسمع، والوجدان ليتأثر، والعقل ليتدبر، وحشدت الكون كله، سماءه وأرضه، وشمسه وقمره، وليله ونهاره، وجباله وبحاره، وعرضته أمام الأنظار مكشوفًا محسوسًا ملموسًا، تكاد كل ذرة فيه تشهد لله بالوحدانية. ختمت السورة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى، فما هي هذه السورة؟
ج 536: سورة النحل.
سورة يتفَكَّه بها أهل الجنة:
س 537: إحدى السور المكية تحتوي على قصة واحدة لم يكررها القرآن في بقية السور. قال عنها خالد بن معدان: إن هذه السورة وسورة مريم مما يتفَكَّه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال عطاء: لا يسمع سورة «...»- وذكرها- محزون إلا استراح إليها، فما هي هذه السورة؟
ج 537: سورة يوسف.
الفاضحة:
س 538: سورة كريمة من السور المدنية التي تعنى بجانب التوجيه والتشريع، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- ولهذه السورة عدة أسماء، منها: الفاضحة. نزلت هذه السورة في السنة التاسعة من الهجرة وهي السنة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، واشتهرت هذه الغزوة باسم "غزوة تبوك"، فما هي هذه السورة التي فضحت المنافقين؟
ج 538: سورة التوبة.
إلغاء بعض العادات الجاهلية
س 539: سورة كريمة من سور القرآن الكريم أبطلت بعض العادات والتقاليد الموروثة التي كانت متفشية في المجتمع الجاهلي؛ مثل: التبني، والظهار، واعتقاد أن الرجل الذكي اللبيب له قلبان في جوفه، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 539: سورة الأحزاب.
قال تعالى: ﴿ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4].
سنام القرآن:
س 540: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، تناولت السورة الفرق الثلاث: المؤمنين، الكافرين، المنافقين. تحدثت السورة عن صفات المؤمنين في خمس آيات، ثم تحدثت عن الكافرين في آيتين، ليظهر الفارق بين الصنفين، ثم تناولت الصنف الثالث وهم المنافقون في ثلاث عشرة آية، فما هي هذه السورة؟
ج 540: سورة البقرة.
آيتان متماثلتان:
س 541: قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: 3].
في كتاب الله تعالى آية نظيرة لآية الزخرف في المعنى والفاصلة، فما هي؟
ج 541: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: 2].
سورة المضاجع:
س 542: سورة كريمة من السور المكية، والمحور الخاص الذي تدور عليه السورة هو موضوع البعث بعد الموت، تبتدئ السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم، تحدثت السورة عن خلق الإنسان الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله، وتحدثت السورة عن الذل والهوان الذي يلقاه المجرمون في أرض المحشر، وتحدثت السورة كذلك عن أهل السعادة، وما أعدَّ الله لهم من النعيم، فقد كانوا في الدنيا أبرارًا تتجافى جنوبهم عن المضاجع طاعة لله. وختمت السورة بأمر رسول الله بالصبر على تكذيب المكذبين حتى يأتي اليوم الموعود، فما هي هذه السورة؟
ج 542: سورة السجدة.
سورة الملائكة:
س 543: سورة كريمة من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والرسل. تحدثت السورة عن خلق الله العجيب وهو الملائكة، وتحدثت السورة عن نعم الله على العباد، وحذرت السورة من الاغترار بهذه الحياة العاجلة الفانية، ومن العدو الأكبر إبليس اللعين، وتحدثت السورة عن الفرق الهائل بين المؤمن والكافر، وتحدثت كذلك عن أنواع الثمار المختلفة الألوان، وتحدثت كذلك عن ميراث الأمة المحمدية لأشرف الرسالات السماوية بإنزال هذا الكتاب المجيد، ثم انقسام الناس إلى ثلاثة أنواع: المقصر، والمحسن، والسابق بالخيرات، فما هي هذه السورة؟
ج 543: سورة فاطر.
سورة الغرف:
س 544: سورة كريمة من السور المكية التي تعنى بجانب العقيدة، عالجت السورة قضية التوحيد، تلك القضية التي كانت الهدف الأول للسورة، ذكرت السورة السعداء من أهل الجنة والأشقياء من أهل النار، وأن كل فريق منهما سيساق إلى مآله، المؤمنون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى النار. تحدثت السورة عن السماوات والأرض والليل والنهار، والشمس والقمر، وخلق الإنسان في ظلمات الأرحام. ختمت السورة بمشهد رائع للمتقين وهم يساقون إلى الجنة أفواجًا، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 544: سورة الزمر.
سورة تناولت الجانب التشريعي:
س 545: سورة مدنية من سور القرآن الكريم تناولت الأحكام الآتية:
أحكام القصاص، الوصية، الصيام، الجهاد، الحج والعمرة، تحريم الخمر والميسر، تحريم نكاح المشركات، وتناولت السورة شئون الأسرة بالتفصيل؛ كأحكام الطلاق، والرضاع، والعدَّة، وتناولت كذلك بعض القصص القرآني، كذلك تناولت أحكام الربا، ثم تعرضت لأحكام الدِّين، فما هي هذه السورة العظيمة؟
ج 545: سورة البقرة.
سورة اهتمت بموضوع المرأة:
س 546: سورة مدنية من سور القرآن الكريم، مملوءة بالأحكام التشريعية التي تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين، وقد تعرضت هذه السورة لموضوع المرأة، فصانت كرامتها، وحفظت كيانها، ودعت إلى العطف عليها وهي صغيرة، وإلى الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف وهي زوجة، وإلى احترامها وتوقيرها وهي أم، كما دعت إلى إعطائها حقوقها التي فرضها الله لها كاملة دون غبن أو ظلم أو إجحاف، وتعرضت السورة بالتفصيل لأحكام الميراث، وتناولت السورة تنظيم العلاقات الزوجية، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 546: سورة النساء.
سورة فيها ثماني عشرة فريضة:
س 547: سورة مدنية من سور القرآن الكريم من آخر ما نزل من القرآن، ليس فيها منسوخ، وفيها ثماني عشرة فريضة، تناولت الأحكام التشريعية التالية: أحكام العقود، أحكام الصيد، الإحرام، ما يحل ويحرم من الأطعمة، نكاح الكتابيَّات، أحكام الردة، أحكام الوضوء والتيمُّم، حد السرقة، حد البغي والفساد والإفساد في الأرض، كفارة اليمين، تحريم الخمر والميسر، منع المشركين من دخول المسجد الحرام، أحكام الوصية عند الموت، حكم من ترك العمل بشريعة الله، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 547: سورة المائدة.
قلب القرآن:
س 548: سورة كريمة من سور القرآن العظيم من السور المكية، عالجت موضوع العقيدة والرسالة والبعث والنشور، تحدثت عن كفار مكة وعن أهل القرية الذين كذبوا الرسل، ابتدأت السورة بالقسم بالقرآن العظيم على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثت السورة عن الرجل الناصح الأمين الذي جاءهم من بعيد فقتلوه، فأدخله الله الجنة وأهلك قومه بالصيحة. وتحدثت السورة عن مشاهد الكون المتنوعة: مشهد الأرض، ومشهد الليل، ومشهد الشمس، ومشهد القمر، ومشهد الفلك، ومشهد النطفة. وتحدثت السورة عن أهل الجنة وأهل النار، وعن مآل كل فريق، وركزت السورة على قضية البعث والنشور، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 548: سورة يس.
سورة القتال:
س 549: سورة كريمة من السور المدنية، لهذه السورة اسم آخر هو سورة القتال، وهو اسم حقيقي لها، مناسب لموضوعاتها وأهدافها، فالقتال لأعداء الله هو موضوعها الأساسي، والقتال هو العنصر البارز فيها، وهو المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 549: سورة محمد.
صلح الحديبية:
س 550: سورة كريمة من سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية بالإجماع، نزلت ليلًا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حين عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، بهذه السورة الكريمة أقرَّ الله تعالى عين نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إذ جمع له سبحانه ما به تقر عينه في الدنيا والآخرة، فما هي هذه السورة العظيمة؟
ج 550: سورة الفتح.
محاورة بين ثلاث فِرَق:
س 551: سورة كريمة من سور القرآن الكريم تناولت مشهدًا حسيًّا من مشاهد القيامة، وفي هذا المشهد تجري المحادثة بين فرق ثلاث: فريق المؤمنين أصحاب الجنة، أهل الهدى والإيمان، وفريق الكافرين أصحاب النار، أهل الضلال والبهتان، وفريق ثالث هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فإذا رأوا أصحاب الجنة طمعوا، وإذا رأوا أصحاب النار فزعوا، في أي سورة جاء هذا المشهد؟
ج 551: سورة الأعراف.
سورة تناولت النواحي العسكرية:
س 552: سورة مدنية كريمة عنيت بجانب التشريع وبخاصة فيما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله، فقد عالجت بعض النواحي العسكرية والحربية، وتضمنت كثيرًا من التشريعات الحربية، والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتِّباعها في قتالهم لأعداء الله، وتناولت جانب السلم والحرب، وقواعد المعاهدات الدولية، وأحكام الأسر والغنائم، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 552: سورة الأنفال.
أول آية:
س 553: ما هي أول آية في كتاب الله الخالد بعد البسملة؟
ج 553: قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2].
السبع المثاني:
س 554: سورة كريمة من سور القرآن الكريم قسمها الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: قسم لله تعالى، وقسم لعباده، وقسم ذكر فيه ثلاثة أصناف من البشر، فما هي هذه السورة؟
ج 554: سورة الفاتحة.
أول مكان نزل به القرآن.
س 555: ما هو أول مكان نزل به القرآن الكريم؟
ج 555: غار حراء في مكة المكرمة.
كلمة مكررة في آية واحدة:
س 556: كلمة من كلمات القرآن الكريم رسمت بالتاء المفتوحة وهي توجد في موضعين في آية واحدة، فما هي؟ وما الآية؟
ج 556: قوله تعالى: ﴿ هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون: 36].
بَقِيَّت:
س 557: في كم موضع رسمت بقية بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 557: في موضع واحد: ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [هود: 86].
قُرَّت:
س 558: في كم موضع رسمت "قرة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 558: في موضع واحد: ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ﴾ [القصص: 9].
فِطْرت:
س 559: في كم موضع رسمت "فطرة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 559: في موضع واحد: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ﴾ [الروم: 30].
شَجَرَت:
س 560: في كم موضع رسمت "شجرة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 560: في موضع واحد: ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ* طَعامُ الْأَثِيمِ ﴾ [الدخان: 43، 44].
جَنَّت:
س 561: في كم موضع رسمت "جنة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 561: في موضع واحد: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: 89].
ابْنَت:
س 562: في كم موضع رسمت "ابنة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 562: في موضع واحد: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ ﴾ [التحريم: 12].
مَعْصِيت:
س 563: في كم موضع رسمت "معصية" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 563: في موضعين ولا ثالث لهما:
1- قوله تعالى: ﴿ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: 8].
2- وقوله تعالى: ﴿ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: 9].
لَعْنَت:
س 564: في كم موضع رسمت "لعنة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 564: في موضعين اتفاقًا، وهما:
1 - قوله تعالى: ﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: 61].
2- وقوله تعالى: ﴿ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [النور: 7].
كَلَمَت:
س 565: في كم موضع رسمت "كلمة" بالتاء المفتوحة المتفق على قراءتها بالإفراد؟
ج 565: في موضع واحد فقط وهو: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى ﴾ [الأعراف: 137].
امْرَأت:
س 566: في كم موضع رسمت "امرأة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟ مع ذكر الضابط لذلك.
ج 566: في سبعة مواضع اتفاقًا، وهي:
1- ﴿ إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ ﴾ [آل عمران: 35].
2– ﴿ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها ﴾ [يوسف: 30].
3– ﴿ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾ [يوسف: 51].
4– ﴿ وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ [القصص: 9].
5– ﴿ امْرَأَتَ نُوحٍ ﴾ [التحريم: 10].
6– ﴿ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ [التحريم: 10].
7– ﴿ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: 11]. وضابط ذلك أنَّ كل امرأة تذكر مقرونة بزوجها ترسم بالتاء المفتوحة كما في هذه المواضع السبعة وليس غيرها في القرآن.
سُنَّت:
س 567: في كم موضع رسمت "سُنَّة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 567: في خمسة مواضع اتفاقًا، وهي:
1– ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال: 38].
2– ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ﴾ [فاطر: 43].
3– ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [فاطر: 43].
4– ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [فاطر: 43].
5– ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ ﴾ [غافر: 85].
نِعْمَت:
س 568: في كم موضع رسمت "نعمة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 568: في أحد عشر موضعًا اتفاقًا، وهي:
1– ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 231].
2– ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ﴾ [آل عمران: 103].
3– ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ ﴾ [المائدة: 11].
4– ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: 28].
5– ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها ﴾ [إبراهيم: 34].
6– ﴿ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: 72].
7– ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها ﴾ [النحل: 83].
8– ﴿ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ [النحل: 114].
9– ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ ﴾ [لقمان: 31].
10– ﴿ يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [فاطر: 3].
11– ﴿ فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ ﴾ [الطور: 29].
رَحْمَت:
س 569: في كم موضع رسمت "رحمة" بالتاء المفتوحة اتفاقًا؟
ج 569: في سبعة مواضع اتفاقًا، وهي:
1– ﴿ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 218].
2– ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: 56].
3– ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [هود: 73].
4– ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾ [مريم: 2].
5– ﴿ فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾ [الروم: 50].
6– ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف: 32].
7– ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: 32].
يوم القيامة:
س 570: ما هي أسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن الكريم؟
ج 570: يوم الدين: ﴿ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4]. الآخرة: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: 4]. يوم القيامة: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 85]. الدار الآخرة: ﴿ قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ﴾ [البقرة: 94]. اليوم الآخر: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: 177]. الساعة: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها ﴾ [الأنعام: 31]. يوم الحسرة: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: 39]. يوم البعث: ﴿ وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 56]. يوم الفصل: ﴿ هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الصافات: 21]. يوم التلاق: ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ﴾ [غافر: 15]. يوم الآزفة: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ ﴾ [غافر: 18]. يوم الحساب: ﴿ وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ ﴾ [غافر: 27]. يوم التناد: ﴿ وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ ﴾ [غافر: 32]. يوم الجمع: ﴿ وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [الشورى: 7]. يوم الوعيد: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾ [سورة ق: 20]. يوم الخلود: ﴿ ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ [سورة ق: 34]. يوم الخروج: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ [سورة ق: 42]. الواقعة: ﴿ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ ﴾ [الواقعة: 1]. التغابن: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ ﴾ [التغابن: 9]. الحاقة: ﴿ الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ [الحاقة: 1 - 3]. القارعة: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ ﴾ [الحاقة: 4]. الطامة الكبرى: ﴿ فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى ﴾ [النازعات: 34]. الصاخة: ﴿ فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ [عبس: 33]. الغاشية: ﴿ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1].
-
فوائد البنوك واحدة من أوضح صور الربا التي حرمها الإسلام، وهذا موضوع أشبع حسمًا، وقتل بحثًا، وانتهت الأمة إلى الإجماع على تحريم فوائد البنوك، وصدرت عشرات الفتاوى بتحريمه من قِبَل المؤسسات العلمية، والمجامع الفقهية في كل أصقاع الدنيا.
وبالرغم من هذا الوضوح في تحريم الربا، تخرج علينا بين الفينة والأخرى أصوات ضعيفة علميًّا، مدعومة إعلاميًّا، تفتي بحل فوائد البنوك؛ لأنها معاملة حديثة لم يرد فيها نص، وأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص.
وسنزيد الصورة وضوحًا بذكر تعريف وتحديد العلماء لماهية الربا، وأنواعه، وماهية فوائد البنوك، ومن أي أنواع الربا هي:
تعريف الربا:
1- قبل أكثر من ألف ومائة عام عرف الإمام الزجاج [ت: 311هـ] الربا في تفسيره[1] فقال: "الربا هو كل قرض يُوخَذ به أكثر منه، أو يَجر منفعة".
2– "الربا أن يدفع أحدهم للآخر مالًا لمدة ويأخذ كل شهر قدرًا معينًا، فإذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين أن يدفع رأس المال أجَّل له مدة أخرى بالفائدة التي يأخذها منه، وهذا هو الربا الغالب في المصارف وغيرها ببلادنا، وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم الأخرى"[2].
أنواع الربا:
الربا نوعان: ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، والثاني ربا الفضل.
1- ربا النسيئة: قال الإمام النيسابوري في تعريفه: كانوا في الجاهلية يدفعون المال مدة على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ثم إذا حَلَّ الدَّيْن طالب المديون برأس المال، فإن تعَذَّر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل [3].
2– قال الجصاص[4] في تعريف ربا النسيئة: هو ما كان قرضًا مؤجلًا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلًا من الأجل.
تعريف ربا الفضل: هو بيع الشيء بجنسه متفاضلًا يدًا بيدٍ، مثل أن يبيع جرامًا ذهبًا بجرامين من ذهب يدًا بيدٍ.
حكم الربا:
حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
وردت آيات كثيرة تدل على حرمة الربا، ومنها قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 275 - 279].
ومن السنة:
أحاديث كثيرة، منها:
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)؛ متفق عليه.
2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ"؛ رواه مسلم والترمذي وأحمد.
وبعد أن اتضحت لنا ماهية الربا، وأنواع الربا، نرى أن فوائد البنوك تتطابق تمامًا مع ماهية الربا؛ بل تتفق من كل الوجوه مع أسوأ أنواع الربا وأشدها حرمة وهو ربا النسيئة (ربا الجاهلية)، ويزيد الصورة وضوحًا ما ذكره علماء الاقتصاد في تعريف فوائد البنوك.
فوائد البنوك:
يرى علماء الاقتصاد أن الفائدة عبارة عن زيادة ثابتة ومشترطة ومحددة سلفًا بنسبة معينة من رأس المال، والمتفق عليه بين علماء الاقتصاد: أنها الأجرة أو الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام النقود، أو المبلغ الذي يدفعه المدين إلى رأس المال وهي العائد لسنة واحدة، أو التعويض الذي يتقاضاه رب المال لقاء التأخير في الوفاء بالنقود [5].
فهذا هو تعريف فوائد البنوك لدى علماء الاقتصاد، وهو رصد وتصوير صحيح للواقع المشاهد والمحسوس في معاملات المصارف المالية المعاصرة، وهذا ما دفع علماء الإسلام للقول: بأن فوائد البنوك مطابقة تمامًا لماهية الربا المحرَّم، بل هي أسوأ من ربا الجاهلية، ولا يوجد أدنى فرق بين ماهية فوائد البنوك، وماهية الربا المحرم، والتي نص عليها العلماء منذ قديم الزمان، يقول الإمام الرازي [ت: 606هـ] في تفسيره [6]:
"اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ويكون رأس المال باقيًا، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذَّر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به".
فهذا هو تعريف الإمام الرازي للربا قبل أكثر من ثمانمائة عام، وهو ينطبق تمامًا على فوائد البنوك في المصارف المالية المعاصرة، وما يوجد من فروق فهي فروق شكلية بكل تأكيد لا قيمة لها ولا وزن في ميزان الشريعة الإسلامية؛ ولهذا صدرت عشرات الفتاوى بتحريم فوائد البنوك من المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية، بإجماع كل أعضاء تلك المجامع، بل اعتبر الكثير من العلماء أن فوائد البنوك هي أشَدُّ حرمةً من ربا الجاهلية.
فوائد البنوك هي عين الربا:
وتأسيسًا على ما سبق أجمع العماء على أن فوائد البنوك هي عين الربا، وأي محاولة للبحث عن فروق شكلية بينهما – أي فوائد البنوك والربا- للتوصُّل إلى تحليل ما حَرَّم الله، هي محاولة عبثية يضحك منها السفهاء فضلًا عن الحكماء، وقد انعقد إجماع العلماء على ذلك في القديم والحديث.
يقول الإمام محمد أبو زهرة [7]: "لم يكن نظام الفائدة الذي هو الربا حرامًا في الإسلام وحده من بين الديانات السماوية، بل إن الديانتين السماويتين السابقتين على الإسلام قد صرح بالتحريم فيهما، فهو مُحرَّم في التوراة والإنجيل والقرآن، لا في القرآن وحده، ولا تزال بقية من هذا التحريم في التوراة التي بين أيدينا، وإن كانوا قد نسوا حظًّا مما ذكروا به، ففي سفر التثنية بالإصحاح الثالث والعشرين: لا تقرض أخاك الإسرائيلي ربًا، ربا فضة أو ربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا".
ويقول أيضًا [8]: "وربا القرآن الكريم هو الربا الذي تسير عليه المصارف ويتعامل به الناس، فهو حرام لا شكَّ فيه".
وقد يتوهم البعض أن لفظ "الفائدة" لم يعرفه علماء الإسلام قديمًا، وأنه ظهر بعد نشأة البنوك والمصارف الحديثة، وهذا وهم يكذبه الواقع، ويدحضه التاريخ، فقد عرف علماء الإسلام لفظ "الفائدة" من قديم الزمان، ونصوا على حرمته، جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [9]: "وسئل رحمه الله عن رجل اضطر إلى قرض دراهم فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة"
وفي فتاوى السبكي[10]: "أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان، وصورتها أن يأتي شخص إلى ديوان الأيتام، فيطلب منهم مثلًا ألفًا، ويتفق معهم على فائدتها مائتين أو أكثر أو أقل".
فعبارات الفقهاء قديمًا وحديثًا تنص على أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، وليس هذا اجتهادًا حديثًا توصَّل إليه الفقهاء بعد نشأة المصارف، ففي أول سطر من كتاب بحوث في الربا، نصَّ المصنِّف الإمام محمد أبو زهرة على أن الفائدة هي الربا المحرم في الإسلام واليهودية والمسيحية، ثم نقل بعد ذلك عن رجال الدين المسيحيين تأكيدهم على حرمة فوائد البنوك، وأن الربا انتشر في أوربا لعدة أسباب، من بينها أن علماء الاقتصاد كانوا يوهمون رجال الدين بأن الفائدة القليلة هي أجرة إدارة، أو نحو ذلك، مما يجري الآن للتمويه على علماء الدين المسلمين، وعلى العامة المتدينين[11].
فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية:
الربا هو مبادلة مال بمال وزيادة، فإذا كانت الزيادة يدًا بيد؛ أي: فورية فهو ربا الفضل، وإن كانت الزيادة مؤجلة فهو ربا الجاهلية، وهو أشد أنواع الربا تحريمًا، ويسمى ربا القرآن؛ أي: الربا الذي نصَّ القرآن الكريم على تحريمه، وقد أجمعت الأمة على تحريم ربا الجاهلية، وأما فوائد البنوك فهي أسوأ وأقبح من ربا الجاهلية لعدة أسباب منها:
1– أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودًا فعلية سلعية، وهي الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية، أما البنوك فإنها إلى جانب إقراض ما لديها من ودائع تأخذ فوائد ربوية على ما خلقته من ائتمان أو نقود؛ أي: تأخذ فوائد على نقود وهمية، فالبنك يقرض بالربا ما ليس عنده، وما لا يملكه، بل ما لا وجود له في الواقع، ولا يخفى على الاقتصاديين علاقة خلق النقود بالتضخم وزيادة الأسعار، ويدركون خطر ذلك على الاقتصاد [12].
2– ربا الجاهلية كان يتم بالتراضي بين الطرفين، ويدل على ذلك قول الجصاص في أحكام القرآن[13]: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة، على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به".
فكان ربا الجاهلية يتم بالتراضي بين الطرفين، أما الربا في معاملات البنوك فيتم فرضه فرضًا من قبل البنك دون رضا الطرف الآخر.
3– إذا اقترضت مليونًا بأي عملة من العملات، فأهل الجاهلية كانوا يدفعون المليون كاملة، أما في البنوك الحديثة فيخصم البنك من المليون 10%، أو 20% من البداية، ويعطيك تسعمائة ألف، أو ثمانمائة ألف، ثم يأخذها منك مليونًا، بفائدة 20% تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا حسب سعر الفائدة المحدد من البنك المركزي، فلم يدفع البنك مليونًا، لكنه أخذها مليونًا مضافًا إليها الفوائد.
4– كانت الديون في الجاهلية استثمارية في الغالب، حيث كان يتم استثمارها في التجارة أو الزراعة أو تربية الأنعام، أما الآن فالديون أغلبها استهلاكية، والبنوك معظمها تجارية تقترض لتقرض فقط، ولا عمل لها في الاستثمار إلا نادرًا جدًّا.
فلهذه الأسباب وغيرها اعتبر الراسخون في العلم فوائد البنوك أشدَّ حرمة من ربا الجاهلية، وصدرت العشرات من فتاوى المجامع الفقهية بتحريم فوائد البنوك بالإجماع، ومن هذه الفتاوى على سبيل المثال لا الحصر:
1– المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المنعقد بالقاهرة في المحرم 1385هـ مايو 1965، وحضره خمسة وثمانون فقيهًا من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونص في بنده الأول على أن (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم).
2– المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة، والمنعقد في 1396هـ= 1976م، وحضره أكثر من ثلاثمائة عالم من كبار علماء الفقه والاقتصاد في العالم الإسلامي، وأفتوا بالإجماع - دون أن يشذَّ منهم واحد - بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المحرم الذي لا شك في حرمته.
3- المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت (1403هـ الموافق 1983م) والذي نصَّ على حرمة الفوائد البنكية.
4– قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المؤتمر الثاني بجدة في ربيع الثاني 1406هـ= ديسمبر 1985م حيث نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حَلَّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.
5- قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في مكة المكرمة في رجب 1406هـ= مارس 1986م حيث نص على كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا.
6- المؤتمر الثالث للمصارف الإسلامية المنعقد في دبي (1406هـ الموافق 1986م) وفيه تم التأكيد على حرمة الفوائد البنكية.
وفتاوى المجامع الفقهية التي نصت على حرمة فوائد البنوك بالإجماع أكثر من أن تحصى، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية ودار الإفتاء المصرية وغيرها فتاوى يصعب حصرها كلها تنص على حرمة فوائد البنوك بالإجماع، وهذا ما يجعل هذا الأمر قطعيًّا لا مجال فيه للظَّنِّ، والله أعلم، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
[1] تفسير الزجاج 4/ 187، الناشر: عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م.
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 222، عبدالرحمن الجزيري (ت 1360هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م.
[3] تفسير النيسابوري 2/ 60، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى - 1416 هـ.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2/ 186، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تاريخ الطبع: 1405 هـ.
[5] تقويم التجربة المصرفية ص 66/ 67، دكتور عبدالحميد الغزالي، ودكتور عادل عيد، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى 1434هـ 2013م.
[6] مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 7/ 72، لفخر الدين الرازي (ت 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.
[7] بحوث في الربا ص 5، للإمام محمد أبو زهرة، الناشر دار الفكر العربي، القاهرة 1420هـ = 1999.
[8] بحوث في الربا، ص 22.
[9] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 430، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، السعودية، 1416هـ = 1995م.
[10] فتاوى السبكي 1/ 327، لعلي بن عبدالكافي السبكي، الناشر دار المعرفة، بيروت.
[11] بحوث في الربا ص 10.
[12] تقويم التجربة المصرفية 72 ،73.
[13] أحكام القرآن للجصاص 2/ 184، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 1405هـ = 1985م، تحقيق محمد الصادق قمحاوي.
شبكة الالوكة
-
سورة الحج﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣﴾] هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد؛ كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين أهل الكتاب وأهل البدع؛ فإنهم يجادلون في الله بغير علم، ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. ابن تيمية:4/401.
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣﴾] قال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة; لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله: (ما ضربوه لك إلا جدلا) [الزخرف: 58]، والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: 125] أ.هـ منه. الشنقيطي:4/263.
﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢﴾] تشبيه بالسكارى من شدّة الغمّ. ابن جزي:2/49.
﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢﴾] إنما لم يقل مرضع؛ لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال: (مرضعة) ليكون ذلك أعظم في الذهول؛ إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. ابن جزي:2/ 48.
﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢﴾] مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصاً في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها. السعدي:533.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١﴾] فائدة ذكر هول ذلك اليوم: التحريض على التأهب له، والاستعداد بالعمل الصالح. القرطبي: 14/311.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١﴾] يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم؛ الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه، بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. السعدي:532.
﴿ يَدْعُوا۟ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٣﴾] لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره، فإذا تخلف ذلك منهما نادراً كان مذمة وغضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مطرداً فذلك شر الموالي. ابن عاشور:17/216.
﴿ يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا۟ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٢﴾] (يدعو لمن ضره أقرب من نفعه): فيها إشكالان: الأول: في المعنى؛ وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرّها أقرب من نفعها، فنفى الضرّ، ثم أثبته، فالجواب: أن الضر المنفي أولاً يراد به ما يكون من فعلها؛ وهي لا تفعل شيئاً، والضر الثاني: يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. ابن جزي:2/51.
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١١﴾] أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه: إما خوفاً، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. السعدي:534.
﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١١﴾] أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أَمَّله الذي جعل الردة رأساً لماله، وعوضاً عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له. السعدي:535.
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١١﴾] نزلت في قوم من الإعراب: كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال: هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به، وارتدّ عن الإسلام. ابن جزي:2/50.
﴿ ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٩﴾] (له في الدنيا خزي): وهو الإهانة والذل؛ كما أنه استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا، وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. ابن كثير:3/203.
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٨﴾] فليس عنده علم ضروري، ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي، ولا علم من وحي، فهو جاهل محض من جميع الجهات. الشنقيطي:4/280.
﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٣﴾] (ولباسهم فيها حرير): في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم. ابن كثير:3/207.
﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٢﴾] (وذوقوا عذاب النار): ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً. ابن كثير:3/207.
﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٩﴾] قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه، وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب، وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من نار. القرطبي:15/462.
﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٨﴾] يقول تعالى ذكره: ومن يهنه الله من خلقه فيشقه، (فما له من مكرم) بالسعادة يسعده بها؛ لأن الأمور كلها بيد الله، يوفق من يشاء لطاعته، ويخذل من يشاء، ويشقي من أراد، ويسعد من أحب. وقوله: (إن الله يفعل ما يشاء): يقول تعالى ذكره: إن الله يفعل في خلقه ما يشاء من إهانة من أراد إهانته، وإكرام من أراد كرامته؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره. الطبري:18/587.
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٨﴾] يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً، وسجود كل شيء مما يختص به. ابن كثير:3/205.
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٨﴾] ما من جماد إلا وهو مطيع للّه، خاشع للّه، مسبح له، كما أخبر اللّه تعالى عن السماوات والأرض. البغوي:3/206.
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿١٨﴾] (والشمس والقمر والنجوم): إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عُبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة. ابن كثير:3/205.
﴿ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٠﴾] ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي؛ لِكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلّق الخبث بالأجساد. ابن عاشور:17/253.
﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٠﴾] أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه، ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه (فهو خير له عند ربه)؛ فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل؛ كذلك على ترك المحرمات، واجتناب المحظورات. ابن كثير:3/212.
﴿ وَلْيَطَّوَّفُو ا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٩﴾] قال قتادة: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط، وقال سفيان بن عيينة: سمي عتيقاً لأنه لم يملك قط. البغوي:3/216.
﴿ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٧﴾] ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك؛ حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس؛ لأن للنفوس ميلاً إلى المحسوسات؛ ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس. ابن عاشور:17/243.
﴿ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٧﴾] وقد حصل ما وعد الله به؛ أتاه الناس رجالاً وركباناً من مشارق الأرض ومغاربها. السعدي:537.
﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِين َ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٦﴾] وتطهير البيت عام في الكفر، والبدع، وجميع الأنجاس، والدماء. القرطبي:14/359.
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٢٥﴾] «الإلحاد»: الميل عن الصواب، و«الظلم» هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ لأن الذنوب في مكة أشدّ منها في غيرها، وقيل: هو استحلال الحرام. ابن جزي:2/54.
﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٧﴾] المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى؛ أي: بالإخلاص لله، وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا، فعبر عن هذا المعنى بلفظ: (لن ينال) مبالغة وتأكيداً؛ لأنه قال: لن تصل لحومها، ولا دماؤها إلى الله، وإنما تصل بالتقوى منكم؛ فإن ذلك هو الذي طلب منكم، وعليه يحصل لكم الثواب. ابن جزي:2/58.
﴿ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٦﴾] مَنَّ سبحانه علينا بتذليلها، وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبداناً، وأقوى منا أعضاء؛ ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير؛ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله، الواحد، القهار فوق عباده. القرطبي:14/403.
﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٦﴾] فالمعنى: أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية، ومن تعرض للعطاء. ابن جزي:2/58.
﴿ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٤﴾] وقد أتبع صفة (المخبتين) بأربع صفات، وهي: وجل القلوب عند ذكر الله، والصّبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق. ابن عاشور:17/261.
﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٢﴾] فالمقصود تقوى القلوب لله؛ وهو: عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة، وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل، وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل. ابن تيمية:4/427.
﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣٢﴾] وتعظيمها: إجلالها، وتوقيرها، والقصد إليها. وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها: القيام بها، وإجلالها. ابن جزي:2/56.
﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٣١﴾] قيل: شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع؛ بحيث تسقطه الريح، فهو هالك لا محالة؛ إما باستلاب الطير لحمه، وإما بسقوطه إلى المكان السحيق، وقال الحسن: شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل؛ فلا يقدرون على شيء منها. البغوي:3/218.
﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٦﴾] معناه: أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. البغوي:14/224.
﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤١﴾] فمن قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه. ابن تيمية: 4/434.
﴿ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٠﴾] أي: من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحض على القتال. ابن جزي:2/59.﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٠﴾]
ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر، ولم يذكر في هذه المجوس، ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته، ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. ابن عطية:4/125.﴿ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٠﴾]
ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين، وببركتهم دفع الله عنها الكافرين. السعدي:539.﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٠﴾]
الآية تقوية للإذن في القتال، وإظهار للمصلحة التي فيه؛ كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. ابن جزي:2/59.﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٠﴾]
وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله، وذبُّ الكفار المؤذين للمؤمنين. السعدي:539.﴿ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٣﴾]
(ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة) لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم؛ وهم: الذين (فِي قُلُوبِهِم مَّرِضٌ) أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم؛ فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. (وَالقاسِيَةِ قُلوبُهُمْ) أي: الغليظة، التي لا يؤثر فيها زجر، ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها... فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها؛ وهم المذكورون بقوله: (وَلِيَعْلَمَ اَّلذِينَ أُوتُواْ العِلْمَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ)؛ لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل، والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين. السعدي:542.﴿ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٣﴾]
أي: محنة، وبلية، وشك، ونفاق. (وَالقاسِيَةِ) يعني: الجافية (قُلوبُهُمْ) عن قبول الحق؛ وهم المشركون؛ وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك. البغوي:3/228.
﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٠﴾]
ووصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءَه من المكدرات. ابن عاشور:17/294.﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٤٨﴾]
فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجباً لمبادرتنا بالعقوبة. السعدي:541.﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٥﴾]
يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده، ولا يوم؛ لأنهم يقتلون فيه. ابن جزي:2/62.﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٤﴾]
الحق كلما جودل أهله ظهرت حججه، وأسفرت وجوهه، ووضحت براهينه، وغمرت لججه؛ كما قال تعالى: (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) [البقرة: 26]. (فيؤمنوا به) لما ظهر لهم من صحته بما ظهر من ضعف تلك الشبه، (فتخبت) أي: تطمئن وتخضع (له قلوبهم) وتسكن به قلوبهم؛ فإن الله جعل فيها السكينة. البقاعي:13/73.﴿ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٣﴾]
جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية، وذات مرض، ومؤمنة مخبتة. ابن تيمية:4/441.﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٢﴾]
ومن كبريائه: أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض؛ كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه؛ ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار؛ كالصلاة وغيرها. السعدي:544.﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦١﴾]
فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدّين على ضدّه، وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الملحمة، فضرب له مثلاً بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة، وتغليب مدة الليل على مدة النهار في بعضها. ابن عاشور:17/314.﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٠﴾]
فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ ليعاملكم الله كما تعاملون عباده؛ (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى: 40]. السعدي:543.﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٠﴾]
(إن الله لعفو غفور): إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعاراً بأن العفو أفضل من العقوبة؛ فكأنه حض على العفو، والثاني: أن في ذكرهما إعلاماً بعفو الله عن المعاقِب حين عاقب. ابن جزي:2/62.﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا۟ أَوْ مَاتُوا۟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٨﴾]
يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم، فتركوا ذلك في رضا الله، وطاعته، وجهاد أعدائه، ثم قتلوا، أو ماتوا وهم كذلك؛ ليرزقنهم الله يوم القيامة في جناته رزقا حسنا؛ يعني بالحسن: الكريم. الطبري:18/673.
﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا۟ أَوْ مَاتُوا۟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٨﴾]
خص بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويهاً بشأن الهجرة. ابن عاشور:17/309.﴿ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٥٧﴾]
(مُّهِينٌ) لهم من شدته، وألمه، وبلوغه للأفئدة؛ كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. السعدي:543.﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٢﴾]
(قل) أي: يا محمد لهؤلاء: (أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا) أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم. ابن كثير:5/396.
﴿ وَإِن جَٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٨﴾]
في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء: ألا يجاب، ولا يناظر، ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. القرطبي:14/445.
﴿ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٧﴾]
أي: لا ينازعك المكذبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد... وكقولهم: (إنما البيع مثل الربا) [البقرة:275]، ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها وهم منكرون لأصل الرسالة... فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز. السعدي:545.﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٦﴾]
أي: لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته، ووحدانيته. وقيل: إنما قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم؛ كما قال تعالى: (وقليل من عبادي الشكور) [سبأ: 13]. القرطبي:14/442.
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٥﴾]
(إن الله بالناس لرؤوف رحيم): أرحم بهم من والديهم، ومن أنفسهم؛ ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشر والضر، ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. السعدي:545.
﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٥﴾]
فيكون قوله: (ويمسك السماء) امتناناً على الناس بالسلامة مما يُفسد حياتهم، ويكون قوله: (إِلاَّ بِإِذْنِهِ) احتراساً؛ جمعاً بين الامتنان والتخويف. ابن عاشور:17/323.﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٦٥﴾]
وإنما خصّ هذا بالذكر؛ لأن ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير؛ إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة لكان حظها من البحر الغَرق. ابن عاشور:17/322.
﴿ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٨﴾]
أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا، فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله، فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعة فيه، ولا مصلحة لنا. ابن تيمية:4/ 448.
﴿ وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٨﴾]
الجهاد: بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب، فالجهاد في الله حق جهاده هو: القيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ من: نصيحة، وتعليم، وقتال، وأدب، وزجر، ووعظ، وغير ذلك. السعدي:547.﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٧﴾]
(وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ): عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات.﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٧﴾]
المراد بالركوع والسجود الصلوات، وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة؛ إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. ابن عاشور:17/346.﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٧﴾]
فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على مساوي أعمالهم خُتمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يُصلح أعمالهم، وينوّه بشأنهم، وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. ابن عاشور:17/345.﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٥﴾]
فاصطفى الله جبريل من الملائكة، واصطفى محمداً من البشر. ابن تيمية:4/444.
﴿ مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴾ [سورة الحج آية:﴿٧٤﴾]
وقوله: (ما قدروا الله حق قدره) يقول: ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة لله شريكا في العبادة حق عظمته حين أشركوا به غيره، فلم يخلصوا له العبادة، ولا عرفوه حق معرفته؛ من قولهم: ما عرفت لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك من قصر بحقه، وهم يريدون تعظيمه. الطبري:18/686.
-
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُم....}السخرية من الناس تنم عن كبر في قلب صاحبها، وتعالٍ على من سخر بهم، فلا يرى لهم عليه حق التوقير والاحترام، ويأنف من أُخُوتهم وهم إخوانه في الدين، والكبر من كبائر الذنوب، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " ثم فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه " بطر الحق وغمط الناس" وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم؛ وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص.والسخرية تقود إلى الغيبة وهي من كبائر الذنوب، فقد لا يستطيع السخرية بحضرة أخيه، فيسخر به من ورائه؛ فتكون سخرية وغيبة، ويكون هو بمثابة من أكل لحم أخيه ميتا.
وصاحب السخرية لا بد أن يكون همازا لمازا، واللمز هو المباشرة بالسوء والمكروه، والمواجهة بالقدح والعيب، ويكون بالقول. والهمز يكون بالفعل كأن يعيبه بالإشارة بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه.
وهذان الخلقان الذميمان اتصف بهما بعض المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فكانوا يهمزونهم ويلمزونهم، فأنزل الله تعالى فيهم سورة الهمزة (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) [الهمزة:1] وتوعدهم فيها بنار الله الموقدة (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) [الهمزة:7-9].
فالهماز اللماز في الناس متصف بصفات المشركين، متخلق بأخلاق أهل السعير، ويناله من الوعيد في ذلك بقدر همزه ولمزه في إخوانه المسلمين. كما أن الهماز قد أخذ من الشياطين بعض صفاتهم التي أمر الله تعالى نبيه أن يتعوذ بالله تعالى منها (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) [المؤمنون:98] فالهماز من الشياطين يطعن بني آدم بالصرع والمس، والهماز من البشر يطعن أخاه بالعيب والنقص.
والهماز قد يسعى بالنميمة وهي من كبائر الذنوب، وقد حذر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام منه (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) [القلم:10-11] .
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُم....} [ الحجرات: ١١]
أيها الساخر : احفظ لسانك فالميزان سماوي لايحدده جاه أو مال أو جمال ، بل يحدده قلب تقيّ نقيّ
لكي لاتسخر لاتراقب .. لاتغرك المظاهر قد يكون من تسخر منه أفضل منك عند الله ... احتقارك للآخرين هو احتقار لإنسانيتك ، وعندما تلمز الآخرين تفتح على نفسك ثغرات تظلم بها نفسك ..
أخوك هو أنت في موازين هذا الدين . لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحبه لنفسه
نهى الإسلام أن يُعير المسلم أخيه التائب فيما كان يفعل قبل توبته (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) الظلم لايعني سفك الدماء فقط ، فقد يحيا المرء ظالماً لنفسه بارتكاب المحرمات ! عندما تسخر من الآخرين تعمل على زيادة حسناتهم وتستزيد لنفسك بضاعة مزجاة !! كن حذراً
-
الباب الأول: الفضل بالسبق للذاكرين الله كثيرًا والذكرات:
عن أبي هريرة، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير في طريق مكة، فمرَّ على جبل يُقال له جُمْدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المُفرِّدون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا، والذاكرات))[1].
وعن أبي الدرداء، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألَا أُنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والوَرِق، وخير لكم من أن تلقَوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله تعالى، قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله))[2].
الباب الثاني: فضل حياة قلب وروح الذاكر لربِّه على الحقيقة:
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَثَلُ الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت))[3].
وفي رواية لمسلم: ((مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت))[4].
الباب الثالث: فضل من قال: الذكر عند المتضمن بالإيمان بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم:
عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قُل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن متَّ من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال: فردَّدتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت))[5].
وفي رواية: ((فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت، أصبت خيرًا))[6].
الباب الرابع: فضل الذكر والدعاء بعد الاستيقاظ من النوم:
عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعارَّ من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإن توضأ وصلى، قُبلت صلاته))[7].
وعن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا، فيتعار من الليل، فيسأل الله خيرًا من الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه))[8].
الباب الخامس: فضل إحسان الوضوء والذكر بعده:
عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره))[9].
وعن عقبة بن عامر، قال: ((كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبلًا عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة، قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدالله ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء))[10].
الباب السادس: فضل الأذان:
عن أنس بن مالك، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجتَ من النار، فنظروا فإذا هو راعي مِعزًى))[11].
الباب السابع: فضل من قال هذا الذكر حيث يسمع الأذان:
عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا، غُفر له ذنبه))، قال ابن رمح في روايته: ((من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد))، ولم يذكر قتيبة قوله: "وأنا"[12].
الباب الثامن: فضل الترديد خلف المؤذن، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله له الوسيلة:
عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة))[13].
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ؛ فإنه من صلى عليَّ صلاةً، صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلَّت له الشفاعة))[14].
الباب التاسع: فضل إجابة دعاء من قال ما يقول المؤذن ثم دعا:
عن عبدالله بن عمرو، ((أن رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت، فسَلْ تُعْطَهْ))[15].
الباب العاشر: فضل كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة:
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألَا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط))[16].
وعن أنس رضي الله عنه، قال: ((أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرى المدينة وقال: يا بني سلمة ألَا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا))[17].
وعن عباية بن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اغبرَّت قدماه في سبيل الله، حرَّمه الله على النار))[18].
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تطهَّر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضةً من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةً، والأخرى ترفع درجةً))[19].
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، خمسًا وعشرين درجةً، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، وأتى المسجد، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطُ خطوةً إلا رفعه الله بها درجةً، وحط عنه خطيئةً، حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد، كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي - يعني الملائكة – عليه، ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يُحدث فيه))[20].
الباب الحادي عشر: فضل الدعاء بين الأذان والإقامة:
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة))[21].
الباب الثاني عشر: فضل من حمِد الله بهذا الذكر عند الاستفتاح للصلاة:
عن أنس: ((أن رجلًا جاء فدخل الصف وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ، فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرمَّ القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال: لقد رأيت اثني عشر مَلَكًا يبتدرونها، أيهم يرفعها))[22].
الباب الثالث عشر: فضل من أمَّن خلف الإمام فوافق تأمينه تأمين الملائكة:
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمَّن الإمام، فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين))[23].
الباب الرابع عشر: فضل من قال الذكر بعد الرافع موافقًا تأمين الملائكة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه))[24].
الباب الخامس عشر: فضل من سبَّح الله وحمده وكبَّره دُبر كل صلاة:
عن أبي هريرة: ((أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا، والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويُعتقون ولا نُعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفَلَا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبِّحون، وتكبِّرون، وتحمدون، دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرةً، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء))[25].
الباب السادس عشر: فضل من قال سيد الاستغفار حين يصبح أو يمسي موقنًا بها قلبه:
عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال: ومن قالها من النهار موقنًا بها، فمات من يومه قبل أن يُمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة))[26].
الباب السابع عشر: فضل من قال هذا الذكر بعد صلاة الصبح:
عن ابن عباس، عن جويرية: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرةً حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: ما زلتِ على الحال التي فارقتكِ عليها؟ قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلتُ بعدكِ أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وُزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنَّ: سبحان الله وبحمده، عددَ خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته))[27].
الباب الثامن عشر: فضل من قال هذا الذكر مائة مرة أو زاد عن ذلك:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي، ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك))[28].
الباب التاسع عشر: فضل التسبيح بحمد الله في يوم مائة مرة أو زاد على ذلك:
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال: حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده، مائة مرة، لم يأتِ أحد يوم القيامة، بأفضلَ مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه))[29].
الباب العشرون: فضل أعمال فاضلة متنوعة للعبد المسلم من ذكر واستغفار، وكفِّ أذًى، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر بدخول الجنة:
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه خُلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفصل، فمن كبَّر الله، وحمِد الله، وهلَّل الله، وسبَّح الله، واستغفر الله، وعزل حجرًا عن طريق الناس، أو شوكةً أو عظمًا عن طريق الناس، وأمَر بمعروف أو نهى عن منكر، عددَ تلك الستين والثلاثمائة السُّلامى، فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار، قال أبو توبة: وربما قال: يمسي))[30].
الباب الحادي والعشرون: فضل من سقى كلبًا رحمة به:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بينما كلب يَطِيف بركية، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مَوقها فسقَته، فغُفر لها به))[31].
الباب الثاني والعشرون: فضل من كف الأذى عن الطريق:
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجل يمشي بطريقٍ وَجد غصن شوكٍ على الطريق فأخَّره، فشكر الله له فغفر له))[32].
الباب الثالث والعشرون: فضل طهارة القلب وصدق اللسان:
عن عبدالله بن عمرو، قال: ((قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان، نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غلَّ، ولا حسد))[33].
الباب الرابع والعشرون: فضل الحامد لربه بعد تناوله لطعامه وشرابه:
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لَيرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمَده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها))[34].
الباب الخامس والعشرون: فضل الكلمة من رضوان الله، وإمساك اللسان عن كل ما لا يجوز، والعزلة حين تغير حال الناس:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد لَيتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يُلقي لها بالًا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالًا، يهوي بها في جهنم))[35].
وعن عقبة بن عامر، قال: ((قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك))[36].
الباب السادس والعشرون: فضل من اكتفى بعد عبادة ربه بأن يدَع الناس عن شره:
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من خير معاش الناس لهم، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعةً، أو فزعةً طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانِّه، أو رجل في غنيمة في رأس شَعَفة من هذه الشعف، أو بطن وادٍ من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير))[37].
وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنًا، وأنفَسها عند أهلها، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرق، قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك))[38].
الباب السابع والعشرون: فضل التصدق بشق تمرة أو بكلمة طيبة:
عن عدي بن حاتم، قال: ((ذَكَرَ النبي صلى الله عليه وسلم النار، فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه - قال شعبة: أما مرتين فلا أشك - ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة))[39].
الباب السابع والعشرون: فضل من سأل الله الجنة واستعاذ به سبحانه من النار:
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجِره من النار))[40].
والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات.
[1] مسلم 4 - (2676)، وأحمد (9332)، وابن حبان (858).
[2] صحيح: رواه أحمد (21702)، والترمذي (3377)، وابن ماجه (3790)، وصححه الألباني.
[3] رواه البخاري (6407).
[4] رواه مسلم 211 - (779)، وابن حبان (854).
[5] البخاري (247)، ومسلم 56 - (2710).
[6] رواه البخاري (7488)، ومسلم 58 - (2710).
[7] البخاري (1154)، وأحمد (2596)، وأبو داود (5060)، والترمذي (3414)، وابن ماجه (3878)، وابن حبان (2596).
[8] صحيح: رواه أحمد (22092)، أبو داود (5042)، وابن ماجه (3881)، وصححه الألباني.
[9] مسلم 33 - (245).
[10] مسلم 17 - (234)، وأبو داود (169)، وأحمد (17314)، والترمذي (55)، والنسائي (148)، وابن ماجه (470).
[11] مسلم 9 - (382)، وأحمد (12351)، والترمذي (1618)، وابن حبان (4753).
[12] مسلم 13 - (386).
[13] البخاري (614)، وأحمد (14817)، وأبو داود (529)، والترمذي (211)، والنسائي (680)، وابن ماجه (722).
[14] مسلم 11 - (384)، وأحمد (6568)، أبو داود (523)، والترمذي (3614)، والنسائي (678).
[15] حسن صحيح: رواه أحمد (6601)، وأبو داود (524)، وابن حبان (1695)، وقال الألباني: حسن صحيح.
[16] مسلم 41 - (251)، وأحمد (7729)، والترمذي (51)، والنسائي (143)، وابن ماجه (428)، وابن حبان (1038).
[17] البخاري (1887)، وأحمد (12033)، وابن ماجه (784).
[18] البخاري (907)، وأحمد (15935)، والترمذي (1632)، والنسائي (3116)، وابن حبان (4605).
[19] مسلم 282 - (666)، والترمذي (603)، وابن ماجه (774)، وابن حبان (2044).
[20] البخاري (647) واللفظ له، ومسلم 246 - (649).
[21] صحيح: رواه أحمد (12200)، وأبو داود (521)، والترمذي (212)، وابن حبان (1696).
[22] مسلم 149 - (600).
[23] البخاري (780)، ومسلم 72 - (410).
[24] البخاري (6306)، وأحمد (17111)، والترمذي (3393)، والنسائي (5522)، وابن حبان (933).
[25] البخاري (796)، ومسلم 71 - (409)، وأحمد (9923)، والترمذي (267)، والنسائي (848).
[26] البخاري (843)، ومسلم 142 - (595).
[27] مسلم 79 - (2726)، وأحمد (27421)، وأبو داود (1503)، والترمذي (3555)، وابن ماجه (3808)، وابن حبان (832).
[28] البخاري (3293)، ومسلم 28 - (2691).
[29] مسلم 29 - (2692)، وأبو داود (5091)، والترمذي (3469)، وابن حبان (860).
[30] مسلم 54 - (1007).
[31] البخاري (3467)، ومسلم 155 - (2245)، وأحمد (10621)، وابن حبان (386).
[32] البخاري (652)، ومسلم 164 - (1914).
[33] صحيح: رواه ابن ماجه (4216)، وصححه الألباني.
[34] مسلم 89 - (2734)، وأحمد (12168)، والترمذي (1816).
[35] البخاري (6478) واللفظ له، ومسلم 49 - (2988) مختصرًا على الشطر الثاني، وأحمد (8411)، وابن حبان (5707).
[36] صحيح: رواه أحمد (17334)، والترمذي (2406)، وصححه الألباني.
[37] البخاري (2518)، ومسلم 136 - (84).
[38] مسلم 125 - (1889).
[39] البخاري (6023)، ومسلم 68 - (1016).
[40] صحيح: رواه أحمد (13173)، والترمذي (2572)، والنسائي (5521)، وابن ماجه (4340)، وابن حبان (1034)، وصححه الألباني.
شبكة الالوكة
-
الأنبياء والرسل
تعرف الناس بالآله الحق (المعبود)
وتعرفهم بما يصلح آخرتهم (العبادات)
وتعرفهم بما يصلح دنياهم (العادات)
فإرسالهم من أعظم النعم والمنن ﴿لقدمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولامن أنفسهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوامن قبل لفي ضلال مبين﴾
تخيل أن رجلًا ذهب إلى الله، ثم يرسل لك وصية بعد أن انتقل عن الدنيا؟ فكيف ستكون أهمية وصيته؟ فهذا إبراهيم أعلم الناس بالله بعد نبينا يرسل لنا وصية بعد موته وارتحاله عن هذه الدنيا..
إنها وصية قادمة من رجل سبقنا في الرحلة إلى المستقبل الأبدي.. فكأنها وصية قادمة من المستقبل.. وماذا كانت هذه الوصية..
إنها الوصية بأمور تبني لك موقعًا في الجنة: «يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».
-
{يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُمۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ} [الحجرات : ١٧]
فَمَا الَّذِي فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِنْ أَنْتَ ظَفِرْتَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ؛ إِنْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدِ اصْطَفَاكَ وَاجْتَبَاكَ مِنْ بَيْنِ الْبَشَرِ وَجَعَلَكَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالطَّرِيقِ الْقَوِيمِ؟
رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قَالَ: آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: «آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».
إِنَّ نُورَ الْهِدَايَةِ قَدْ يُقْذَفُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتِ الْآلَةُ كَالَّةً وَالْفَهْمُ ضَئِيلًا! وَقَدْ يُسْلَبُهَا مَنْ كَانَ فَطِنًا ذَكِيًّا حَادَّ الذَّكَاءِ، لَهُ اعْتِبَارَاتُهُ فِي عَالَمِ الدُّنْيَا، أَبْحَاثٌ دَقِيقَةٌ وَدِرَاسَاتٌ عَمِيقَةٌ، وَلَهُ مِنَ الْأَلْقَابِ مَا يَكِلُّ مِنْهَا اللِّسَانُ، تَقُومُ لَهُ الدُّنْيَا وَلَا تَقْعُدُ، وَمَعَ هَذَا يَعْبُدُ بَقَرَةً أَوْ فَأْرَةً أَوْ حَجَرًا أَوْ شَجَرًا!! حَتَّى تُدْرِكَ أَيُّهَا الْمُوَفَّقُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمَقَايِيسِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَا عِبْرَةَ بِهَا فِي الْمَوَازِينِ الْأُخْرَوِيَّةِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَءُوا، ] فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا [ [الكهف:105]» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]. فَالْعِبْرَةُ بِمَا حَمَلَ الْجَنَانُ مِنْ أَنْوَارِ الْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ، وَلِذَا فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَسْتَشْعِرُونَ نِعْمَةَ الْهِدَايَةِ عِنْدَمَا يَدْخُلُونَهَا؛ قَالَ اللهُ: ] وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلّٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُۖ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّۖ وَنُودُوٓاْ أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ [ [الأعراف:43]. بَلْ إِنَّ أَحَدَهُمْ رُبَّمَا تَذَكَّرَ قَرِينَهُ وَصَاحِبَهُ الَّذِي كَانَ يَؤُزُّهُ إِلَى الشَّرِّ أَزًّا؛ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَصَمَهُ عَنْ سُلُوكِ سَبِيلِ الرَّدَى وَيَسَّرَ لَهُ طَرِيقَ الْهُدَى؛ ]فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَسَآءَلُونَ * قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٞ * يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُصَدِّقِينَ * أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلۡ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ * فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ * قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرۡدِينِ[ [الصافات:50-56].

{يَمُنُّونَ عَلَيۡكَ أَنۡ أَسۡلَمُواْۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَٰمَكُمۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ} [الحجرات : ١٧]
إذا أعجبتك نفسك عند الطّاعة فذكرها بهذه الآية ..
من هُدي إلى الإيمان وعمل بأركان الإسلام فهو الموفق وليسأل ربه الثبات وحسن الختام ..
الهداية للإيمان أعظم منن الرحمن ، كل صواب من أعمالك فالمنة فيها لله ، ومن أعظم نعم الله على عبده توفيقه للطاعة ، ومن أعظم الخذلان بعد الطاعة أن يمن العبد بطاعته .
انكسار المذنب ، وحرقة قلبه ، وصدق توبته خيرٌ من كِبر وإعجاب الطائع وإدلائه بعمله .. يمنون أن سلكوا الطريق إلى الجنة !!.. لا بل المنة لله وحده من قبل ، أن وفقهم لذلك ، والمنة له من بعد ، أن لم يؤاخذهم بما قالوا !!..
(رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه) -
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات : 13]
كيف يتفاخر الناسُ بالآباء والأحساب والأنساب؛ وآدمُ عليه السلام هو أبو البشر جميعاً؟! وقد خُلِقَ من تُراب؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ؛ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» صحيح – رواه أبو داود. فأصل البشر جميعاً إلى التُّراب والطِّين، فلا يجوز لأحد – بعد ظهور هذه الحقيقة – أنْ يَفتخر بآبائه ونسبه على أحد؛ فإنَّ التفاضل بين بني آدم لا يكون إلاَّ بالتقوى.
ولَمَّا خَطَبَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ؛ إِلاَّ بِالتَّقْوَى» صحيح – رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» رواه مسلم. قَالَ شُرَيْحٌ: (كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ) رواه البخاري.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ» صحيح – رواه الترمذي.
ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالآباء الذين ماتوا، فقال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ [هو دُويبة أرْضِية] الَّذِى يُدَهْدِهُ [أي: يُدَحْرِج] الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ [الكِبْرُ وَالفَخْرُ] إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ» حسن – رواه الترمذي.
ونَهَى - أيضاً - عن احتقار الناس وازدرائهم، وأبان بأنَّ ذلك يصدر – في الغالب – عَمَّنْ غلب عليه داءُ الكِبْرِ والجهل، لذا يَسْتَصْغِرُ غيره، ويَنْظُر إلى نفسه بعين الرضا؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ [أي: دَفْعُهُ ورَدُّه] وَغَمْطُ النَّاسِ [أي: هو احتقارُهم وازدراؤُهم]» رواه مسلم.
فلا ينبغي أن يغتر الناس بالمظاهِرِ والصُّور، والأشخاصِ والأجسام، وإنما المقياس بالأعمال والقلوب؛ فعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الأَرَاكِ - وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ - فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِمَّ تَضْحَكُونَ؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ» حسن - رواه أحمد. دل الحديثُ: على أنَّ الذي يثقل في الميزان صحيفةُ الأعمال، لا أشخاصُ العاملين.
ويوم القيامة تُكشَفُ الحقائِقُ، وتُبلى السَّرائرُ، فَرُبَّ شَخْصٍ عَظِيمٍ في بدنه، مُعَظَّمٍ عند قومِه، وهو لا يَزِنُ عند الله جناحَ بعوضة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: اقْرَءُوا: ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف:105]» رواه البخاري ومسلم. دل الحديث: على أنَّ السِّمَنَ المُكْتَسَب للرِّجال مذموم؛ وسبب ذلك؛ أنَّ السِّمَنَ المُكْتَسَب إنما هو كثرة الأكل، والشَّرَه، والدَّعَة، والراحة، والاسترسال مع النفس على شهواتها.
(إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) التقوى مقياس ربّاني ، الأكرم هو الأتقى
ليس في كتاب الله آية يمدح فيها أحداً بنسبه ولا يذم أحداً بنسبه ، وإنما يمدح الله الإنسان بإلإيمان والتقوى .. ألا تحب أن تكون أكرم الناس ؟ اتق الله
هذه الآية الكريمة تُلغي الكِبر والإعتزاز بالنسب . من أنت ؟ لاتقل أصلي وفصلي أبداً إنما أصل الفتى ماقد حصل .
يُكرم الإنسان بتقواه وأخلاقه لابنسبه وشهاداته ، ويرفع الله عباده بالتواضع ، ويرزقهم القبول في الأرض ويوم العرض .. يمدحهم بالإيمان الراسخ في قلوبهم ويذمهم بالكفر والمعاصي .. هذا هو الميزان الحق ، وما عداه هو باطل ..
د. محمود بن أحمد الدوسري
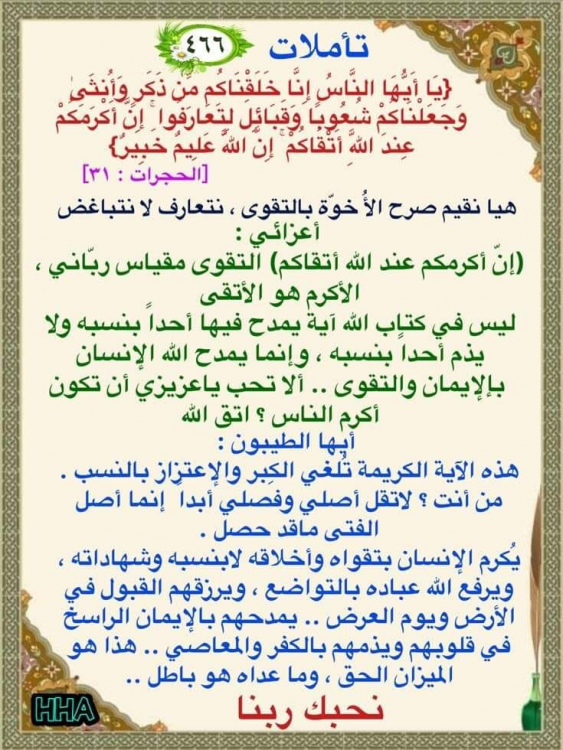
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
- ” وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا … ” تضيف لهم ….. ويضيفون لك … / نايف الفيصل
- ألاَ تحب أن تكون أكرم الناس ؟ ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾/ نايف الفيصل
- {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ليس في كتاب الله آية يمدح فيها أحدا بنسبه ، ولا يذم أحدا بنسبه ، وإنما يمدح بالإيمان والتقوى . ابن تيمية/ نايف الفيصل
- “إن أكرمكم عند الله أتقاكم …. ” مقياس رباني ……. (الأكرم هو الأتقى)/ نايف الفيصل
- ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ آية تُلغي الكبر والاعتزاز بالنسب.. من أنت ؟ لا تقل أصْلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل/ نايف الفيصل
- ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ؛ يرفعهم بالتواضع ، يرزقهم القبول في الأرض ويوم العرض ، أحباؤه وأصفياؤه ، عُليَة القوم. / فرائد قرآنية
-قالوا : المَرءُ بآدابه لا بثيابه، وبفَضِيلته لا بفَصيلته ، وبأنبائه لا بآبائه ، وبكماله لا بجَمَاله... ومصداقه في كتاب الله : . ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ .
-}إن أكرمكم عند الله أتقاكم{ التفضيل ليس بالفقر والغنى، ولا بالعافيه والبلاء، ولا بالحر والعبد، وإنما فضّل الله الناس بالتقوى.
حصاد التدبر -
إن من أعظم أسباب صلاح القلوب، وتزكية النفوس: الحرص على تدبر آيات القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 29]، فإن التدبر يورث اليقين، ويزيد الإيمان، وهو طريق إلى العمل بما في القرآن من المأمورات، والكف عن المنهيات، وهو سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه، وكل ذلك يزيد القلب تعظيمًا للقرآن الكريم، يقول ابن القيم رحمه الله: "ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر على معاني آياته".
ومن هذا المنطلق نقف هذه الوقفات مع سورة من قصار السور؛ ألا وهي: [سورة العاديات] ومع قلة عدد آياتها إلا أن فيها دروسًا وعبرًا لا تحصى!
• سورة العاديات: هي سورة مكية، وعدد آياتها إحدى عشرة آيةً، والغريب أنها تتحدَّث عن الجهاد!
اشتملت السورة على ثلاثة موضوعات؛ ولذلك يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
1- آيات القسم: مشهد الخيل وهي تجري في الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فقد صور الله تعالى هذا المشهد بأدق التفاصيل.
2- جواب القسم: وهو جحود الإنسان وحبه الشديد للدنيا.
3- خاتمة السورة: وعيد وتذكير ببعثرة القبور، وتحصيل ما في الصدور.
أولًا: آيات القسم الأول:
بدأت السورة بأسلوب قسم؛ فالواو من حروف القسم، والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته: المرسلات، الفجر، الضحى، الليل، الشمس؛ وفيها أطول قسم.
وهنا أقسم الله تعالى: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ [العاديات: 1]؛ أي: الجاريات من العَدْو والجري؛ فذكر الوصف ولم يذكر الموصوف، وأشهر التفاسير أنها: الخيل حين تعْدُو بسرعة، والضبح: هو صوت أنفاسها في صدرها عند اشتداد عدوها.
تعلمنا هذه الآية: المسارعة والمسابقة في أبواب الخير؛ تقول لك: تعلم من الخيل في عدوها في سبيل الله الجري والمسارعة في الطاعات وأبواب الخير؛ كما قال تعالى في آيات كثيرة: ﴿ وَسَارِعُوا ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿ سَابِقُوا ﴾ [الحديد: 21]، ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: 148].
قوله: ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾ [العاديات: 2]؛ أي: النار التي تخرج من أثر احتكاكهن بالحجارة خلال عدوها بسرعة؛ كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ [الواقعة: 71].
تعلمنا هذه الآية: القوة في كل شيء؛ ففيها دليل على قوة الخيل في الجري؛ لدرجة أن اصطكاك حافرها بالصخر يقدح شررًا، وفيه دليل على إقبال راكبها نحو العَدْو.
قوله: ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ [العاديات: 3]؛ أي: يغير أهلها على العدو في وقت الصباح، وهذا أمر أغلبي؛ أي غالبًا ما تكون الإغارة في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارةً على العدو أن يكون في الصباح؛ لأن العدو غالبًا يكون في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُغِير على قوم في الليل؛ بل ينتظر، فإذا أصبح؛ إن سمع أذانًا كفَّ وإلا أغار.
تعلمنا هذه الآية: المسارعة والإقدام والمداومة؛ حيت تشير الآية إلى أن الخيل تجري نحو العدو الليل كله باستمرار ومداومة.
وفيه أيضًا: البركة في البكور.
قوله: ﴿ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ [العاديات: 4]؛ أي: فهيجن من الإثارة الغبار بذلك العدو، أو المكان الذي حلت فيه.
تعلمنا هذه الآية: أن يكون لك أثر في كل مكان لخدمة هذا الدين العظيم.
وهذا الغبار له فضل عند الله تعالى، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسهما النار)) ((ولا يجتمع غبار في سبيل الله مع نار جهنم))؛ [رواه البخاري].
قوله: ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴾ [العاديات: 5]؛ أي: فتوسطن براكبهن جموع العدو، وتوسطته؛ بسبب الغبار الذي هيجته، وهذا دليل على أنهم مقدمون على الأعداء، ودليل على شجاعتهم؛ فلم يقفوا على الأطراف؛ ليكون سهلًا للفرار!
ثانيًا: آيات القسم الثاني:
بعد الكلام عن معالي الأمور، وذروة سنام الإسلام، وحال الخيل في أرض الجهاد، وبعد أن أقسم بالأشياء العظيمة لتأكيد هذا الأمر؛ وهو:
قوله: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ [العاديات: 6]؛ أي: لكفور جحود لنعم ربه عليه، وهو جواب القسم، وهذا الجواب: أكد بثلاثة مؤكدات: واو القسم، وإن، اللام.
عن الحسن البصري: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ قال: "هو الكفور الذي يعد المصائب، وينسى نعم ربه".
تعلمنا هذه الآية: لا تكن الخيل أفضل منك أيها الإنسان الجحود! وهذا يدعو الإنسان: أن يسأل نفسه: ما هي أحواله من نعم الله تعالى عليه؟
• ما هي صفات الإنسان الكنود؟
1- لا ينظر إلا للمفقود؛ وهذه من أخطر أسباب التعاسة والشقاء: أن ينظر إلى ما ينقصه ولا ينظر إلى ما يملكه! وصدق القائل عن أحوال الناس في هذا الزمان: "الفقر في قلوبهم، ولكن في أيديهم ما يكفيهم".
نعم الله تعالى ليست محصورة في المال؛ فقد تعطى المال وتحرم غيره؛ عن يونس بن عبيد رحمه الله: أن رجلًا شكا إليه ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبرجليك؟ قال: لا، قال: فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك مئين ألوف، وأنت تشكو الحاجة!".
تأمل معي أخي الحبيب، وسل نفسك هذه الأسئلة؛ لتعرف كثرة نعم الله عليك: ألست اليوم أنت تقوم وحدك؟ وتجلس وحدك؟ وتمشي وحدك؟ وتقضي حوائجك وحدك؟ وتشرب كوب الماء وحدك دون مساعدة أحد؟ وتنظر وتسمع وتتكلم؟ وتنام مرتاحًا ولا تشعر بألم؟ هذه والله نعم حرم منها الكثير من الناس اليوم.
2- ومن صفات الكنود: أنه لا ينظر إلا لما في أيدي الناس، والتوجيه القرآني: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: 131]، والتوجيه النبوي كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر ألَّا تزدروا نعمة الله عليكم)) وفي راوية: ((إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه))، قال عون بن عبدالله رحمه الله: "صحبت الأغنياء فلم أر أحدًا أكثر همًّا مني، أرى دابةً خيرًا من دابتي، وثوبًا خيرًا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت".
3- ومن صفات الكنود: ينسب النعم لغير المنعم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب)).
4- ومن صفات الكنود: عدم شكر النعم، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: 7].
قوله: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات: 7]؛ أي: وإن الإنسان على كنوده وجحوده يشهد على نفسه لظهور أثره عليه، وقيل: الضمير عائد على الله تعالى؛ لكن سياق الآيات يدل على أنه عائد على الإنسان الجحود.
يشهد على ذلك: بأقواله وأفعاله وما يخفيه في صدره؛ فهو كنود بلسانه: بكثرة التشكي وكثرة عبارات التسخط، وإعلان الحاجة والفلس دائمًا، وكنود بقلبة: بكثرة التسخط والاعتراض على قدر الله تعالى، وكنود بأفعاله: لا يظهر نعم الله عليه!
قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8]؛ أي: إن الإنسان لأجل حب المال لبخيل ممسك.
والخير: هو المال؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: 20]، وسمي المال خيرًا؛ لأنه يفعل به الخير، أو يظن الناس فيه الخير.
ومن شدة حب المال: ربما يظلم، ويعتدي، ويسرق، وغيرها من صور الكسب الحرام!
ومن شدة حب المال: يبخل به، ويبخس الناس حقوقهم!
ولماذا جحد الإنسان نعم ربه؟ لأنه غفل عن الآخرة؛ ولذلك جاءت آيات القسم الثالث: وعيدًا وتذكيرًا لهذا الكنود ببعثرة القبور، وتحصيل ما في الصدور.
ثالثًا: آيات القسم الثالث:
بعد أن ذكر أحوال المجاهدين، ثم الذين يجحدون ويبخلون، جاء التهديد لهذا الكنود: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ [العاديات: 9]؛ أي: هذا الإنسان إذا بعث من القبر للحساب والجزاء.
قوله: ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [العاديات: 10]؛ أي: واستخرج وأظهر ما في صدره من خير أو شر، فكما أن الأجساد أخرجت، فكذلك ما في الصدور.
تعلمنا هذه الآية: منزلة القلوب، وأهمية الاعتناء بها؛ كما قال: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ [الطارق: 9]؛ ففي الدنيا الأحكام على الظاهر، لكن في الآخرة المعاملة بما في القلوب.
قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ﴾ [العاديات: 11]؛ أي: عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليه؛ فهذا وعد ووعيد؛ وعد لمن آمن وعمل صالحًا، ووعيد لمن كفر بالله وجحد نعمه! إنسان يقدم ويبذل، والآخر يجحد ويبخل، والله تعالى خبير بهم، ويعلم أحوالهم.
نسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلِّ اللهم على نبينا محمد.
شبكة الالوكة -
ضيفٌ كريم:
أظلنا شهرٌ عظيم مبارك هو شهر الله المحرم أول شهور السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ.... ﴾ [التوبة:36].
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في قوله -تعالى-: ﴿ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾: "اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرامًا وعظّم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم".
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ))؛ [رواه البخاري].
وكانوا يسمون شهر المحرم شهر الله الأصم لشدة تحريمه. [الطائف: 83]. وقال أبو عثمان النهدي: "كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم". [الطائف: 84]. وقال قتادة: "إن الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السَنة"؛ [فتح القدير: 5/429].
صيام المحرم:
ومن فضائل شهر محرم: أنه يُستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر محرّم، ففي الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ))؛ [رواه مسلم]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((شهر الله)) من باب إضافة التعظيم، وأفضل أيامه اليوم العاشر، فقد صامه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر بصيامه، ففي الصحيحين وغيرهما عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى - شكرًا لله تعالى - قَالَ: فَنحن أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، ونحن نصومه تعظيمًا له، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ))؛ ورواه الإمام أحمد بزيادة غير صحيحة: ((وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرًا)).
نحن أحق بموسى منهم:
نعم إخوة الإيمان، نحن أحق بموسى منهم فهذه الأمة المباركة هي امتداد للأنبياء والصالحين، وكل نبي وكل صالح من الأمم السابقة، إنما هو تابع لهذه الأمة، ونحن أحق بكل نبي من قومه الذين كذبوه وعصوه، والأنبياء - عليهم السلام - امتدادًا لتاريخنا، والانتماء إلى الأنبياء ليس انتماء نسب أو بلد؛ إنما الانتماء للأنبياء يكون باتباع هديهم وتعاليمهم.
صيام عاشوراء يكفر سنة:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله))؛ [رواه مسلم].
فيا له من فضل عظيم لا يفوِّته إلا محروم، فصيام يوم واحد لا يتجاوز خمس عشرة ساعة يكفر الله به خطايا عام كامل، وهذا من رحمة الله - تعالى- بنا ولطفه، ولكن صيام عاشوراء ماذا يكفّر؟ قال أهل العلم: إنه يكفر الذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح وقبولها، كما أشار إلى ذلك العلماء المحققون كالنووي وابن تيمية - رحمهما الله .
هل يجوز إفراد عاشوراء بالصيام حتى وإن كان يوم جمعة أو سبت؟
يقول أهل العلم: لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى صيام يوم قبله أو يوم بعده، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية.
مخالفة اليهود والتميز:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع مع العاشر -يعني عاشوراء-))؛ [رواه مسلم]، وفي صحيح مسلم أيضًا؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((خالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده)).
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يريد لنا الرفعة عن مشابهة الكفار، ويريد لنا العزة، ويريد لنا التميز، فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! نحن أمة مرفوعة، فلم نكون خاضعين؟! نحن أمة متبوعة، فلم نكون تابعين؟! وديننا يأمرنا بالتميز في سلوكنا ومظاهرنا وفي عباداتنا، وأن تكون لنا -نحن المسلمون- الشخصية المتميزة المبنية على الشعور بالعزة الإيمانية.
صيام عاشوراء مراتب:
ذكر بعض الفقهاء أن صيام عاشوراء ثلاث مراتب:
1- صوم التاسع والعاشر والحادي عشر.
2- صوم التاسع والعاشر.
3- صوم العاشر وحده. [زاد المعاد: 2/76].
وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
يوم عاشوراء يوم النصر للحق وأهله:
في غمرة الشعور باليأس والإحباط الذي أصاب المسلمين اليوم من جراء تتابع النكبات والشدائد، يأتي يوم عاشوراء ليُذكِّر الأمة أنه لا تقف أمام قوة الله أي قوة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون.
شهر الله المحرم شهر نصرٍ وعز لنبي الله موسى – عليه الصلاة والسلام - وقومه على فرعون الطاغية المتجبر على رغم كثرة عددهم وعدتهم وخيلائهم، فإن الله -تعالى- يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وبإحياء ذكرى ذلك النصر المجيد، على ذلك الطاغية الكبير، نعلن أن الدعوات لا تهزم بالأذى والحرب والاضطهاد، وعاقبة الظلم وخيمة، والله ناصر دينه، وكتابه، وأوليائه، والعاقبة للمتقين والنصر حليفهم؛ متى ما تمسكوا بدينهم، واستنزلوا النصر من ربهم؛ قال -تعالى-: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: 126]، وقال -تعالى-:﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [غافر: 51- 52].
يوم عاشوراء: اليوم الذي قال فيه موسى لقومه لما قالوا له وهم يرون فرعون وجنوده خلفهم: (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) [الشعراء: 61]، قال موسى بلغة المؤمن الواثق من وعد الله: ﴿ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: 62]، إنه فضل وأهمية التوحيد والاستسلام في الملمات، وتفويض الأمر إلى الله وحده، فمهما حمل لنا العدو من دبابات وقاصفات ومدمرات، فإن الله معنا يسمع ويرى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ قال -تعالى-: ﴿ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ﴾ [مريم: 84].
يوم عاشوراء: اليوم الذي قال فيه فرعون المتجبر المتكبر المتألّه، لما أيقن بالهلاك: ﴿ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: 90]، فردّ الله عليه هذا الإيمان الاضطراري وهذه الدعوى الكاذبة، فقال - عز من قائل -: ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ [يونس: 91- 92].
يوم عاشوراء: حُق لكل مؤمن أن يعرف قدره ومقداره، وأن يتيقن فيه من سنة الله الكونية في نُصرة أوليائه الذين ينافحون عن دينه، ودحر أعدائه الذين يعارضون شرعه في كل زمان ومكان.
يوم عاشوراء: فيه رسالة أن الباطل مهما انتفخ وانتفش، وتجبر وتغطرس، وظن أنه لا يمكن لأحد أن ينازعه أو يرد كيده وباطله أو يهزم جنده وجحافله، فإن مصيره إلى الهلاك، وعاقبته هي الذلة والهوان، فهذا فرعون الطاغية بلغ به التكبر والغرور أن يدّعي الألوهية، وأن يعلن للناس بكل جرأة وصفاقة: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: 38]، وأن يقول بملء فيه من غير حياءٍ ولا خجل: ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ الأَعْلَى ﴾ [النازعات: 24]، ولكنه حين حل به العذاب لم يُغن عنه ملكه وسلطانه، ولا جنده وأعوانه، ولا تبجحه وادعاؤه، ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ [النازعات: 25- 26].
محرم والهجرة النبوية:
العاشر من محرم يُذَكِّرُنَا بِهِجرَةِ المُصطَفَى -صلى الله عليه وسلم- مِن مَكَّةَ إِلى المَدِينَةِ، وَبَدءِ ظُهُورِ الدَّعوَةِ الإِسلامِيَّةِ وَانتِصَارِ الإِسلامِ وَانتِشَارِه، وعلينا كمسلمين أن نشكر الله على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر في معرفة التاريخ اليومي الذي يبدأ من الهجرة (هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة) وأن علينا جميعًا أن نكون أمةً متميزة بتاريخها وأخلاقها، ورأيها ومعاملاتها عن سائر الأمم الكافرة.
استشهاد سيد شباب أهل الجنة:
من المفارقات العجيبة ما حصل في هذا اليوم المبارك أيضًا من قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعن أبيه وأمه وآل بيته، حيث قُتل في فتنة عظيمة بين فئتين من المسلمين، وهي فتنة طهّر الله منها أيدينا فلا نخوض فيها بألسنتنا.
إن كل مسلم ينبغي أن يحزنه مقتل الحسين أو حتى غير الحسين من عامة المسلمين، فكيف إذا كان من أهل الفضل والمكانة، وكيف إذا كان من قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه - رضي الله عنه - من سادات المسلمين، ومن علماء الصحابة وابن بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان عابدًا شجاعًا سخيًّا.
ما ينبغي التنبيه إليه:
ما ينبغي التنبيه إليه هو أن ما يفعله بعض الشيعة في هذا اليوم من البكاء والنواح على قتل الحسين - رضي الله عنه - وما يقومون به من تعذيب أنفسهم، وإسالة الدماء من وجوههم وصدورهم وظهورهم، والتقرب إلى الله بضرب أبدانهم بالسلاسل والسكاكين، ولطم خدودهم ونتف شعورهم ليس من الإسلام في شيء، وهو من البدع المحدثة والمنكرات الظاهرة ومن كبائر الذنوب التي تبرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مرتكبيها فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية))؛ [متفق عليه].
فكل عمل يدل على الجزع والتسخط وعدم الرضا بقدر الله، فإنه محرم.
تشويه صورة الإسلام وتنفير غير المسلمين:
يضاف إلى هذه الأعمال البدعية المؤذية للأبدان من: حماقة وسفاهة وتشويه لصورة الإسلام، وتنفير لغير المسلمين من الدخول فيه، وقد رأينا بعض وسائل الإعلام العالمية المعادية تحرص على نشر هذه الأعمال البدعية بالصوت والصورة، زاعمة بأن هذا هو الإسلام، فمن كان مشتاقًا إلى الضرب، فليدخل في هذا الدين على حد زعمهم.
من العجائب:
والعجيب من أمر الرافضة أن أبا الحسين - رضي الله عنهما - كان أفضل منه، وقُتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعين، ولا يتخذون مقتله مأتمًا، وكذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقد قُتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين، وقد ذُبح من الوريد إلى الوريد، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتمًا، وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قُتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتمًا، كما يفعل هؤلاء الجهلة يوم مصرع الحسين -رضي الله عنه.
اللهم زدنا إيمانًا بك، وتوكلاً عليك، واستعانةً بك، اللهم كما أنجيت موسى وقومه؛ فأنجِ المسلمين المستضعفين في كل مكان من فراعنة هذا الزمان، يا رحيم يا رحمن.
المصدر: موقع المختار الإسلامي
-
الكلمة الأكثر ذكرًا:
س 443: ما أكثر كلمة ذكرت في القرآن الكريم؟
ج 443: لفظ الجلالة الله وقد ذكر 2697 مرة.
المصحف الإمام:
س 444: ما المقصود بالمصحف الإمام؟
ج 444: هو مصحف سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- الذي جمعه ووزَّعه على الأمصار.
السور المسماة بأسماء صفات الملائكة:
س 445: ما هي السور المسماة بأسماء صفات الملائكة؟
ج 445: سورة الصافات، سورة المعارج، سورة النازعات.
السور المسماة بأسماء صفات القرآن الكريم:
س 446: ما هي السور المسماة بأسماء صفات القرآن الكريم؟
ج 446: سورة الفرقان، سورة فصلت.
السور المسماة بأسماء الأشياء:
س 447: ما هي السور المسماة بأسماء الأشياء؟
ج 447: سورة المائدة، سورة الحديد، سورة القلم، سورة الماعون، وسورة المسد.
السور المسماة بأسماء الرسل والأنبياء:
س 448: ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء الرسل والأنبياء؟
ج 448: سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة محمد، سورة نوح، سورة المزمل، سورة المدثر.
السور المسماة بأسماء يوم القيامة:
س 449: ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء يوم القيامة وأهوالها؟
ج 449: سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة الحشر، سورة التغابن، سورة الحاقة، سورة القيامة، سورة النبأ، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة الغاشية، سورة الزلزلة، وسورة القارعة.
السورتان المفتتحتان بكلمة "هل":
س 450: ما هما السورتان الكريمتان المفتتحتان بكلمة "هل"؟
ج 450: سورة الإنسان ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾، وسورة الغاشية ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾.
السور المفتتحة بكلمة "قل":
س 451: ما هي السور الكريمة المفتتحة بكلمة "قل"؟
ج 451: 1- سورة الجن ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾.
2- سورة الكافرون ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾.
3- سورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.
4- سورة الفلق ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾.
5- سورة الناس ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾.
السورتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما:
س 452: ما هما السورتان الكريمتان اللتان ورد اسمهما في آخر آية منهما؟
ج 452: 1- سورة الماعون ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: 7].
2- سورة المسد ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ [المسد: 5].
السور المسماة بأسماء الأزمنة:
س 453: ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء الأزمنة؟
ج 453: سورة الحج، والجمعة، والفجر، والليل، والضحى، والقدر، والعصر، والفلق.
السور المسماة بأسماء الحيوانات:
س 454: ما هي السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات؟
ج 454: سورة البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعلق، والعاديات، والفيل.
أثلاث القرآن:
س 455: ما هي أقسام القرآن الكريم أثلاثًا؟
ج 455: 1 - يعتبر ثلث القرآن الأول من الفاتحة إلى الآية 99 من سورة التوبة ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.
2- يعتبر ثلث القرآن الثاني من رأس الآية 100 من سورة التوبة إلى الآية 100 من سورة الشعراء ﴿ شافِعِينَ ﴾.
3- يعتبر ثلث القرآن الثالث من رأس الآية 101 من سورة الشعراء إلى سورة الناس، وهي آخر القرآن؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
أرباع القرآن:
س 456: ما هي أقسام القرآن أرباعًا؟
ج 456: 1- يعد الربع الأول من القرآن من أول الفاتحة وحتى آخر سورة الأنعام.
2- يعد الربع الثاني من القرآن من أول الأعراف وحتى ﴿ وَلْيَتَلَطَّفْ ﴾ من الكهف.
3- يعد الربع الثالث من القرآن من ﴿ وَلْيَتَلَطَّفْ ﴾ وحتى آخر سورة الزمر.
4- يعد الربع الرابع من القرآن من أول غافر وحتى آخر القرآن؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
السور التي لم يرد اسمها في أي آي من آياتها:
س 457: ما هي السور الكريمة التي لم يرد اسمها في أي آية من آياتها إطلاقًا؛ وإنما سميت بالمعنى الوارد فيها؟
ج 457: 1- الفاتحة: لأنها فاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بها.
2- الأنبياء: لورود قصص أغلب الأنبياء فيها.
3- الإخلاص: لما فيها من معنى الإخلاص بوحدانية الله تعالى؛ [دليل القرآن الكريم/ إصدار جامعة الإمام].
السور المبدوءة بكلمة "إنَّا":
س 458: ما هي السور القرآنية الكريمة المبدوءة بكلمة "إنَّا"؟
ج 458: 1- سورة الفتح ﴿ إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾.
2- سورة نوح ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحًا إِلى قَوْمِهِ ﴾.
3- سورة القدر ﴿ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾.
4- سورة الكوثر ﴿ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ﴾.
السور المبدوءة بكلمة "سَبَّحَ":
س 459: ما هي السور القرآنية الكريمة المبدوءة بكلمة "سَبَّحَ"؟
ج 459: 1- سورة الحديد ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.
2- سورة الحشر ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.
3 - سورة الصف ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. 4- سورة الأعلى ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾.
السورتان المبدوءتان بكلمة "يُسبِّح":
س 460: ما هما السورتان الكريمتان المبدوءتان بكلمة "يسبح"؟
ج 460: 1- سورة الجمعة ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.
2- وسورة التغابن ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.
السورتان المبدوءتان بكلمتي "لا أقسم":
س 461: ما هما السورتان الكريمتان المبدوءتان بكلمتي "لا أقسم"؟
ج 461: 1- سورة القيامة ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾.
2- سورة البلد ﴿ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ ﴾.
السور التي اتفقت في آية الافتتاح:
س 462: ما هي السور القرآنية الكريمة التي اتفقت في آية الافتتاح؟
ج 462: 1- سورة الشعراء والقصص: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿ طسم * تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾.
2- وسورتا الزخرف والدخان: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿ حم * وَالْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾.
3- وسورتا الجاثية والأحقاف: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿ حم * تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.
4- وسورتا الحشر والصف: افتتحتا بقوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.
الطواسين:
س 463: ما هي السور القرآنية الكريمة التي تُسمَّى الطواسين؟
ج 463: 1- سورة النمل ﴿ طس* تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ ﴾.
2- سورة الشعراء ﴿ طسم* تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾.
3- سورة القصص ﴿ طسم* تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾.
السورتان المبدوءتان بكلمة "تبارك":
س 464: ما هما السورتان القرآنيتان الكريمتان المبدوءتان بكلمة "تبارك"؟
ج 464: 1- سورة الفرقان ﴿ تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ ﴾.
2- سورة الملك ﴿ تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.
السور المفتتحة بحروف مقطعة:
س 465: ما عدد السور القرآنية الكريمة المفتتحة بحروف مقطعة؟
ج 465: تسع وعشرون سورة.
السور المفتتحة بالدعاء:
س 466: ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة بالدعاء؟
ج 466: 1- سورة المطففين ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾.
2- سورة الهُمَزة ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾.
3- سورة المسد ﴿ تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾.
السور المفتتحة باسم السورة:
س 467: ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة باسم السورة في أول كلمة منها؟
ج 467: 1- الحاقة ﴿ الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾.
2- ﴿ الْقارِعَةُ الْقارِعَةُ * مَا الْقارِعَةُ * وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ ﴾.
3- عبس ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى* أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى ﴾.
4- الرحمن ﴿ الرَّحْمنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ ﴾.
السورة المفتتحة بخمسة حروف:
س 468: ما هي السورة الوحيدة المفتتحة بخمسة حروف مقطعة؟
ج 468: سورة مريم.. وهي مفتتحة بـ ﴿ كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾.
السورتان المفتتحتان بكلمة "قد":
س 469: ما هما السورتان القرآنيتان الكريمتان المفتتحتان بكلمة "قد"؟
ج 469: 1- سورة المؤمنون ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.
2- سورة المجادلة ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ ﴾.
السورتان المفتتحتان بأربعة حروف:
س 470: ما هما السورتان القرآنيتان الكريمتان المفتتحتان بأربعة حروف؟
ج 470: 1- سورة الأعراف ﴿ المص* كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ ﴾.
2- سورة الرعد ﴿ المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾.
السور المفتتحة بحرفين:
س 471: ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة بحرفين؟
ج 471: 1- سورة غافر: ﴿ حم* تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾.
2- سورة فصلت ﴿ حم* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴾.
3- سورة الشورى ﴿ حم* عسق* كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.
4- سورة الزخرف ﴿ حم* وَالْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾.
5- سورة الدخان ﴿ حم* وَالْكِتابِ الْمُبِينِ ﴾.
6- سورة الجاثية ﴿ حم* تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.
7- سورة الأحقاف ﴿ حم* تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾.
8- سورة طه ﴿ طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ﴾.
9- سورة يس ﴿ يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾.
10- سورة النمل ﴿ طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ ﴾.
السور المفتتحة بـ "الم":
س 472: ما هي السور القرآنية الكريمة المفتتحة بـ "الم"؟
ج 472: سورة البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة.
السور المفتتحة بـ "الر":
س 473: ما هي السور القرآنية المفتتحة بـ "الر"؟
ج 473: سورة يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر.
السورتان المبدوءتان بكلمة "اقترب":
س 474: ما هما السورتان الكريمتان المبدوءتان بكلمة "اقترب"؟
ج 474:
1- سورة الأنبياء ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾.
2- سورة القمر ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾.
حاء بعد حاء:
س 475: ليس في القرآن الكريم حاء بعد حاء إلا في موضعين، فما هما؟
ج 475: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: 235]، وقوله تعالى: ﴿ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكهف: 60].
غين بعد غين بلا حاجز:
س 476: آية كريمة من آيات القرآن الكريم جاء فيها حرف غين بعد غين بلا حاجز في موضع واحد، فما هي الآية الكريمة؟
ج 476: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 85].
كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما:
س 477: ليس في كتاب الله تعالى كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين، فما هما؟
ج 477: قوله تعالى: ﴿ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: 200]، وقوله تعالى: ﴿ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر: 42].
آية فيها ستة عشر ميمًا:
س 478: آية كريمة من آيات القرآن الكريم فيها ستة عشر ميمًا، فما هي؟
ج 478: قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ ﴾ [هود: 48].
آية فيها ثلاثة وثلاثون ميمًا:
س 479: آية كريمة من آيات القرآن الكريم فيها ثلاثة وثلاثون ميمًا، فما هي؟
ج 479: قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ ﴾ [البقرة: 282]، وهي آية الدَّيْن، وهي أطول آية في القرآن الكريم.
عشر واوات:
س 480: سورة كريمة من سور القرآن الكريم مكونة من ثلاث آيات فيها عشر واوات، فما هي؟
ج 480: سورة العصر.
آيات أولها شين:
س 481: سئل الكسائي: كم آية في القرآن أولها شين؟ فأجاب: أربع آيات، فما هي؟
ج 481: قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضانَ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: 18]، وقوله تعالى: ﴿ شاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ﴾ [النحل: 121]، وقوله: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ﴾ [الشورى: 13].
آيتان آخرهما شين:
س 482: وسئل الكسائي: كم آية آخرها شين؟ فأجاب: اثنتان، فما هما؟
ج 482: قوله تعالى: ﴿ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: 5]، وقوله تعالى: ﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ﴾ [قريش: 1].
يتبع
-
(سورة الأنبياء)
﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠﴾] وتنكير (كتاباً) للتعظيم؛ إيماء إلى أنه جمع خصلتين عظيمتين: كونه كتاب هدى، وكونه آية ومعجزة للرسول ﷺ لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، أو مُدَانِيه. ابن عاشور:17/22.
﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠﴾] (ذكركم) أي: شرفكم، وفخركم، وارتفاعكم؛ إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم، وعظم أمركم. السعدي:519.
﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧﴾] لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله تعالى: (فاسألوا). القرطبي:14/179.
﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧﴾] وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيٌ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهيٌ له أن يتصدى لذلك. السعدي:519.
﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧﴾] لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم، والإجابة عما علموه. السعدي:519.
﴿ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧﴾] لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم، والإجابة عما علموه. السعدي:519.
﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣﴾] (لاهية قلوبهم): غافلة؛ يقول: ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون، غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه، ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم. الطبري:18/410.
﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١﴾] ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله، وطابت نفسه بالتوبة، ولم يركن إلى الدنيا، فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. القرطبي:14/171.
﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢٤﴾] وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات تبين لهم الحق من الباطل تبيناً واضحاً جلياً. السعدي:521.
﴿ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢٣﴾] لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. القرطبي:14/189.
﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢٢﴾] فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نفي كثرة الآلهة، ووجوب أن يكون الإله واحداً، والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره. ابن جزي:2/34.
﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢١﴾] ووصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين، وإظهار لأفن رأيهم، أي: جعلوا لأنفسهم آلهة من عالَم الأرض، أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة، أو خشب؛ تعريضاً بأن ما كان مثلَ ذلك لا يستحق أن يكون معبوداً. ابن عاشور:17/37.
﴿ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٩﴾] (ومن عنده) أي: من الملائكة، (لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون) أي: لا يملون، ولا يسأمونها؛ لشدة رغبتهم، وكمال محبتهم، وقوة أبدانهم. السعدي:520-521
﴿ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٨﴾] (ولكم الويل) يا معشر الكفار (مما تصفون) الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. البغوي:3/154.
﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٨﴾] وهذا عام في جميع المسائل الدينية؛ لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل، أو رد حق، إلا في أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يُذهِبُ ذلك القول الباطل، ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. السعدي:520.
﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣٥﴾] قال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك؛ لننظر كيف شكرهم فيما يحبون، وكيف صبرهم فيما يكرهون. الطبري:18/440.
﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣٥﴾] (ونبلوكم بالشر والخير) أي: نختبركم بالفقر والغنى، والصحة والمرض، وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر، والشكر على الخير، أو خلاف ذلك. ابن جزي:2/36.
﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣٥﴾] وهذه الآية تدل على بطلان قول من قال ببقاء الخضر، وأنه مُخَلَّد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية. السعدي:523.
﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣٤﴾] سببها أن الكفار طعنوا على النبي ﷺ بأنه بشر يموت، وقيل: إنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده. ابن جزي:2/36.
﴿ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢٩﴾] وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق -الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه- مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟! السعدي:522.
﴿ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢٧﴾] أي: لا يقولون قولاً مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم، وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. السعدي:522.
﴿ وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٢٦﴾] ولما كان اتخاذ الولد نقصاً في جانب واجب الوجود أعقب مقالتهم بكلمة (سبحانه) تنزيهاً له عن ذلك؛ فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد. ابن عاشور:17/50.
﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٤﴾] (بل متعنا هؤلاء) أي: متعناهم بالنعم، والعافية في الدنيا، فطغوا بذلك، ونسوا عقاب الله. ابن جزي:2/37.
﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٤﴾] أي: بسطنا لهم، ولآبائهم في نعيمها، وطال عليهم العمر في النعمة، فظنوا أنها لا تزول عنهم، فاغتروا، وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل. القرطبي:14/209.
﴿ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٢﴾] وقدم الليل؛ لأنه زمن المخاوف؛ لأن الظلام يُعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان، وحيوان، وعلل الأجسام. ابن عاشور:17/74.
﴿ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٢﴾] (قل من يكلؤكم) أي: يحرسكم ويحفظكم.. وتقديره: قل لا حافظ لكم (بالليل) إذا نمتم، وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم. القرطبي:14/207-208.
﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣٧﴾] واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: (خلق الإنسان من عجل) مع قوله (فلا تستعجلون) فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه، ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه؟! لأنه تكليف بمحال؛ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل، ولكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. الشنقيطي:4/152
﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٣٦﴾] والحكمة في ذكر العجلة ههنا: أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول- صلوات الله وسلامه عليه- وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل؛ لأنه تعالى يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته. ابن كثير:3/175.
﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۟ مُدْبِرِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٥٧﴾] أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان، بل كسر أصنامهم، فعل واثق بالله تعالى، موطِّن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. القرطبي:14/216-217.
﴿ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٥٠﴾] ووصف القرآن بالمبارك يعمّ نواحي الخير كلها؛ لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كلّه خير من جهة بلاغة ألفاظه، وحسنها، وسرعة حفظه، وسهولة تلاوته، وهو أيضاً خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام، والحكمة، والشريعة، واللطائف البلاغية... وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به مَن آمنوا به. ابن عاشور:17/90.
﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٨﴾] أي: يخشونه في حال غيبتهم، وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم، ويقومون بما ألزم. السعدي:525.
﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٨﴾] وخص المتقين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك علماً وعملاً. السعدي:525.
﴿ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٦﴾] فالمعنى: ولئن مسهم أقل شيء من العذاب (ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين) أي: متعدين؛ فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. القرطبي:14/211.
﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٥﴾] أي: الأصم لا يسمع صوتاً؛ لأن سمعه قد فسد، وتعطل، وشرط السماع مع الصوت: أن يوجد محل قابل لذلك؛ كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح، وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنْزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات. السعدي:524.
﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٤٥﴾] عن قتادة يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله؛ لا يسمعه، ولا ينتفع به، ولا يعقله، كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. الطبري: 18/450.
﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٢﴾] (ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة) أي: زيادة؛ لأنه دعا في إسحق، وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة؛ أي: زيادة على ما سأل؛ إذ قال: (ربِّ هب لي من الصالحين)، ويقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد. القرطبي:14/230.
﴿ وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧١﴾] هي الشام؛ خرج إليها من العراق. وبركتها بخصبها، وكثرة الأنبياء فيها. ابن جزي:2/40.
﴿ قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٦٩﴾] وعن أبي العالية: لو لم يقل الله: (وسلاما) لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل: (على إبراهيم) لكان بردها باقيا إلى الأبد. الشنقيطي:4/163.
﴿ قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٦٨﴾] لما دحضت حجتهم، وبان عجزهم، وظهر الحق، واندفع الباطل؛ عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا: (حرقوه وانصروا آلهتكم). ابن كثير:3/179.
﴿ ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٦٥﴾] (ثم نكسوا على رؤوسهم): استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، فقالوا: (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ابن جزي:2/39.
﴿ فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٦٣﴾] وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعترفون أنهم لا ينطقون، وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. ابن كثير:3/178.
﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٥٨﴾] وتأمل هذا الاحتراز العجيب: فإنَّ كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما كان النبي ﷺ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: «إلى عظيم الفرس»، «إلى عظيم الروم»، ونحو ذلك، ولم يقل: «إلى العظيم». وهنا قال تعالى: (إلا كبيرًا لهم)، ولم يقل: «كبيرًا من أصنامهم»، فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، إلا إذا أضيف إلى من عَظَّمَه. السعدي:526.
﴿ وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٠﴾] شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. الشنقيطي:4/234.
﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٩﴾] والظاهر أن قوله: (وَكُنا فَاعِلين) مؤكد لقوله: (وَسَخرنا مَعَ دَاوودَ الجِبالَ يُسَبِّحنَ وَالطّيرَ)، والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة. الشنقيطي:4/232.
﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٩﴾] وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً، وتسبيحاً، وتمجيداً. السعدي:528.
﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٨﴾] قال الحسن: لولا هذه الآية؛ لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده. القرطبي:14/237.
﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٨﴾] (فَفَهمناها سُليمانَ) أي: فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: (وَكُلاً) من داود وسليمان (آتينا حكماً وعلماً) وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب، وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. السعدي: 528.
﴿ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٣﴾] (وأوحينا إليهم فعل الخيرات): وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد، (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين، وفضلهما، ولأن من كمَّلهما كما أُمِرَ كان قائماً بدينه، ومن ضَيَّعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه تعالى، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه. السعدي:527.
﴿ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٧٣﴾] وهذا من أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إماماً يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون. السعدي:527.
﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٩﴾] (وأصلحنا له زوجه): بعدما كانت عاقراً؛ لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل؛ لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركاً بين الوالدين. السعدي:530.
﴿ وَكَذَٰلِكَ نُۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٨﴾] أي: إذا كانوا في الشدائد، ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. ابن كثير:3/187.
﴿ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٧﴾] أقر لله تعالى بكمال الألوهية: (لا إله إلا أنت)، ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة: (سبحانك)، واعترف بظلم نفسه وجنايته: (إني كنت من الظالمين). السعدي:529.
﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٧﴾] (فنادى في الظلمات):وهي ظلمة الليل، والبحر، وبطن الحوت. ابن جزي:2/43.
﴿ وَأَدْخَلْنَٰهُ مْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٦﴾] وصفهم أيضاً بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة الله، ومحبته، والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطباً من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكَفِّها عن المعاصي. السعدي:529.
﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٤﴾] ابتليناه ليعظم ثوابه غدا، (وَذِكْرىَ لِلعَابِدينَ) أي: وتذكيرا للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب، وصبره عليه، ومحنته له -وهو أفضل أهل زمانه- وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا، نحو ما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر. القرطبي:14/263.
﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٨٣﴾] (وَذِكْرىَ لِلعَابِدينَ)أي: وجعلناه في ذلك قدوة؛ لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء. ابن كثير:3/185.
﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩٨﴾] والحكمة في دخول الأصنام النار -وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب- بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد عذابهم. السعدي:531.
﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩٨﴾] وإنما يخرج من هذا من عُبد مع كراهته لأن يُعبد ويطاع في معصية الله؛ فهم الذين سبقت لهم الحسنى؛ كالمسيح،والعزير ، وغيرهما، فأولئك (مبعدون). ابن تيمية:4/393.
﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩٧﴾] ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع، والأهوال المزعجة، والقلاقل المفظعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور، والندم والحسرة على ما فات. السعدي:531.
﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩٢﴾] ومعنى كونها واحدة: أنها توحّد الله تعالى؛ فليس دونه إله، وهذا حال شرائع التوحيد، وبخلافها أديان الشرك؛ فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان؛ لأن لكل صنم عبادة وأتباعاً، وإن كان يجمعها وصف الشرك. ابن عاشور:17/141.
﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩٢﴾] أي: هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة، واجتمعتم على التوحيد، فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق. القرطبي:14/283.
﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩٢﴾] أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم، وأئمتكم الذين بهم تأتمون، وبهديهم تقتدون؛ كلهم على دين واحد، وصراط واحد، والرب أيضاً واحد، ولهذا قال: (وأنا ربكم). السعدي:530.
﴿ وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿٩١﴾] هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى -عليهما السلام- مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى -عليهما السلام- فيذكر أولاً قصة زكريا، ثم يتبعها قصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه؛ فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها، ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب؛ فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر، هكذا وقع في سورة آل عمران، وفي سورة مريم، وههنا. ابن كثير:3/189.
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٧﴾] عن ابن عباس في قوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبل. الطبري:18/552.
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٧﴾] إن قيل: رحمة للعالمين عموم، والكفار لم يرحموا به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا؛ فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم، والآخر: أنهم رحموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدّمون من الطوفان، والصيحة، وشبه ذلك. ابن جزي:2/46.
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٧﴾] والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد ﷺ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة. ابن جزي:2/46.
﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٥﴾] قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين، وإعزاز المسلمين. البغوي:3/196.
﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٥﴾] الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل: الأرض المقدسة، وقيل: أرض الجنة، والأول أظهر. والعباد الصالحون: أمّة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ففي الآية ثناء عليهم، وإخبار بظهور غيب مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. ابن جزي:2/46.
﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٤﴾] روى مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم تُحشرون إلى الله حُفاة عراة غُرْلاً: (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين)». ابن عاشور:17/161.
﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ [سورة الأنبياء آية:﴿١٠٣﴾] والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث... وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار، وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها، وذبح الموت بين الجنة والنار. القرطبي:14/295.
-
سورة طه
﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿٩﴾] وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عما لقي في تبليغه من المشقات وكفر الناس؛ فإنما هي له على جهة التمثيل في أمره. ابن عطية:4/38.
﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [سورة طه آية:﴿٧﴾] عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: السر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدّث به نفسك؛ لأنك تعلم ما تسر به اليوم، ولا تعلم ما تسر به غدا، واللّه يعلم ما أسررت اليوم، وما تسر به غدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى: ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. البغوي:3/113.
﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٣﴾] والتذكرة: خطور المنسي بالذهن؛ فإن التوحيد مستقرّ في الفطرة والإشراك مناف لها، فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في الفطرة، أو تذكير لملّة إبراهيم عليه السلام. ابن عاشور:16/185.
﴿ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿٢﴾] والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب، فتمتثل أمر الله، وتجتنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها. الشنقيطي:4/5.
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٩٦﴾] أي: القرآن؛ يعني: بيناه بلسانك العربي، وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمله. القرطبي:13/528.
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٩٦﴾] يجعل لهم وداً: أي: محبة ووداداً في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ودٌ تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات، والدعوات، والإرشاد، والقبول، والإمامة ما حصل. السعدي:501.
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٩٦﴾] قال مجاهد: يحبهم الله، ويحببهم إلى عباده المؤمنين... قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله- عز وجل- إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم. البغوي:3/110.
﴿ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٢٧﴾] وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه... وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العِيُّ، ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ابن كثير:3/143.
﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٢٥﴾] سأل اللّه أن يوسع قلبه للحق؛ حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرّته إلا بإذن اللّه، وإذا علم ذلك لم يخف فرعون مع شدة شوكته وكثرة جنوده. البغوي:3/119.
﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٢٥﴾] أي: وسِّعه وأفسِحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. السعدي:504.
﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٢٤﴾] ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر، وسأل الله الإعانة عليه بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه، وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. ابن عاشور:16/210.
﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٧﴾] إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية؛ فمعنى السؤال: تقرير أنها عصا، فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها، وبعد أن قلبها. ابن جزي:2/17.
﴿ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٤﴾] قيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بها. ابن جزي:2/16.
﴿ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٤﴾] (فاعبدني): بجميع أنواع العبادة: ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر -وإن كانت داخلة في العبادة- لفضلها وشرفها، وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. السعدي:503.
﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٥٠﴾] قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه، وهداه لما يصلحه. البغوي:3/124.
﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٤٩﴾] وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله: (فمن ربكما) إعراضاً عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما؛ لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه، فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربّه، أو أنه اعترف بأنّ له ربّاً. ابن عاشور:16/232.
﴿ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٤٤﴾] إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء، لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى، فإذا لم ينفع اللين مع المدعوّ، وأعرض واستكبر؛ جاز في موعظته الإغلاظ معه. ابن عاشور:16/225.
﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٤٣﴾] قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: «هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول: أنت الإله؟!». القرطبي:14/66.
﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٤٢﴾] يقول: ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما؛ فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما، ويثبت أقدامكما؛ لأنكما إذا ذكرتماني ذكرتما منِّي عليكما نعما جمة، ومننا لا تحصى كثرة. الطبري:18/312.
﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٤١﴾] إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده، ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه، واصطفاه من خلقه؟! السعدي:506.
﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿٣٩﴾] قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أحبه الله، وحببه إلى خلقه»، وقال ابن زيد: «جعلت من رآك أحبك، حتى أحبك فرعون، فسلمت من شره، وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك». القرطبي:14/58.
﴿ فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ ﴾ [سورة طه آية:﴿٦٤﴾] ليكون أمكن لعملكم، وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. السعدي:508.
﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٦٠﴾] ومعنى جمع الكيد: تدبير أسلوب مناظرة موسى، وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليه، وإقناع الحاضرين بأنّ موسى ليس على شيء. وهذا أسلوب قديم في المناظرات؛ أن يسعى المناظر جهده للتشهير ببطلان حجّة خصمه بكلّ وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير، ومبادأته بما يفتّ في عضده، ويشوش رأيه؛ حتّى يذهب منه تدبيره. ابن عاشور:16/247.
﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴾ [سورة طه آية:﴿٥٩﴾] وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله، وظهور دينه، وكبت الكافر، وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد، وفي المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. القرطبي:14/86.
﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٥٧﴾] زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى أوطانها، ويصعب الخروج منها ومفارقتها. السعدي:508.
﴿ كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٥٤﴾] وخص الله أولي النهى بذلك؛ لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة، والأنعام السائمة؛ لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسامهم معرضة. السعدي:507.
﴿ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٥٤﴾] (لآيات لأولي النهى): لذوي العقول؛ واحدتها نهية؛ سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. البغوي:3/126.
﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٥٣﴾] (الذي جعل لكم الأرض مهداً) أي: فراشاً، وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها؛ لا على وجه الحقيقة، ولا على وجه المجاز، ولو قال له: هو القادر، أو الرازق، وشبه ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالطه، ويدعي ذلك لنفسه. ابن جزي:2/20.
﴿ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٧٤﴾] فلا ينتفع بحياته، ولا يستريح بموته، وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته، كما أخبر الله تعالى عنه، فلا يموت بفراقها، ولا يحيا باستقرارها. القرطبي:14/107.
﴿ قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴾ [سورة طه آية:﴿٧٢﴾] وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. السعدي:509.
﴿ قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴾ [سورة طه آية:﴿٧٢﴾] أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه؛ إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين، وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة؛ فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته. ابن عاشور:16/266.
﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنّ َ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنّ َكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٧١﴾] ولما رأى فرعون إيمان السحرة تغيّظ ورام عقابهم، ولكنه علم أنّ العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول المناظرة، فاختلق -للتشفّي من الذين آمنوا- علّة إعلانهم الإيمان قبل استئذانِ فرعون، فعدّ ذلك جرأة عليه. ابن عاشور:16/263.
﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ ﴾ [سورة طه آية:﴿٦٩﴾] يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: (حيث أتى)، وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه؛ وهو الكافر. الشنقيطي:4/39.
﴿ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٦٧﴾] كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. السعدي:508.
﴿ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٦٥﴾] خيروه، موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت. السعدي:508.
﴿ قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٧﴾] وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة القبط؛ فألقوها عنهم، وعبدوا العجل؛ فتورعوا عن الحقير، وفعلوا الأمر الكبير. الشنقيطي:4/87.
﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٦﴾] أي: بعد ما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم؛ هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم، وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم، وهذا شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله. ابن كثير:3/157.
﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٤﴾] أي: عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه؛ لترضى عني. القرطبي:14/117.
﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٣﴾] موسى- عليه السلام- لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله، وطلباً لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامريّ حينئذ بعبادة العجل. ابن جزي:2/23.
﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٢﴾] الأسباب [أسباب المغفرة] كلها منحصرة في هذه الأشياء: فإن التوبة تجُبُّ ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها: من تعلم علم، وتدبر آية أو حديث؛ حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد، وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب، محصلات لغاية المطلوب. السعدي:511.
﴿ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٨١﴾] قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تظلموا، وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين، وقيل: لا تنفقوا في معصيتي، وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصيَّ. البغوي:3/134.
﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿٧٧﴾] اقتصر على وعده دون بقية قومه لأنه قدوتهم، فإذا لم يخف هو تشجعوا وقوي يقينهم. ابن عاشور:16/270.
﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّ هُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٧﴾] ففعل موسى ذلك، فلو كان إلهاً لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أُشْرِبَ العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى- عليه السلام- إتلافه -وهم ينظرون- على وجه لا تمكن إعادته، بالإحراق والسحق، وذريه في اليم، ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه، كما زال شخصه. السعدي:512.
﴿ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٧﴾] هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، وألا يخَالطوا، وقد فعل النبي- صلى الله عليه وسلم- ذلك بكعب بن مالك، والثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. القرطبي:14/130.﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٤﴾] هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) الآية [الأنعام: 90]. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أُمِر نبيُّنا ﷺ بالاقتداء بهم، وأمره ﷺ بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. الشنقيطي:4/92.
﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٤﴾] ترقق له بذكر الأم، مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. ابن كثير:3/159.
﴿ قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٢﴾] هذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم- لاسيما إذا كان راضيا- حكمه كحكمهم. القرطبي:14/124.
﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٩﴾] لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل؛ لأنهم يَدْعُونه، ويُثنون عليه، ويمجدونه، وهو ساكت، لا يشكر لهم، ولا يَعِدهم باستجابة، وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقّى طِلبة أن يجيب. ابن عاشور:16/288.
﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [سورة طه آية:﴿٨٩﴾] وقدم الضرّ على النفع قطعاً لعُذرهم في اعتقاد إلهيته؛ لأن عذر الخائف من الضرّ أقوى من عذر الراغب في النفع. ابن عاشور:16/289.
﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٣﴾] وهذا وصف يفيد المدح؛ لأنّ اللغة العربية أبلغ اللّغات، وأحسنها فصاحة وانسجاماً. ابن عاشور:16/314.
﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٢﴾] لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. القرطبي:14/143.
﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١١١﴾] وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه. القرطبي:14/142.
﴿ يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١٠٣﴾] والمقصود من هذا: الندم العظيم؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة، وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم، والدعاء بالويل والثبور. السعدي:513.
﴿ يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١٠٣﴾] أي: يقول بعضهم لبعض في السرّ: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال؛ وذلك لاستقلالهم مدّة الدنيا. وقيل: يعنون لبثهم في القبور. (يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) أي: يقول أعلمهم بالأمور؛ فالإضافة إليهم. (إن لبثتم إلا يوماً): واحداً؛ فاستقل المدّة أشد مما استقلها غيره. ابن جزي:2/24.
﴿ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٩﴾] وهو هذا القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء. السعدي:512.
﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [سورة طه آية:﴿٩٩﴾] ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطْع حصة الزمان، ولا إيناس السامعين بالحديث، إنما المقصود منه العبرة، والتذكرة، وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة. ابن عاشور:16/302.
﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٢٣﴾] قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة»، وتلا الآية. القرطبي 14/156.
﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٨﴾] في قوله: (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى)، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله:وقد قُرن بين انتفاء الجوع واللباس (وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) لمناسبة بين الجوع والعَرى في أن الجوع خلوّ باطن الجسم عما يقيه تألمه؛ وذلك هو الطعام، وأن العري خلوّ ظاهر الجسم عما يقيه تألمه، وهو لفح الحر، وقرص البرد. ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن، والثاني ألم حرارة الظاهر. ابن عاشور:16/322.
﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٤﴾] كان ابن مسعود- رضي الله عنه- إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علماً وإيماناً ويقيناً. البغوي:3/142.
﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٤﴾] ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنَّى ويصبر حتى يفرغ المعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام مُلْقِي العلم؛ فإنه سبب للحرمان. السعدي:514.
﴿ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٤﴾] وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن مُلك غيره من الـمُتَسَمِّين بالملوك لا يخلو من نقص. ابن عاشور:16/315.
﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١١٤﴾] لما كانت عجلته- صلى الله عليه وسلم- على تَلَقُّف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم، وحرصه عليه؛ أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم. السعدي: 514.
﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [سورة طه آية:﴿١٢٤﴾] فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق، وحيرة، وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة.
﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٣٢﴾] أي: لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم، وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة. القرطبي:14/165.
﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٣٢﴾] (لا نسألك رزقاً) أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك؛ فتفرغ أنت وأهلك للصلاة، فنحن نرزقك، وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا؛ بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية. ابن جزي:2/29.
﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [سورة طه آية:﴿١٣٢﴾] والأمر بالشيء أمرٌ بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمراً بتعليمهم ما يصلح الصلاة، ويفسدها، ويكملها... فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. السعدي:517.
﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٣١﴾] وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحاً إلى زينة الدنيا، وإقبالاً عليها، أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. السعدي:517.
﴿ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٢٦﴾] وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة، والإعراض عما متع الله الكفّار برفاهية العيش، ووعده بأن العاقبة للمتقين. ابن عاشور:16/337.
﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٢٧﴾] لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. السعدي:516.
﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ [سورة طه آية:﴿١٢٦﴾] النسيان في هذه الآية بمعنى: الترك. ولا مدخل للذهول في هذا الموضع، و(تُنسى) بمعنى: تترك في العذاب. ابن عطية:4/69.
-
سورة مريم
﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨﴾] تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته؛ فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة. وقيل: سأله وهو في سِنّ من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. ابن جزي:2/4.
﴿ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٧﴾] فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: أحدها: إجابة دعائه، وهي كرامة. الثاني: إعطاؤه الولد؛ وهو قوة، الثالث: أن يفرد بتسميته. القرطبي:13/417.
﴿ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ [سورة مريم آية:﴿١﴾] وجه خوفه: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً، فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حَدُّهُ. ابن كثير:3/109.
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤﴾] قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: (وهن العظم مني) إظهار للخضوع، وقوله: (ولم أكن بدعائك رب شقياً) إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي: لم أكن بدعائي إياك شقيا؛ أي: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي: إنك عودتني الإجابة فيما مضى. القرطبي:13/409.
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤﴾] توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته. السعدي:489.
﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣﴾] (إذ نادى ربه) يعني: دعاه. (نداءً خفياً): أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. ابن جزي:2/3.
﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٢﴾] وصفه بالعبودية تشريفاً له، وإعلاماً له بتخصيصه وتقريبه. ابن جزي:2/3.
﴿ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٢٥﴾] وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب؛ قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى، قاله الربيع بن خثيم وغيره. الشنقيطي:3/399.
﴿ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٢٥﴾] استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة. ابن كثير:3/164.
﴿ وَلِنَجْعَلَهُۥ ٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٢١﴾] تدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله؛ فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مُقَدِّرها ومسببها. السعدي:491.
﴿ قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿١٨﴾] وذكرها صفة (الرحمن) دون غيرها من صفات الله لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعراً عليها. ابن عاشور:16/81.
﴿ قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿١٨﴾] تذكير له بالله؛ وهذا هو المشروع في الدفع: أن يكون بالأسهل فالأسهل؛ فخوفته أولاً بالله عز جل. ابن كثير:3/113.
﴿ وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿١٥﴾] قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد؛ فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه، ويوم يموت؛ فيرى قوماً لم يكن عاينهم، ويوم يبعث؛ فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا، فخصه بالسلام عليه. ابن كثير:3/111.
﴿ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿١٤﴾] يقول تعالى ذكره: وكان برا بوالديه، مسارعا في طاعتهما ومحبتهما، غير عاق بهما، (ولم يكن جباراً عصياً): يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا، متذللا؛ يأتمر لما أمر به، وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه، ولا والديه. الطبري:18/160.
﴿ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣٣﴾] وذكر المواطن التي خصها؛ لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. ابن عطية:4/15.
﴿ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣٢﴾] وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه لأن برّ الوالدين كان ضعيفاً في بني إسرائيل يومئذ، وبخاصة الوالدة؛ لأنها تستضعف؛ لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البرّ بها. ابن عاشور:16/100.
﴿ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣١﴾] أي: نفّاعا حيث ما توجهت، وقال مجاهد: معلما للخير، وقال عطاء: أدعو إلى اللّه، وإلى توحيده وعبادته. البغوي:3/85.
﴿ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣٠﴾] فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاً، أو ابناً للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله. السعدي:492.
﴿ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣٠﴾] ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده: أنه عبد الله؛ وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله، أو ابنه، أو إله معه. الشنقيطي:3/416.
﴿ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٢٧﴾] أتت بعيسى قومها تحمله؛ وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها. السعدي:492.
﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٢٦﴾] وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج، ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمراً من جنسه؛ وهو كلام عيسى في حال صغره جداً. السعدي:492.
﴿ وَأَعْتَزِلُكُم ْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤٨﴾] وهذه وظيفة من أَيِسَ مِمَّن دعاهم... أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله. السعدي:495.
﴿ قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤٧﴾] أجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه، بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: (سلام عليك). السعدي:495.
﴿ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤٤﴾] وذكر وصف: (عصيًّا) الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان، مع زيادة فعل (كان) للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه، وأنه متمكن منه. ابن عاشور:16/117.
﴿ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤٣﴾] وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى؛ فإنه لم يقل: «يا أبت أنا عالم وأنت جاهل»، أو «ليس عندك من العلم شيء»، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علماً، وأن الذي وصل إليَّ لم يصل إليك ولم يأتك. السعدي:494.
﴿ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤٢﴾] فتدرج الخليل- عليه السلام- بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل؛ فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون ولياً للشيطان. السعدي:495.
﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٤٠﴾] الصديق: الكثير الصدق القائم عليه، وقيل: من صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق بالبعث، وقام بالأوامر فعمل بها؛ فهو الصديق. البغوي:3/88.
﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٣٩﴾] الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه، والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي: أنذر الناس يوم القيامة، وقيل له يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. الشنقيطي:3/422.
﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٦٢﴾] (بكرة وعشيا) أي: في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيا... وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا. القرطبي:13/479.
﴿ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٦١﴾] أضافها إلى اسمه (الرحمن) لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وأيضاً ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية بقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. السعدي:497.
﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٥٩﴾] وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين، وقوامه، وخير أعمال العباد. ابن كثير:3/125.
﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٥٩﴾] سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. ابن تيمية:4/285.
﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٥٨﴾] وفي إضافة الآيات إلى اسمه (الرحمن) دلالة على أن آياته من رحمته بعباده، وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة. السعدي:496.
﴿ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ ﴾ [سورة مريم آية:﴿٥٤﴾] فكمَّل نفسه، وكمَّل غيره، وخصوصاً أخص الناس عنده، وهم أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. السعدي:496.
﴿ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٥٤﴾] قال مجاهد: لم يعد شيئاً إلا وفَّّى به، وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد؛ حتى رجع إليه الرجل. البغوي:3/91.
﴿ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٧٦﴾] (والباقيات الصالحات): الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها. البغوي:3/105.
﴿ قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٧٥﴾] فمعيار التفرقة بين النّعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال. [ابن عاشور:16/155].
﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٧٤﴾] الأثاث: المال من اللباس ونحوه، والرئي: المنظر، فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا، وأحسن أثاثا وأموالا؛ ليبين أن ذلك لا ينفع عنده، ولا يعبأ به. ابن تيمية:4/292.
﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٧٣﴾] (خير مقاماً) أي: في الدنيا من: كثرة الأموال، والأولاد، وتوفر الشهوات... وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. السعدي:499.
﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٧١﴾] كان عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: (وإن منكم إلا واردها) فلا أدري أنجو منها، أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أُخبِرنا أَنَّا واردوها، ولم نُخْبَر أَنَّا صادرون عنها. ابن كثير:3/129.
﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٦٩﴾] (أيهم أشد على الرحمن عتيا): عتواً؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: فجورا؛ يريد: الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر؛ يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر. البغوي:3/99
﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُ مْ وَٱلشَّيَٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٦٨﴾] وعطف (الشياطين) على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة. ابن عاشور:16/147.
﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٩٠﴾] قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق، إلا الثقلين. ابن كثير:3/135.
﴿ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدً ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨٧﴾] وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهداً لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. السعدي:501.
﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨٦﴾] يساقون إلى جهنم ورداً؛ أي: عطاشاً، وهذا أبشع ما يكون من الحالات؛ سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة -وهو جهنم- في حال ظمَئِهم ونصبهم. السعدي:500.
﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨٥﴾] الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم؛ فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه. السعدي:500.
﴿ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨١﴾] ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. ابن تيمية:4/292.
﴿ وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨٠﴾] ومعنى إرث أولاده: أنهم يصيرون مسلمين، فيدخلون في حزب الله؛ فإن العاص وَلدَ عمَرْاً الصحابي الجليل، وهشاماً الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي ﷺ، ونكاية وكمد للعاص بن وائل. ابن عاشور:16/163.
﴿ وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ [سورة مريم آية:﴿٨٠﴾] أي: نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد، وقال ابن عباس-رضي الله عنهما- وغيره: «أي: نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه». وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد، ونجعله لغيره من المسلمين. (ويأتينا فرداً) أي: منفردا لا مال له، ولا ولد، ولا عشيرة تنصره. القرطبي:13/509. -
قال تعالى:﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم:71].
الحديث في هذه الآية عن جهنم، حيث يجعل ورودها لجميع الناس. فما من إنسانٍ إلا سيرد جهنم، مسلماً كان أو كافراً.
وقد فهم بعض الناس أن الورود في الآية معناه الدخول في جهنم. فقالوا: ما من إنسان – مسلماً كان أو كافراً – إلا سيدخله الله جهنم ويعذبه فيها. وينتقل هؤلاء من هذا الفهم المغلوط لمعنى الورود ولمعنى الآية، إلى تشكيك الصالحين بجدوى وفائدة وثمرة صلاحهم وعبادتهم وطاعتهم، ويزعمون لهم أنها لا تنفعهم يوم القيامة، بل يكونون معهم في نار جهنم. فالكل معذّب، صالحٌ وطالح،مطيعٌ ومذنبٌ، فلماذا يُتعبون أنفسهم في الدنيا بالعبادة والمجاهدة والتقوى؟، ولماذا لا يكونون مثل العصاة والمذنبين طالما سيكونون معهم في نفس المصير؟.
إن هذا فهمٌ مغلوطٌ، وتحريفٌ لمعناها، ودليل الجهل والمرذول الذي وقع به هؤلاء: قول الله: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا71/ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: 71- 72].
فعند قراءة الآية الثانية – التي تقرر معنى الآية الأولى، وتبيِّن المراد منها – نعلم أن المتَّقين ناجون، وأنهم غير معذبين، وغير داخلين في جهنم. بل المعذَّبون هم الظالمون الذين يتركهم الله في جهنم «جِثِيًّا».
هذا أمرٌ. وأمرٌ آخر: إن الورود ليس معناه دخول جهنم، بل معناه المرور عليها. المرور على الصِّراط المستقيم الذي يُنصب على شفيرها. فيجتاز المسلمون الناجون هذا الصّراط إلى جنَّة الله، بينما يمرّ عليه الكافرون والعصاة فيهوون عنه إلى جهنم – والعياذ بالله -.
روى مسلم في صحيحه عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول عند حفصة: لا يدخل النار – إن شاء الله – من أصحاب الشجرة أحد – الذين بايعوا تحتها – قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾.
وروى الترمذي عن السدي قال: سألتُ مُرَّةَ الهمداني عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، فحدَّثني أن عبد الله بن مسعود حدّثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَرِدُ الناس، ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحُضْر الفَرَس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشَدِّ الرجُل، ثم كمشيه».
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - «ثم يُضْرب الجسر على جهنم. وتحِل الشفاعة. ويقولون: اللهم سلِّم، سلِّم. قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: دَحْضٌ مُزِلّة، فيه خطاطيف وكلاليبٌ وحَسَك، تكون بنجدٍ فيها شُوَيْكة، يقال لها «السَّعْدان» غير أنه لا يعلم ما قدْر عِظَمِها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبَق بعمله، ومنهم المُجازَى حتى ينجو. فيمرّ المؤمنون كطَرْف العين، وكالبرق، وكالريح وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب.فناجٍ مُسَلَّم، ومخدوشٌ مرسل، ومكدوسٌ في نار جهنم».
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث، والأقسام الثلاثة هنا: (إنهم ثلاثة أقسام: قسم يَسْلم فلا يناله شيء أصلاً. وقسم يُخدش ثم يُرسل فيُخلص، وقسم يُكردس ويُلقى فيسقط في نار جهنم).
وقال الإمام النووي في موضعٍ آخر، من شرحه على صحيح الإمام مسلم:
(اعلم أن مذهب أهل السنّة، وما عليه أهل الحق من السلف والخلف، أن من مات موحداً، دخل الجنة قطعاً على كل حال.
فإن كان سالماً من المعاصي، كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبةً صحيحةً من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يُحدث معصية بعد توبته، والموفّق الذي لم يُبتل بمعصيةٍ أصلاً.
فكل هذا الصنف يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أصلاً. لكنهم يَردونها على الخلاف المعروف في الورود.
والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوبٌ على ظهر جهنم، أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه).
الكلم الطيب
-
قال تعالى:
﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًارَّحِيمًا﴾.
تقرر هذه الآية استحالة العدل بين الزوجات- لمن تزوج بأكثر من واحدة- ولو حرص الرجل على ذلك.
لكن ما هو هذا العدل المنفي والمستحيل؟ هل هو العدل الظاهري الخارجي، في المعاملة بين الزوجات والعشرة معهن؟ أم هو العدل القلبي في المودة والمحبة؟
وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل، وقبل أن نقدم المعنى الصائب للآية، نشير إلى تحريف بعض الناس لمفهومها:
هناك أعداءٌ لهذا الدين، وهناك سذجٌ من المسلمين، يرددون شبهات الأعداء. ويثير الفريقان كثيراً من الإشكالات والشبهات ضد هذا الدين، وأحكامه وقيمه ومبادئه.
ونالت شبهاتُهم- فيما نالت- مبدأ تعدد الزوجات الذي أباحه الله للمسلمين، بنص القرآن وتطبيق الصحابة له. ويحارب أعداء الدين والسذج من المسلمين، هذا الحكم الرباني والرخصة الإسلامية، وحتى يموهوا على المسلمين بهذا الخبث، يقولون: إن القرآن نفسه يبين استحالة العدل بين الزوجات، وهذا العدل المستحيل- في زعمهم- هو العدل الظاهري المادي الخارجي في العِشرة والنفقة، وطالما أنه مستحيل، فلا يجوز تعدد الزوجات بناءً على حكم هذه الآية؟؟
وهذا ضلالٌ عريض، وتحريفٌ خبيث، وخطأٌ واضح. فالقرآن أباح التعدد بقوله: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾.
أباح الله للمسلمين تعدد الزوجات- ولم يوجبه عليهم- واشترط العدل بين الزوجات. والعدل المشروط الواجب التطبيق، هو العدل الخارجي المادي، بحيث يعدل الرجل بين زوجاته، في المعاشرة والقسمة والنفقة والمعاملة والحياة المادية.
أما الآية الثانية التي تنفي العدل بين الزوجات، فإنها تنفي العدل القلبي، والميل القلبي، وتبين أنه يستحيل تحقيقه، فلا بد أن يكون لإحدى الزوجات في قلب زوجها من المحبة ما ليس للأخريات، وأن يميل لها قلبياً أكثر من ميله للأخريات. وقلبه لا سلطان له عليه، فلا يؤاخذه الله على ذلك.
المهم أن لا يتحول هذا الميل القلبي، إلى جَوْرٍ في المعاملة الظاهرية، بحيث يقدِّم لهذه التي زاد حبه لها من المعاملة والعطاء أكثر من غيرها. إن فعل ذلك يكون آثماً ظالماً.
هذا المفهوم القرآني السليم طبّقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه.
روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
وأخرج هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما. جاء يوم القيامة وأحد شِقَّيه ساقط».
وخير من يردُّ على أولئك المحرفين لمعاني الآيات، المتلاعبين بمفاهيمها، الأستاذ سيد قطب، حيث يقول: (والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس، فلا يطالَب به أحدٌ من بني الإنسان، لأنه خارج عن إرادة الإنسان.
وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾. هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد، والأمر ليس كذلك، وشريعة الله ليست هازلة، حتى تُشرَّع الأمر في آية، وتُحرَّمه في آية، بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى، والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق، هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة، وسائر الأوضاع الظاهرة».
الكلم الطيب -
أمر الله تعالى عباده أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها، ومن الكلمات أجملها عند حديث بعضهم لبعض حتى تشيع الألفة والمودة، وتندفع أسباب الهجر والقطيعة والعداوة، فقال الله تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) (الإسراء:53)
يقول الشيخ السعدي رحمه الله:
وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال:
(وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما.
والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره.
وقوله إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.
فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم (ليكونوا من أصحاب السعير)
وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم.
الكلام مسطور ومحفوظ
إنها حقيقة قررها القرآن الكريم في العديد من المواضع والآيات ؛ كي يكون الإنسان حسيبا على نفسه مراقبا للسانه، يقول الله عز وجل: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18)
ولما حكى الله عزوجل عن اليهود وبشاعة أقوالهم عقب فقال سبحانه وتعالى: (لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) (آل عمران:181).
وأخبر الله عز وجل أن الملائكة تحصي على الناس أقوالهم وتكتبها، فقال: (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) (الزخرف:80). والآيات في هذا كثيرة جدا والمقصود تنبيه العباد إلى أن ما يصدر عنهم من أقوال يكتب فإما لهم وإما عليهم، فإذا التزم الإنسان القول الحسن في جميع أحواله لم يكتب في صحيفته إلا الخير الذي يسره يوم القيامة.
عود لسانك الخير
لقد حث الشرع المطهر الناس على انتقاء الألفاظ الطيبة التي تدخل السرور على الناس، فقال الله عز وجل: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: من الآية83).
ولم يبح الله عز وجل لعباده الجهر بالسوء إلا في أحوال محددة كحالة التظلم فقال:
(لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً) (النساء:148).
قال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين،إحداها: إن لم تنفعه فلا تضره،والثانية: إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة:إن لم تمدحه فلا تذمه.
وقد كان الصالحون يتعهدون ألسنتهم فيحرصون على اخيتار الألفاظ والكلمات التي لا يندمون عليها فرأينا منهم عجبا،هذا الأحنف بن قيس يخاصمه رجل فيقول للأحنف لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا،فقال الأحنف: لكنك والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة.
ورأى عيسى عليه السلام خنزيرا فقال:مر بسلام، فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ قال أعود لساني الخير.
أما العلامة تقي الدين السبكي فسمع ولده العلامة تاج الدين يقول لكلب:يا كلب بن كلب، فنهاه عن ذلك فقل: أليس كلب بن كلب؟ فقال:شرط الجواز عدم التحقير. فقال تاج الدين: هذه فائدة.
أحق الناس بحسن منطقك
إننا وإن كنا مطالبين بإلانة القول وإحسانه للناس كافة فإن هذا المطلب يتأكد في حق أصناف من الناس هي الأولى بهذا الخلق ومن هؤلاء:
الوالدان
فأحق الناس بالتعامل معهم بهذا الخلق الكريم الوالدان اللذان أمر الله ببرهما والإحسان إليهما، ومن الإحسان إليهما اختيار الطيب من الأقوال عند الحديث إليهما: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) (الإسراء:23).
وقد كان كثير من السلف إذا تكلم مع أمه لا يكاد يُسمع من شدة حرصه على خفض صوته تأدبا، وكان بعضهم يمر كل يوم على أمه فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، وكان بعضهم يتأدب في الكلام مع والديه كأنه أسير لديهما.
وإننا لنعجب اليوم من حال شباب وفتيات يتعاملون مع الآباء معاملة فظة فيرفعون أصواتهم وينهرونهم ويسيئون إليهم ويؤذونهم بمنطقهم السيىء حتى لو إنسانا رآهم ولم يكن يعلم أن هذا هو الوالد أو أن هذه هي الأم لظن أنهما خادمان يعملان لدى الأبناء من شدة غلظة وقسوة الألفاظ التي يستخدمها بعض الأبناء مع الوالدين.
الزوجان
مما لا شك فيه أن الأساس الذي تبنى عليه البيوت هو الرحمة والمودة: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21).
فيحتاج الزوجان لاختيار أحسن الألفاظ للتخاطب بها ولإبداء مشاعر الحب والرحمة تجاه بعضها، وانظر إلى هذا الحديث الحاني بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة حين يقول لها: " إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى " قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: " أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى، قلت: لا ورب إبراهيم ". قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. فأي رحمة هذه وأي منطق حسن هذا!!
وحين قال لها صلى الله عليه وسلم: " ذريني أتعبد الليلة لربي " قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فما أحسن الطلب وما أحسن الجواب.
وتشتد حاجة الزوجين إلى هذا الخلق عند ثورة الغضب وسبق اللسان بالخطأ والزلل من أحدهما تجاه الآخر، وما أحسن ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته في بداية أمرهما: إن لقيتني غضبان فرضني، وإن لقيتك غضبى رضيتك، وإلا فلنفترق.
وانظر إلى مالك بن ينار الذي غضبت زوجته يوما فقالت له: يا منافق، فأحسن التصرف وفوت على الشيطان الفرصة فقال لها: ما عرف اسمي إلا أنت.
هكذا أيها الأحبة ينبغي للمسلم أن يتعهد لسانه وألا يقول إلا خيرا، وصدق الله القائل: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) (النساء:114).
نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير
الكلم الطيب
-
إنه لا بد للإنسان في هذه الحياة أن يخالط الناس، فحوله الجيران والأقارب، وهناك الزملاء في قاعات الدراسة، وهناك آخرون في أماكن العمل.
وبحكم هذه المخالطة مع أنواع مختلفة وأنماط متباينة فإنه لا بد وأن يصدر من بعض الناس شيء من الإساءة يقل أو يكثر، بقصد أو بغير قصد، فلو تخيلنا أن كل إساءة ستُقابَل بمثلها لتحولت المجتمعات إلى ما يشبه الغابات، ولتخلى الناس عن خصال الخير، ولغدوا بلا ضوابط ولا روابط.
وحتى لا يتحول مجتمع المسلمين إلى ما يشبه هذه الصورة المنفرة فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يدفعوا السيئة بالحسنة: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ). (فصلت:34).
ولا شك أن الخصلة التي هي أحسن من رد السيئة بمثلها إنما هي العفو والإحسان، أو الإعراض وكف الأخذ والرد في موضوع الإساءة.
إنك- أيها الحبيب- حين تتحلى بهذا الخلق الكريم فإنك تحافظ على وقارك واتزانك، فلا تنجرف مع استفزازات المحرشين اللاغين فتكون بذلك من عباد الرحمن الذين وصفهم عز وجل بقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ). (المؤمنون:3)
وقوله تبارك وتعالى: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ). (القصص:55)
وقوله تبارك وتعالى: (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً). (الفرقان: من الآية63)
وإنك حين تعامل من أساء إليك بالحسنى، تكون قد كظمت غيظك فحينئذ يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء ".
إن من أعظم ثمرات الدفع بالتي هي أحسن أن يتحول العدو الذي يجابهك بما يسوؤك ويؤذيك إلى نصير مدافع وصديق حميم.
سبحان الله ! إن سحر الخلق الفاضل ليفوق في كثير من الأحيان قوة العضلات وسطوة الانتقام، فإذا بالخصم ينقلب خلقا آخر: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم).
وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله: ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك.
إننا رأينا خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم يتحمل إساءة المسيئين، ليس هذا فحسب بل كان يعفو ويصفح، وهذا ما وصفته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: " ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ".
وهكذا كان الصالحون رضي الله عنهم على نهجه صلى الله عليه وسلم يسيرون، فهذا أحدهم يُسب فيقول لسابه: إن كنتَ كاذبا فإني أسأل الله أن يغفر لك، وإن كنت صادقا فإني أسأل الله أن يغفر لي.
إننا وإن كنا جميعا مطالبين بالتحلي بهذا الخلق فإن من رزقه الله سلطانا أولى بهذا من غيره، ولهذا كان من آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته قبل وفاته أن قال موصيا بالأنصار خيرا:
" فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم ".
ولما جاءه رجل يشكو خادمه: إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال: " تعفو عنه كل يوم سبعين مرة ".
كذلك يحتاج إلى هذا الخلق بصفة خاصة من كان له قرابة وأرحام يسيئون إليه، فإنه لا يقابل سيئتهم بمثلها ولكن يعفو ويصفح ويزداد إحسانا، فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ يقول: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام، أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: " لا؛ إذا تتركون جميعا، ولكن خذ بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك من الله ظهير ما كنت على ذلك ".
إن الدفع بالتي هي أحسن هو الدواء المرمم لما يبلى أو ينهدم من الروابط الاجتماعية، والمصلح لما يفسد منها، والمجدد لما ينطمس منها، وبه تحيا معاني الخير في النفوس، ويتبارى الناس في الإحسان، وتغلق أبواب الشر على الشيطان، ولا يتاح للإساءة أن تتفاقم بل يغمرها الإحسان ويقضي على دوافعها ورواسبها.
الكلم الطيب
-
(وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى)
قال الشيخ:( عبد الرحمن بن ناصر السعدي) رحمه الله:"{ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ }، أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه: تقتضي من الشكر ما يليق بها، ولهذا قال:{ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى }، أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدؤه، وعماد الدعوة الإسلامية".* ﴿ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىۤ ﴾، قال سفيان بن عُيينة:" أوّل العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر"، ، فإذا استمع العبد إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله: أفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا.* (وأنا اخترتك): رجعت الأمور لاختيار الله، فكما أن (الأنبياء): اختيار، فورثتهم (العلماء): اختيار، ولا يختار الله إلا المطأطئين للوحي .* الإنشغال بالقرآن: تلاوةً واستماعًا وتدبُرًا: اصطفاء رباني؛ تأمّل:﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾{وَأَنَا اخْتَرْتُكَ}: كم من الناس يفرح باختيار أمير لصحبته، أو وزير لمكتبه: كلها ستذهب سدى إلا اختيار الله لك: لدينه ودعوته.* لك الفخر: إن كنت تعقل!.هذا الرب العظيم، قدر برحمته أن يكلمك أنت أيها الإنسان، فكلمك بالقرآن، أوَ تدري ما تسمع!!؟: رب الكون يكلمك! (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى)!.أي وجدان؟، وأي قلب يتدبر هذه الحقيقة العظمى، فلا يخر ساجدًا لله الواحد القهار رغبًا ورهبًا؟.اللهم إلا إذا كان صخرًا أو حجرًا، كيف، وهذا الصخر والحجر من أخشع الخلق لله؟:(لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ).﴿وأنا اخترتك﴾ تسقط وتتلاشى كل مفاخر الدنيا و مناصبها وأوسمتها أمام اختيار الله لك.* إذا وردت : { يا أيها الذين آمنوا }؛ فأرع لها سمعك، فكيف بأمر الله عز وجل بالسماع:{ .. فاستمع لما يوحى }؟، فذاك أمرٌ عظيم، وخطبٌ جل ؛ فانْقد لما تؤمر .* لما قال الله لموسى:(وَأَنَا اخْتَرْتُكَ)، قال:(اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ).إن أروع صور الإختيار الربانى لك: أن يصرفك إلى ميادين الدعوة، لا مجال للانتظار.* يا معلم القرأن:لم اجد لك أجمل منها:﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى}.كم هو جميل شعورك بالغبطة: باختيار الله لك؛ لسماع كلامه والقرب منه!.*يا من انشغل بالقرآن:لِتعلَمَ: أن القضية قضية اختيار واجتباء، تأمَّل في مشارب الناس حولك: ذاك شغلته الدنيا، وذاك شغله المال، وآخر شغلته السهرات والسمرات... بينما أنتَ تكرر الآية تلو الآية؛ لترسخها في صدرك!.حينها: يتجلّى لك قول الله لموسى:﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾.إن الانشغال بالقرآن الكريم: تلاوةً واستماعاً وتدبراً:(اصطفاء ربّاني)؛ فالله يختارك من بين الغافلين؛ ليكون لك ورد قرآني يومي، وهذه الميزة: نعمة قلّما يستشعرها أصحابها،فإذا اختارك الله لتعلم القرآن: حفظا وفهما؛ فاستمع لما يوحى تدبرا وامتثالا.والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.{وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} [طه :١٣]
أول منازل العلم حسن الاستماع
{وأنا اخترتك} تسقط وتتلاشى كل مفاخر الدنيا ومناصبها وأوسمتها أمام اختيار الله لك .. هي بداية السعادة التي لاتنتهي .. هنا يتوقف الوجود مشدوهاً ، ماذا تعني الحياة بأسرها بعد هذه الكلمة ؟! الله لاينظر إلى الشكل و اللون بل ينظر للقلب ، إن كان طاهراً اصطفاه ..
وأنا اخترتك - وألقيت عليك محبة مني ، ولتصنع على عيني .. كيف كان قلب سيدنا موسى وهو يسمع هذه الكلمات من الله تعالى؟!
لاغرابة من أن تحب ربك فأكثر الناس كذلك ، لكن أن يحبك ربك !!! ..أعظم الحب هو أن يكون من الله فإن أحبك أسعدك ونصرك وألقى في قلوب الناس حبك ، ما أعظم أن يختارك الله أنت لتصدع بالحق ، أو تأمر بخير ، أن يختارك من بين ملايين البشر لأداء مهمة خاصة !!..
-
( وَحَنَانَاً مِنْ لَدُنَّا وزكاةً )
هل (الحنان) من صفات الله ؟
( الحنَان ) صفة ثابتة لله تعالى ، وهي بمعنى : الرحمة .
قال " الحليمي " : " الحنان : وهو الواسع الرحمة ، وقد يكون المبالغ في إكرام أهل طاعته، إذا وافوا دار القرار، لأن مَن حَنّ إلى غيره من الناس، أكرمه عند لقائه ، وكَلِف به عند قدومه "، انتهى من "المنهاج في شعب الإيمان" (1/ 207).
وقال ابن تيمية في "شرح حديث النُّزول" (184) : " وقال [يعني: الجوهري] : الحنين : الشوق ، وتوقان النفس . وقال: حنَّ إليه يحنُّ حنينًا فهو حانٌّ .
والحَنَان : الرحمة ، يقال : حنَّ عليه يحنُّ حنانًا ، ومنه قوله تعالى : ( وَحَنَانَاً مِنْ لَدُنَّا وزكاةً ). والحنَّان بالتشديد : ذو الرحمة . وتحننَّ عليه : ترحَّم ، والعرب تقول : حنانيك يا رب! وحنانك! بمعنى واحد ؛ أي : رحمتك . وهذا كلام الجوهري .
وفي الأثر في تفسير الحنَّان المنَّان: "أنَّ الحنان هو الذي يُقبل على من أعرض عنه، والمنَّان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال" ، وهذا باب واسع " انتهى .
وقال ابن القيم في "القصيدة النونية" (1/50) رادًا على الجهمية نفاة الصفات:
"قالوا وليس لربِّنَا سَمْعٌ ولا بَصَرٌ ... ولا وَجْهٌ، فكيفَ يَدَانِ
وكذاك ليس لربِّنَا من قُدْ ... رَةٍ وإرادةٍ أو رحمةٍ وحَنَانِ
كلا ولا وَصْفٌ يَقُومُ بِه ... سِوى ذاتٍ مجردةٍ بِغَيْرِ مَعَانِ".
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله : " هو صفة فعل لله - تعالى - بمعنى الرحيم، من الحنان - بتخفيف النون - وهو الرحمة، قال الله تعالى: ( وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا ) مريم/ 13 ، أي : رحمة منا "، انتهى من "معجم المناهي اللفظية" (237).
وقال علوي السقاف : " [ الحنان ] صفةٌ فعليةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجَلَّ بالكتاب والسنة.
الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: ( يَايَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّاً - وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيَّاً ) مريم/ 12 - 13.
الدليل من السنة:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: ( يوضع الصراط بين ظهراني جهنم، عليه حسك كحسك السعدان ... ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أنَّ لا إله إلا الله مخلصاً، فيخرجونهم منها ) .
قال: ثم يتحنَّن الله برحمته على مَن فيها، فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها ) .
رواه: الإمام أحمد (3/11) ، وابن جرير في التفسير (16/113) " انتهى من "صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة" (140) .
ثانيًا :
الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يعد (الحنان) من أسماء الله تعالى الحسنى.
قال: " وجاء في تفسير اسمه الحنّان، المنّان:
أنّ الحنّان: الذي يُقبل على من أعرض عنه.
والمنّان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال" انتهى من "النبوات" (1/365).
وبعض أهل العلم يمنع ذلك ، لأنه الأسماء الحسنى مبناها على "ثبوت التوقيف" بها، فما لم يرد بذكر الاسم دليل ثابت من الكتاب، أو صحيح السنة، فلا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: " هل الحنَّان, المنان ,المحسن, من أسماء الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحنان لم يثبت أنها من أسماء الله.
وأما المنان : فثابت أنها من أسماء الله، والمحسن أيضاً من أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا ما زال الناس يسمون عبد المحسن، عبد المنان، والعلماء يعلمون بذلك ولا ينكرونها." انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (4/2) - الشاملة - .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/172) : " أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يسمى الله جل وعلا إلا بما جاء في القرآن أو صحت به السنة، وبناء على ذلك فإن (الحنان) ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو صفة فعل، بمعنى: الرحيم، من الحنان بتخفيف النون- وهو الرحمة، قال الله تعالى: وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا، أي: رحمة منا، على أحد الوجهين في تفسير الآية.
وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الله تعالى ب: (الحنان) فإنه لا يثبت.
وأما: (المنان) فهو من أسماء الله الحسنى الثابتة، كما في (سنن أبي داود والنسائي) من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى" انتهى.
وقد توسع الشيخ "علوي السقاف" في دراسة ثبوت "الحنَّان" اسما لله تعالى ، في كتابه "صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة" (140 - 147) ، ثم قال:
"والخلاصة : أنَّ عدَّ بعضهم (الحنَّان) من أسماء الله تعالى فيه نظر ؛ لعدم ثبوته" انتهى .
وانظر: " معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى " ، لمحمد بن خليفة بن علي التميمي : (224).
وأما العبارة المذكورة في السؤال - (الله أَحَنُّ عليك من ألف كتف) - : فليست من باب "التسمية" ، أو إطلاق "اسم" (الحنان)، على الله جل جلاله، بل هي من باب الإخبار عنه بعظم تحننه على عباده ، وأن رحمته وحنانه على عباده: أقرب لهم من كل من سواه ، وعونه لهم ، أقرب من عون من عداه ، سبحانه ، وهذا معنى صحيح ، شريف ، لا مانع منه ، ولا حرج فيه .
والحاصل:
أن في عد (الحنان) من أسماء الله الحسنى: اختلافا بين أهل العلم، والأحسن أن يتوقف عن ذكره في باب الأسماء، ولا حرج في الإخبار عن الله جل جلاله بحنانه على عباده ، أو تحننه عليهم، ونحو ذلك.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب

{وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا} [مريم :١٣]
قيمة المرء عند الله ليس بما يملك من مال أو جاه ، بل بما يملك من نفيس الأخلاق والدين .. والتقوى رأس مالك .
{وكان تقياً} هي أعظم تزكية ، اختار الله التقوى ليلفت نظرنا إلى أهم خصلة يتحلى بها المرء ... ونحن لاندري أيقول الله عنا في الملأ الأعلى وكان تقياً أو وكان شقياً ؟!
{وحناناً من لدنا} مهما كان ألمك وأملك سيدركه حنان الله . الحنان هبة من الله ، عندما يعطيك الله الحنان والرحمة فقد أعطاك خيراً عظيماً ..استشعر {فإنك بأعيننا} كيف تشعر ؟ أمع الله جرح لايبرأ ؟! أمع الله كسر لايُجبر ؟!
لن نجد أحن من الله تعالى علينا ، الله وحده يغشانا بحنانه حين يتخلى عنا الجميع .. كم من ظلم وقع عليك ونصرك الله ؟! الحنان هو الرحمة والرأفة التي تتيسر بها الأمور وتستقيم بها الأحوال .. اللهم هب لنا من لدنك حناناً -
-
أَهْلُ النَّارِ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْعَذَابِ تَفَاوُتًا كَبِيرًا؛ فَيُعَذَّبُونَ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا النَّارَ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَالصَّدِّ عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمُحَارَبَةِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَكُلَّمَا كَثُرَتْ أَعْمَالُهُمُ السَّيِّئَةُ وَتَعَدَّدَتِ اشْتَدَّ عَذَابُهُمْ، وَكَانَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ أَخَفَّ عَذَابًا مِنْهُمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ * وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الْأَحْقَافِ: 18-19]؛ «أَيْ: وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ فِي النَّارِ بِحَسَبِهِ»، وَقَالَ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ عَدَّدَ جُمْلَةً مِنْ أَنْوَاعِ عَذَابِهِمْ: ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا ﴾ [النَّبَأِ: 26]؛ «أَيْ: جَزَيْنَاهُمْ جَزَاءً وَافَقَ أَعْمَالَهُمْ»، «فَلَيْسَ عِقَابُ مَنْ تَغَلَّظَ كُفْرُهُ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، وَدَعَا إِلَى الْكُفْرِ، كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ»؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النَّحْلِ: 88]، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِهَا: «زِيدُوا عَقَارِبَ لَهَا أَنْيَابٌ كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ» صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.
وَيَدْعُو الْأَتْبَاعُ عَلَى مَنْ أَضَلُّوهُمْ، وَهُمْ جَمِيعًا فِي النَّارِ؛ ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الْأَعْرَافِ: 38]؛ «أَيْ: قَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَجَازَيْنَا كُلًّا بِحَسْبِهِ».
وَدَلَّ عَلَى تَفَاوُتِهِمْ فِي الْعَذَابِ حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ قَدِ اغْتُمِرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.
وَإِذَا عَمِلَ الْكَافِرُ حَسَنَاتٍ فِي الدُّنْيَا كَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَكَفَالَةِ الْأَيْتَامِ، وَالسَّعْيِ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ، وَمُعَالَجَةِ الْمَرْضَى، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ فِي الدُّنْيَا؛ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَنْ تَكُونَ سَبَبًا فِي تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ أَعْمَالَهُ الطَّيِّبَةَ تَفْتَقِدُ شَرْطَ الْقَبُولِ وَهُوَ الْإِيمَانُ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: 91]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الْمَائِدَةِ: 5]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الْأَعْرَافِ: 147]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [التَّوْبَةِ: 17]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: 18]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النُّورِ: 39]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الْفُرْقَانِ: 23].
وَيُجْزَى الْكَافِرُ بِأَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ جَزَاءً دُنْيَوِيًّا مِنْ سَعَةِ الرِّزْقِ، وَبِرِّ الْوَلَدِ، وَحُنُوِّ الزَّوْجَةِ، وَالْعَافِيَةِ فِي الْبَدَنِ، وَالْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَأَمَّا مَا جَاءَ مِنْ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ؛ فَهُوَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَبِي طَالِبٍ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَيَبْقَى عُمُومُ الْكُفَّارِ لَا شَفَاعَةَ لَهُمْ فِي تَخْفِيفِ الْعَذَابِ؛ لِبُطْلَانِ أَعْمَالِهِمْ؛ وَلِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [الْمُدَّثِّرِ: 48]، قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ الَّذِي مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا يُجَازَى فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى».
كَمَا يَتَفَاوَتُ عَذَابُ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ؛ فَإِنَّ عُصَاةَ الْمُوَحِّدِينَ -وَهُمْ أَهْلُ الْكَبَائِرِ- إِذَا دَخَلُوا النَّارَ يَتَفَاوَتُونَ فِيهَا؛ فَأَمَّا أَهْلُ الصَّغَائِرِ فَتُغْفَرُ لَهُمْ صَغَائِرُهُمْ بِاجْتِنَابِهِمُ الْكَبَائِرَ، وَبِأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النِّسَاءِ: 31].
وَعُصَاةُ الْمُوَحِّدِينَ عَلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ:
فَقِسْمٌ مِنْهُمْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ؛ فَلَا يَدْخُلُونَ النَّارَ، بَلْ يَصِيرُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَقِسْمٌ تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ مَعَ سَيِّئَاتِهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ الْأَعْرَافِ، فَيُحْبَسُونَ فِي قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَقِسْمٌ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، فَهُمْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْجُو مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ الشُّفَعَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُهَا لِيُطَهَّرَ مِنْ ذُنُوبِهِ،
وَالْمُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ مِنْ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ عَلَى أَقْسَامٍ؛
فَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَجُ مِنْهَا قَبْلَ اسْتِكْمَالِ عَذَابِهِ، إِمَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوِهِ سُبْحَانَهُ، وَإِمَّا بِشَفَاعَةِ الشُّفَعَاءِ، وَقَبُولِ اللَّهِ تَعَالَى شَفَاعَتَهُمْ فِيهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ سُبْحَانَهُ، وَكَرَامَةً لِلشُّفَعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ أُنَاسٌ يَبْقَوْنَ فِي النَّارِ إِلَى اسْتِكْمَالِ عُقُوبَتِهِمْ، ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُونَ فِي النَّارِ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا وَيُحْيِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى لِدُخُولِ الْجَنَّةِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَالْمُؤْمِنُ إِذَا ذُكِّرَ تَذَكَّرَ، وَإِذَا وُعِظَ اتَّعَظَ، وَتَرْدَعُهُ آيَاتُ الْوَعِيدِ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ غَيِّهِ، وَتَرُدُّهُ عَنْ عِصْيَانِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنَ الْمُتَفَكِّرِينَ الْمُتَدَبِّرِينَ، فَيَتَفَكَّرُ فِي حَرِّ الصَّيْفِ وَشَمْسِهِ اللَّاهِبَةِ لِحَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ، وَيَتَدَبَّرُ آيَاتِ وَصْفِ النَّارِ فِي الْقُرْآنِ؛ لِيَفِرَّ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ لَهُ طَاقَةٌ عَلَى عَذَابِ النَّارِ؟! نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا.
الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الالوكة
-
الرسالة في ثلاث كلمات:
س 354: آية كريمة من آيات الكتاب العزيز مكونة من ثلاث كلمات، اشتملت على جميع ما في الرسالة، فما هي؟
ج 354: قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: 94].
الحرث:
س 355: قال تعالى: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، لماذا قال: ﴿ حَرْثَكُمْ ﴾، هذه اللفظة الدقيقة المعبرة عن الجماع؟
ج 355: لأنه لما كان يحتمل معنى كيف وأين احترس سبحانه بقوله: ﴿ حَرْثَكُمْ ﴾؛ لأنَّ الحرث لا يكون إلا حيث تنبت البذور، وينبت الزرع، وهو المحل المخصوص؛ [البرهان للزركشي 1/ 67].
تقديم ذكر العذاب:
س 356 :قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: 40]، لمَ قدم العذاب عن المغفرة في هذه الآية؟
ج 356: اقتضت الحكمة تقديم ذكر العذاب ترهيبًا وزجرًا؛ لأنَّ الآية وردت في ذكر قطاع الطريق والمحاربين والسُّرَّاق، فكان المناسب تقديم ذكر العذاب. وهو ما ورد في الآية 33 قبلها:
﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ [المائدة: 33] والآية 38: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].
تكرار [إذا]:
س 357: في سورة كريمة من سور القرآن الكريم، تكرر اسم الشرط إذا اثنتا عشرة مرة في السورة ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 357: سورة التكوير.
أحد عشر قسمًا متواليًا في سورة:
س 358: أقسم الله تعالى في إحدى سور القرآن الكريم أحد عشر قسمًا متواليًا، ولا يوجد في القرآن بأكمله أقسام متوالية على هذا النسق البديع، فما الآيات؟ وما السورة؟
ج 358: قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحاها * وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها * وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها * وَالسَّماءِ وَما بَناها * وَالْأَرْضِ وَما طَحاها * وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ﴾ [الشمس: 1 - 7].
جعلناه... لجعلناه:
س 359: قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا... ﴾ [الواقعة: 68 - 70] وقال سبحانه: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ* أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطامًا ﴾ [الواقعة: 63 - 65]، لماذا قال في الأولى جَعَلْناهُ وفي الثانية: لَجَعَلْناهُ؟
ج 359: في الأولى جعلناه أجاجًا مالحًا بدون لام التوكيد؛ لأن أحدًا لن يستطيع الادِّعاء بإمكانيته إنزال المطر المالح الأجاج من السحب، فلا حاجة للتوكيد، بينما في الثانية كان التوكيد لضرورة، فهناك من قد يدعي أنه يستطيع إتلاف الزرع؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 35].
والذي هو يطعمني:
س 360: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ [الشعراء: 81]، وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: 79]، لماذا جاء بكلمة هُوَ في الثانية ولم يأتِ به في الأولى؟
ج 360: جاء بكلمة هُوَ ليؤكد الفعل الإلهي وصرف دعوة المدَّعين أنهم سبب الإطعام، بينما في الأولى لن يدعي أحد خلق الإنسان وإماتته وإحياءه؛ فلم تكن ضرورة للتوكيد؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 35].
السمع والبصر:
س 361: قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [النحل: 78]، وقال سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصارًا وَأَفْئِدَةً ﴾ [الأحقاف: 26]، لماذا يقدم دائمًا السمع على البصر؟
ج 361: الحقيقة العلمية أن السمع أكثر كمالًا وإرهافًا، كما يصاحب السمع الإنسان حتى في نومه فينام بصره ولا ينام سمعه.
وتشريحيًّا جهاز السمع أعظم دقة من العين. والطفل لا يرى ولكنه يسمع من لحظة الميلاد. وإشارة إلى أنَّ السمع لا يتعطَّل في النوم أو غيره كانت الآية: ﴿ فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف: 11] دلالة على تعطيل كافة الحواس. فتأمل هنا كذلك الإعجاز العلمي إلى جانب الإعجاز البلاغ؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 33].
اختلاف الفاصلتين:
س 362: قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [الجاثية: 15]، وقال سبحانه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]، ما سِرُّ اختلاف الفاصلتين في الآيتين؟ أي اختلاف الخاتمتين.
ج 362: نكتة ذلك أنَّ قبل الآية الأولى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الجاثية: 14]، فناسب الختام بفاصلة البعث؛ لأن قبله وصفهم بإنكاره، وأما الآية الثانية فالختام بما فيها مناسب أنه لا يضيع عملًا صالحًا ولا يزيد على من عمل سيئًا؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 131].
اختلاف الفاصلتين:
س 363: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 48]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 116]، ما سبب اختلاف الفاصلتين في الآيتين؟
ج 363: نكتة ذلك أن الأولى نزلت في اليهود وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه، والثانية نزلت في المشركين ولا كتاب لهم وضلالهم أشد؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 131].
تقديم المنِّ على الفداء:
س 364: قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ﴾ [محمد: 4]، لماذا قدَّم المنَّ على الفداء؟
ج 364: في الآية الكريمة إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال، فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله، لا للمغنم المادي والكسب الدنيوي؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 449].
وتدلوا:
س 365: قال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]، ما الحكمة في التعبير بكلمة ﴿ وَتُدْلُوا ﴾؟
ج 365: كلمة تدلوا تبين أن اليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفلى، مع كون الحكام الذين تلقى إليهم الأموال في الأعلى لا في الأسفل، فجاءت لتعبِّر عن دناءة المرتشي وسفله ولو كان في الذروة من حيث المنصب وموقع المسئولية؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 32].
فاجلدوا:
س 366: قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]، لم عبَّر بقوله: ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ ولم يقل: فاضربوا؟
ج 366: للإشارة إلى أن الغرض من الحد الإيلام بحيث يصل ألمه إلى الجلد؛ لعظم الجرم ردعًا له وزجرًا؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 15].
غض البصر:
س 367: قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: 30]، ما السر في تقديم غض البصر على حفظ الفروج؟
ج 367: لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، وهو مقدمة للوقوع في المخاطر، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه، وهو الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 148].
أغطش:
س 368: قال تعالى: ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها ﴾ [النازعات: 29]، لم قال: "أغطش"، ولم يقل: أظلم؟
ج 368: أغطش مساوية من حيث الدلالة اللغوية لأظلم؛ ولكن أغطش تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة، فالكلمة تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعمَّ الركود وبدت في أنحائه مظاهر الوحشة، ولا يفيد هذا المعنى أظلم؛ إذ هي تعبر عن السواد الحالك ليس غير؛ [مباحث في إعجاز القرآن/ 147].
اثَّاقَلْتم:
س 369: قال تعالى: ﴿ ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ [التوبة: 38]، ما الحكمة في التعبير بكلمة "اثَّاقَلْتُمْ"؟
ج 369: كلمة "اثَّاقَلْتُمْ" غير تثاقلتم، ففي حروف الأولى اندماج وتلاصق لتعبر أعظم تعبير عن جبن الجبناء الذين يلتصقون بالأرض خوفًا إذا ما دعوا إلى القتال؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 32].
الزانية والزاني:
س 370: قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]، لماذا قدم الزانية على الزاني بينما في السرقة قدم السارق على السارقة؟
ج 370: لما للمرأة من دور إيجابي يفوق دور الرجل، كما أنَّ آثار الزنى ستظهر على المرأة لا الرجل؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 33].
من إملاق، خشية إملاق:
س 371: قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [الأنعام: 151]، وقال سبحانه: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء: 31]، لماذا قال في الأولى: ﴿ مِنْ إِمْلاقٍ ﴾ وفي الثانية: ﴿ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴾؟
ج 371: لأن الأولى خطاب للفقراء المقلين؛ أي: لا تقتلوهم من فقر بكم فحسن: ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ﴾- ما يزول به إملاقكم. ثم قال: ﴿ وَإِيَّاهُمْ ﴾؛ أي: نرزقكم جميعًا.
والثانية خطاب للأغنياء: أي خشية فقر يحصل لكم بسببهم، ولذا حسن: ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 148].
وجنة عرضها السماوات والأرض:
س 372: قال تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: 133]، لماذا قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿ عَرْضُهَا ﴾ ولم يقل: طولها؟
ج 372: لأن العرض أخص؛ إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 101].
بعض آية ومعانٍ جمَّة:
س 373: قال السيوطي في إتقانه عن بعض آية: جمعت الخير والطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد، فما هي الآية؟
ج 373: قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 124].
الحياة الآمنة:
س 374: قالوا في الآية: المعنى كثير واللفظ قليل. وقد فضلت هذه الآية على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم: القتل أنفى للقتل بعشرين وجهًا أو أكثر. فما هي هذه الآية البالغة الذروة في الإيجاز والفصاحة؟
ج 374: قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179].
من مال وبنين:
س 375: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ ﴾ [الشعراء: 88]، وقال سبحانه: ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: 116].
لماذا قدم الله تعالى المال على البنين؟
ج 375: أثبتت الدراسات الاجتماعية والواقع المجرب أنَّ المال عند أكثر الناس أعز من الولد، كما يفقد المرء أولاده، ولكنه يحرص على ماله الذي يصحبه حتى الممات. وفوق هذا وذاك، يستغني الإنسان عن ولده في أمور معيشته ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن المال، فبدونه لا تتحقق له معيشة وحياة؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 34].
لمن عزم الأمور:
س 376: قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 17]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: 43] لم الصبر في الأولى ﴿ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ وفي الثانية ﴿ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾؟
ج 376: سر التوكيد باللام في الثانية أنه صبر مضاعف؛ لأنه صبر على عدوان بشري له فيه غريم وهو مطالب فيه بالصبر والمغفرة معًا، وهو أمرُّ على النفس من الصبر على القضاء الإلهي الذي لا حيلة فيه؛ [وجوه من الإعجاز القرآني/ 35].
العدة حق للمطلق:
س 377: قال تعالى: ﴿ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ﴾ [الأحزاب: 49]، لماذا أسند العدة للرجال في قوله تعالى: ﴿ لَكُمْ ﴾؟
ج 377: إشارة إلى أنها حق للمطلق، فوجوب العدة على المرأة من أجل الحفاظ على نسب الإنسان، فإنَّ الرجل يغار على ولده، ويهمه ألَّا يسقي زرعه بماء غيره، ولكنها على المشهور ليست حقًّا خالصًا للعبد؛ بل تعلُّق بها حق الشارع أيضًا، فإنَّ منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 288].
ثنى ثم جمع ثم أفرد:
س 378: قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: 87]، لماذا ثنَّى في الخطاب ثم جمع ثم أفرد؟
ج 378: ثنى في الأول تَبَوَّءا؛ لأنه خوطب أولًا موسى وهارون لأنهما المتبوعان، ثم سيق الخطاب عامًّا ﴿ وَاجْعَلُوا ﴾ و ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأنه واجب عليهم، ثم خصَّ موسى بالبشارة وَ﴿ بَشِّرِ ﴾ تعظيمًا له؛ [البرهان للزركشي 2/ 242].
من فوقهم:
س 379: قال تعالى: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: 26]، لماذا قال: ﴿ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾، والسقف لا يكون إلا من فوق؟
ج 379: لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أنَّ السقف قد يكون من تحت بالنسبة، فإنَّ كثيرًا من السقف يكون أرضًا لقوم وسقفًا لآخرين، فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين: وهما قوله: ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾، ولفظة "خرّ"؛ لأنها لا تُستعمَل إلا فيما هبط أو سقط من العلوِّ إلى أسفل، وهذا من بلاغة القرآن ودقته؛ [البرهان للزركشي 3/ 67].
تواب حكيم:
س 380: قال تعالى: ﴿ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: 9، 10]، لما كانت الفاصلة في الآية ﴿ حَكِيمٌ ﴾؟
ج 380: إنَّ الذي يظهر في أول النظر أنَّ الفاصلة تواب رحيم؛ لأنَّ الرحمة مناسبة للتوبة، وخصوصًا من هذا الذنب العظيم، ولكن هاهنا معنى دقيق من أجله قال ﴿ حَكِيمٌ ﴾، وهو أن ينبِّه على فائدة مشروعية اللّعان، وهي الستر عن هذه الفاحشة، وذلك من عظيم الحكم؛ فلهذا كان حَكِيمٌ بليغًا في هذا المقام دون رحيم؛ [البرهان للزركشي 1/ 91].
عشرون ضربًا من البديع في آية:
س 381: قال ابن أبي الأصبع: ولم أرَ في الكلام مثل قوله تعالى... وذكر الآية، فإن فيها عشرين ضربًا من البديع، وهي سبع عشرة لفظة، كل لفظة سهلة مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة وعقادة التركيب، فما هي هذه الآية الغنية بضروب البديع؟
ج 381: قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: 44].
آية تكررت ثماني مرات في سورة:
س 382: التكرار من محاسن الفصاحة في القرآن الكريم، وفي إحدى سور القرآن الكريم تكررت هذه الآية ثماني مرات: ﴿ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾، كل مرة عقب كل صورة. فما هي هذه السورة؟
ج 382: سورة الشعراء.
أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين:
س 383: قال تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ ﴾ [المائدة: 54]، لماذا قال: ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ ﴾ عقب ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾؟
ج 383: فإنه لو اقتصر على ﴿ أَذِلَّةٍ ﴾ لتوهم أنه لضعفهم فدفع هذا الوهم بقوله: ﴿ أَعِزَّةٍ ﴾، وسبحان من هذا كلامه؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 96].
أشداء على الكفار رحماء بينهم:
س 384: قال تعالى في وصف أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم: ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: 29]، لماذا قال: ﴿ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ﴾ عقب ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾؟
ج 384: إذ لو اقتصر على ﴿ أَشِدَّاءُ ﴾ لتوهم أنه لغلظهم، فدفع هذا الوهم بقوله: ﴿ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإتقان للسيوطي 2/ 96].
ذلكم قولكم بأفواهكم:
س 385: قال تعالى: ﴿ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب: 4] قال الزمخشري: من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالفم، فلماذا ذكر قوله: ﴿ بِأَفْواهِكُمْ ﴾؟
ج 385: الجواب: أنَّ فيه إشارة إلى أنَّ هذا القول ليس له من الحقيقة والواقع نصيب، إنما هو مجرد ادعاء باللسان، وقول مزعوم باطل نطقت به شفاههم دون أن يكون له نصيب من الصحة والله أعلم؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 260].
ثم طلقتموهن:
س 386: قال تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 49]، لماذا كان التعبير بـ "ثُمَّ" دون الفاء أو الواو؟
ج 386: لأن "ثُمَّ" تفيد الترتيب مع التراخي، للإشارة إلى أنَّ الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكير طويل، ولضرورة ملحة؛ لأن الطلاق من الأمور التي يبغضها الله؛ حيث فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية؛ ولهذا قال بعض الفقهاء: إنَّ الآية ترشد إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وأنه لا يباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية، ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 288].
فلا يقربوا:
س 387: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ﴾، لماذا كان النهي عن قربان المسجد الحرام مع أن المراد نهيهم عن دخول المسجد الحرام؟
ج 387: النهي عن قربان المسجد الحرام جاء بطريق المبالغة؛ لأن الغرض نهيهم عن دخول المسجد الحرام، فإذا نهوا عن قربانه كان النهي عن دخوله من باب أولى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ﴾، وقوله: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ﴾، فيكون النهي عن أكل مال اليتيم، وارتكاب الزنا محرمًا من باب أولى؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 579].
تكرار [أم]:
س 388: أم حرف عطف تكرر في سورة كريمة من سور القرآن الكريم ستّ عشرة مرة بين آيات السورة، ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي هذه السورة الكريمة؟
ج 388: سورة الطور.
ويل يومئذ للمكذبين:
س 389: في إحدى سور القرآن الكريم تكررت الآية: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي السورة؟ وكم مرة تكررت الآية؟
ج 389: سورة المرسلات، تكررت الآية عشر مرات في السورة.
والسارق والسارقة:
س 390: قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: 38] لماذا قدَّم السارق على السارقة؟
ج 390: لأنَّ السرقة في الذكور أكثر، والغالب وقوعها من الرجل؛ لأنَّه أجرأ عليها وأجلد وأخطر، فقدم عليها لذلك؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 14].
جباههم وجنوبهم وظهورهم:
س 391: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [التوبة: 35]، لماذا قدَّم الجباه ثم الجنوب ثم الظهور؟
ج 391: لأن مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف وجهه أولًا عن السائل، ثم يعرض بجانبه، ثم يتولَّى بظهره، فعوقب بكيِّها في نار جهنم؛ [مختصر تفسير الطبري].
ذو رحمة واسعة:
س 392: قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ ﴾ [الأنعام: 147]، لماذا قال: ﴿ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ ﴾ مع أنَّ ظاهر الخطاب ذو عقوبة شديدة؟
ج 392: إنما قال ذلك نفيًا للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد، ومعناه: لا تغتروا بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته، فإنَّه مع ذلك لا يردُّ عذابه عنكم؛ [البرهان للزركشي 1/ 91].
لعلَّهم يرشدون:
س 393: قال تعالى: وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة: 186] لماذا ختم الآية بقوله لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة؟
ج 393: قيل: فيه تعريض بليلة القدر؛ أي: لعلهم يرشدون إلى معرفتها، وإنَّما يحتاجون للإرشاد إلى ما لا يعلمون، فإنَّ هذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم رمضان وتعليمهم الدعاء فيه، وأنَّ أرجى أوقات الإجابة فيه ليلة القدر؛ [البرهان للزركشي 1/ 93].
أفلا تعقلون:
س 394: قال تعالى: ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 76]، لماذا ختم الآية بقوله: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾؟
ج 394: لأنَّ من دلَّ عدوَّه على عورة نفسه، وأعطاه سلاحه ليقتله به، فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل؛ فلهذا ختمها بقوله: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾؛ [البرهان للزركشي 1/ 83].
وهم لا يشعرون:
س 395: قال تعالى على لسان النملة: ﴿ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: 18]، لماذا قال: ﴿ لا يَشْعُرُونَ ﴾ عقب تحذير النملة؟
ج 395: هذا احتراس؛ لئلا يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان عليه السلام؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 96].
أحد عشر جنسًا من الكلام في آية:
س 396: آية كريمة من أربع كلمات، جمعت أحد عشر جنسًا من الكلام: النداء، والكناية، والتنبيه، والتسمية، والأمر، والقصص، والتحذير، والتخصيص، والتعميم، والإشارة، والعذر، فأدَّت خمسة حقوق: حق الله، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق نبيِّها، ورعيته. فما هي هذه الآية الكريمة المعجزة؟
ج 396: قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ ﴾ [النمل: 18]؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 71].
أصول الكلام في آية:
س 397: آية كريمة من آيات الكتاب العزيز، جمع الله فيها أصول الكلام: النداء، والعموم، والخصوص، والأمر، والإباحة، والنهي، والخبر، فما هي الآية الكريمة؟
ج 397: قوله تعالى: ﴿ يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31]؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 72].
أعظم آية في القرآن فصاحة:
س 398: قال ابن العربي: هي من أعظم آي القرآن فصاحة؛ إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، فما هي؟
ج 398: قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: 7].
لو غفر ورحم لما قطع:
س 399: قال الأصمعي: كنت أقرأ: "﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ﴾ [المائدة: 38] غفور رحيم" وبجانبي أعرابي فقال: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله. قال: أعد، فأعدت، فقال: ليس هذا كلام الله، فانتبهت، فقرأت: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، فقال: أصبت، هذا كلام الله، فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، فقلت: من أين علمت؟
ج 399: قال الأعرابي: يا هذا، عزّ فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع؛ وبهذا كشف الأعرابي وجه الإعجاز في الآية؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 545].
الأمن والأمنة:
س 400: قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ [الأنفال: 11] وقال سبحانه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: 67]، فما هو الفرق بين الأمنة والأمن في الآيتين؟
ج 400: ورد في كتاب الكليات لأبي البقاء هذا الفرق: الأمن يكون مع زوال سبب الخوف، والأمنة مع بقاء سبب الخوف، ونلاحظ في الآية الأولى أن النعاس الأمنة لم يلغ سبب الخوف، وهو وجود الكفار المحاربين ونشوب الحرب واحتدام القتال.
ونلاحظ في الآية الثانية أنَّ الله امتنَّ على قريش بأن هيَّأ لهم الأمن، فعاشوا في ظلال حرم الله الآمن، عاشوا آمنين في واحة الأمن والأمان عند الكعبة، والناس حولهم يتعذبون ويتخطَّفون في صحراء الحرب والنهب والخوف والقلق.
إن شاء الله:
س 401: قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ ﴾ [التوبة: 28] لماذا علق الإغناء بالمشيئة في الآية السابقة؟
ج 401: تعليق الإغناء بالمشيئة في قوله جل وعلا: ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ ﴾ لتعليم رعاية الأدب مع الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ وللإشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على أنَّ المطلوب سيحصل حتمًا، بل لا بدَّ من التضرُّع إلى الله تعالى في طلب الخير، وفي دفع الآفات؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 580].
وما أنزلنا على عبدنا:
س 402: قال تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ ﴾ [الأنفال: 41] لم قال: ﴿ عَبْدِنا ﴾ ولم يقل: محمدًا؟
ج 402: قوله تعالى: ﴿ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا ﴾ المراد به محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ وإنما لم يذكره باسمه تعظيمًا له وتكريمًا؛ لأنَّ أعظم وأشرف أوصاف الرسول صلّى الله عليه وسلّم وصفه بالعبودية، وهذا هو السرُّ في ذكره في سورة الإسراء بهذا الوصف الجليل: ﴿ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ ﴾ وإضافة العبد إليه تعالى تشعر بكمال العناية والتكريم؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 602].
الإصلاح بين الزوجين:
س 403: قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ﴾ [النساء: 35]، لماذا قال: ﴿ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ﴾ و ﴿ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها ﴾؟
ج 403: قال الزمخشري: وإنما كان الحكمان من أهلهما؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، وأطلب للصلاح، وإليهم تسكن نفوس الزوجين، ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض، وإرادة الصحبة والفرقة، وموجبات ذلك ومقتضياته، وما يزويانه عن الأجانب، ولا يحبان أن يطلعوا عليه؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 468].
الإناث والذكور:
س 404: قال تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ﴾[الشورى: 49] لماذا قدم سبحانه الإناث على الذكور في الآية؟
ج 404: يقول ابن القيم- رحمه الله- في كتابه أحكام المولود: بدأ سبحانه بذكر الإناث جبرًا لهنَّ لأجل استثقال الوالدين لمكانهنّ، وقيل- وهو أحسن-: إنما قد قدمهنَّ؛ لأنَّ سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان، فإنَّ الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبًا وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان.
وعندي وجه آخر- والكلام لابن القيم- وهو أنه سبحانه قدَّم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهنَّ؛ أي: هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر، وتأمل كيف نكَّر الله الإناث، وعرَّف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم، وجبر نقص التأخير بالتعريف، فإنَّ التعريف تنويه؛ [أحكام المولود لابن القيم].
التناسب في المعنى:
س 405: قال تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ [طه: 118، 119]، كيف قابل الجوع بالعري، والظمأ بالضحى؟
ج 405: يقول ابن القيم في فوائده: الداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلى الفصاحة والجلالة؛ لأن الجوع ألم الباطن، والعري ألم الظاهر، فهما متناسبان في المعنى، وكذلك الظمأ مع الضحى؛ لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن، والضحى موجب لحرارة الظاهر؛ فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرًا وباطنًا؛ [الفوائد لابن القيم].
أفلا تبصرون:
س 406: قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَدًا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [القصص: 72]، لماذا قال: ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ ولم يقل: أفلا تسمعون؟
ج 406: لأنه لما أضاف جعل النهار سرمدًا إليه صار النهار كأنه سرمد، وهو ظرف مضيء تنوّر فيه الأبصار، وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره، وغيره ليس بفاعل على الحقيقة، فصار الليل كأنه معدوم؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجد، والنهار كأنه موجود سواه؛ إذ جعل وجوده سرمدًا منسوبًا إليه، فاقتضت البلاغة أن يقول: ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾؛ إذ الظرف مضيء صالح للإبصار، وهذا من دقيق المناسبة المعنوية؛ [البرهان للزركشي 1/ 82].
أفلا تسمعون:
س 407: قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ ﴾ [القصص: 71]، لماذا قال: ﴿ أَفَلا تَسْمَعُونَ ﴾ ولم يقل: ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾؟
ج 407: اقتضت البلاغة أن يقول: ﴿ أَفَلا تَسْمَعُونَ ﴾ لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع، ولا يصلح للإبصار؛ [البرهان للزركشي 1/ 82].
عن صلاتهم ساهون:
س 408: قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ [الماعون: 4، 5]، لماذا قال: ﴿ عَنْ صَلاتِهِمْ ﴾ ولم يقل: في صلاتهم؟
ج 408: قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال: ﴿ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ ولم يقل: في صلاتهم؛ لأنه لو قال: في صلاتهم، لكانت في المؤمنين، والمؤمن قد يسهو في صلاته، ولكنه أراد بهم المنافقين؛ لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا هو السرُّ في التعبير بـ "عَنْ"؛ [مختصر تفسير الطبري].
أعرابي سجد لفصاحة كلام الله تعالى:
س 409: جاء في الإتقان للسيوطي أنَّ أعرابيًّا لما سمع هذه الآية... وذكرها، سجد وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. فما هي الآية الكريمة التي هزَّت الأعرابي، فسجد لفصاحتها؟
ج 409: قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: 94]؛ [الإتقان للسيوطي].
تكرار [أو]:
س 410: في آيتين كريمتين من آيات القرآن الكريم تكرر حرف العطف أو إحدى عشرة مرة في كل من الآيتين الكريمتين، ولم تكن غرابة ولا تنافر ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي السورة، وما الآيتان اللتان ورد فيهما التكرار؟
ج 410: سورة النور، والآيتان هما: الآية رقم 31، والآية رقم 61؛ إذ تكرر حرف العطف أو في كل من الآيتين إحدى عشرة مرة.
لولا:
س 411: في إحدى سور القرآن الكريم تكررت كلمة لولا سبع مرات في سبع آيات، ولم تكن غرابة، ولا تنافر، ولا تكرار للمعاني، وهذا من إعجاز القرآن البياني، فما هي السورة، وما هي الآيات؟
ج 411: سورة النور، والآيات هي: 10، 12، 13، 14، 16، 20، 21.
جميع عيوب الخمر:
س 412: في آية موجزة بليغة وصف الله تعالى خمر أهل الجنة وصفًا جمع فيه جميع عيوب الخمر في الدنيا من الصداع وذهاب العقل ونفاد المال، وأنَّ أهل الجنة لا يصيبهم ذلك أبدًا، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 412: قوله تعالى: ﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ [الواقعة: 19].
حصونهم ثم بيوتهم:
س 413: قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ﴾ [الحشر: 2]، لماذا عدل القرآن عن كلمة حصون إلى كلمة بيوت؟ وما الذي تغير في هذه الحصون حتى صارت بيوتًا؟
ج 413: إنها هي لم يتغير شيء في حجارتها ولا بنيانها، ولكن التي تغيرت هي إرادة وعزيمة وثبات الذين بداخلها، إنَّ نظرة اليهود لحصونهم هي التي تغيرت، نتيجة الرعب الذي ملأ قلوبهم، لقد سيطر الجبن عليهم وتمكَّن من قلوبهم، فما عادوا يعتمدون على حصونهم، ولا يركنون إليها، إنها الآن نتيجة للجبن والرعب ليست إلا بيوتًا عادية.
كلما:
س 414: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ* أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ* وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 99 - 101]، والسؤال: ما سرُّ اختيار كلمة "كلما" في سياق الآيات؟
ج 414: كلمة "كلما" تدل على أنَّ نقض العهد عملية متكررة عند اليهود، فكل عهد يعقدونه يقومون بنقضه، مهما كان الطرف الآخر الذي عقدوا معه؛ لأن "كلما" حرف يفيد التكرار والاستمرار، ويدل على تحقيق وتوفر وجود جوابها عند وجود شرطها- كلما حرف شرط، وفعلها في الآية ﴿ عاهَدُوا عَهْدًا ﴾- فيتكرر وجود الجواب بتكرار وجود الفعل.
والعجيب في الآية: أنها تدلنا على خبث ومكر اليهود في نقض العهود، فعندما يعقدون عهدًا لا يقومون جميعًا بنقضه؛ وإنما ينقضه فريق منهم، والآخرون قد يتبرءون من هذا الفريق الناقض، وقد يعلنون معارضتهم لفعله، مع أنهم هم الذين رتبوا الأدوار، وأوحوا للناقض بذلك. إنه مكر يهودي حاقد واضح في تاريخ اليهود.
فاجتنبوه:
س 415: قال تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، لماذا عبَّر بقوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ ولم يقل تعبيرًا غيره؟
ج 415: التعبير بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ أبلغ في النهي والتحريم من لفظ حرَّم؛ لأن معناه البُعْد بالكلية فهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ﴾، فقوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ معناه: كونوا في جانب آخر منه، وكلما كانت الحرمة شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب كما قال تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ﴾ ومعلوم أنه ليس هناك ذنب أعظم من الإشراك بالله؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 561].
بم فضَّل الله بعضهم على بعض:
س 416: قال تعالى: ﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34]، لماذا ورد النظم الكريم ﴿ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ﴾ ولم يرد "بما فضلهم عليهن"؟
ج 416: ورد التعبير بهذه الصيغة لحكمة جليلة، وهي إفادة أنَّ المرأة من الرجل، والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة البدن، ولا ينبغي أن يتكبَّر عضو على عضو؛ لأن كل واحد يؤدي وظيفته في الحياة، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، فالكل يؤدي دوره بانتظام، ولا غنى لواحد عن الآخر، ثم للتعبير حكمة أخرى وهي الإشارة إلى أنَّ هذا التفضيل إنما هو للجنس، لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم، والدين، والعمل، وكما يقول الشاعر:ولو كان النساء كمن ذكرنا
لفُضِّلَتِ النساءُ على الرجال


وبهذين المعنيين اللذين ذكرناهما ظهر أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 467].
فتحت أبوابها... وفتحت أبوابها:
س 417: قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ [الزمر: 71]، وقال سبحانه: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ [الزمر: 73]، لماذا قال في الأولى: ﴿ فُتِحَتْ ﴾ وفي الثانية: ﴿ وَفُتِحَتْ ﴾؟
ج 417: قال المفسرون: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة. وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالًا وترويعًا لهم؛ [تفسير القرطبي].
ثيبات وأبكارًا:
س 418: قال تعالى: ﴿ عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكارًا ﴾ [التحريم: 5]، لماذا لم ترد الواو بين الصفات الست الأولى، ووردت فقط بين ثيبات وأبكارًا؟
ج 418: لأنهما صفتان متنافيتان، فالواو هنا للعطف وتفيد أيضًا التنويع وإفادة المغايرة؛ [تفسير أبي السعود].
غافر الذنب وقابل التوب:
س 419: قال تعالى: ﴿ غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ﴾ [غافر: 3]، لماذا جاءت الواو بين الوصفين الأوَّلين ولم تأتِ بعدهما؟
ج 419: توسيط الواو بين الأوَّلين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين؛ إذ ربما يتوهم الاتحاد أو تغاير موقع الفعلين؛ لأن الغفر هو الستر مع بقاء الذنب، وذلك لمن لم يتب فإنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ [تفسير أبي السعود 7/ 265].
أصحاب الأيكة، مدين:
س 420: قال تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ﴾ [الشعراء: 176، 177]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: 85]، لماذا لم يذكر الأخوة بعد الآية الأولى، وذكرها في الثانية؟
ج 420: يقول الإمام المفسر ابن كثير: لأنه وصفهم بعبارة الأيكة، فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا. ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم. وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة؛ [قصص الأنبياء لابن كثير].
يخلق ما يشاء... يفعل ما يشاء:
س 421: قال تعالى في خلق عيسى ابن مريم: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: 47]، وقال سبحانه في قصة زكريا: ﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: 40].
والسؤال لماذا قال تعالى في شأن عيسى: ﴿ يَخْلُقُ ﴾ وفي شأن زكريا: ﴿ يَفْعَلُ ﴾ وهو الشيخ الكبير وامرأته عاقر؟
ج 421: لأن أمر عيسى عليه السلام أعجب وأغرب؛ حيث يأتي الولد من غير زوج، فناسبه ذكر الخلق، وفي شأن زكريا حيث هو أب كبير والأم عقيم فناسبه ذكر الفعل، والقدرة وهذا من أسرار القرآن؛ [مختصر تفسير الطبري 1/ 105].
من ترك الحج وهو قادر:
س 422: قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]، والسؤال: لماذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ بدل "ومن لم يحج"؟
ج 422: قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ بدل "ومن لم يحج" للتنبيه على أن من ترك الحج وهو قادر مستطيع له، فقد سلك طريق الكافرين؛ [مختصر تفسير الطبري].
قدَّم الجبال على الطير:
س 423: قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾[الأنبياء: 79]، لماذا قدَّم الجبال على الطير؟
ج 423: قال الزمخشري: قدم الجبال على الطير؛ لأنَّ تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدلُّ على القدرة، وأدخل في الإعجاز، والطير حيوان ناطق. قال النحاس: وليس مراد الزمخشري: ناطق ما يراد به في حد الإنسان؛ [البرهان للزركشي 3/ 273].
لعب ولهو:
س 424: قال تعالى: ﴿ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ [الأنعام: 32]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ [محمد: 36]، والسؤال: لماذا قدَّم اللعب على اللهو في الآيات؟
ج 424: لأن اللعب زمان الصبا، واللهو زمان الشباب، وزمان الصبا متقدِّم على زمان اللهو؛ [البرهان للزركشي 1/ 121].
على ظهورهم:
س 425: قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: 31]، لماذا جعل الفاصلة الخاتمة... يَزِرُونَ؟ ولماذا قال: ﴿ عَلى ظُهُورِهِمْ ﴾ ولم يقل: على رءوسهم؟
ج 425: جعل الفاصلة ﴿ يَزِرُونَ ﴾ لجناس ﴿ أَوْزارَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ عَلى ظُهُورِهِمْ ﴾ ولم يقل: على رءوسهم؛ لأنَّ الظهر أقوى للحمل؛ فأشار إلى ثقل الأوزار؛ [البرهان للزركشي 1/ 94].
آية أفردت بالتأليف لبلاغتها:
س 426: قيل عن الآية: أمر فيها ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمَّى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقصَّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفَّت الأقلام، وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف.
وفي العجائب للكرماني: أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. فما هذه الآية الكريمة؟
ج 426: قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: 44]؛ [الإتقان للسيوطي 2/ 71].
جميع ما أخرجه من الأرض في آية:
س 427: آية كريمة من آيات القرآن الكريم مكونة من أربع كلمات دلَّت على جميع ما أخرجه سبحانه وتعالى من الأرض قوتًا ومتاعًا للأنام، من العشب، والشجر، والحب، والثمر، والعصف، والحطب، واللباس، والنار، والملح؛ لأن النار من العيدان، والملح من الماء، فما هي الآية؟
ج 427: قوله تعالى: ﴿ أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها ﴾ [النازعات: 31].
قدرة الله:
س 428: آية كريمة من آيات القرآن الكريم دلّت على قدرة الله ولطفه ووحدانيته؛ لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والتربة، لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم والروائح، ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد، ولكنه صنع اللطيف الخبير. فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 428: قوله تعالى: ﴿ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ﴾ [الرعد: 4].
يتربَّصْن بأنفسهن:
س 429: قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]، وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] قيَّد الله التربُّص في هذه الآية بذكر الأنفس بقوله: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ ولم يذكره في الآية الأولى ﴿ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾، فما هي الحكمة؟
ج 429: إنَّ في ذكر الأنفس تهييجًا لهن على التربُّص وزيادة بعث لهن على قمع نفوسهن عن هواها، وحملها على الانتظار؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأراد الله تعالى أن يقمعن أنفسهن، ويغالبن الهوى بامتثال أمر الله لهن بالتربُّص، والمخاطب في الآية الأولى الرجال، فلم يوجد ذلك الداعي إلى التقييد، فتدبر ذلك السر الدقيق؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 325].
المولود له:
س 430: قال تعالى: ﴿ وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، والسؤال: لم قيل: ﴿ الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ دون الوالد؟
ج 430: قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت: لم قيل ﴿ الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأن الأولاد للآباء؛ ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 351].
بولدها... بولده:
س 431: قال تعالى: ﴿ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233]، لم أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين بِوَلَدِها، وبِوَلَدِهِ؟
ج 431: أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين ﴿ والِدَةٌ بِوَلَدِها ومَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق، فالولد ليس أجنبيًّا عن الوالدين، هذه أمه، وذاك أبوه، فمن حقهما أن يشفقا عليه، ولا تكون العداوة بينهما سببًا للإضرار بالولد؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 351].
الخَبَر والخُبْر:
س 432: قال تعالى: ﴿ إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نارًا سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ ﴾ [النمل: 7]، وقال سبحانه: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ [الكهف: 68]، والسؤال: ما الفرق بين الخَبر بالفتح والخُبر بالضم؟
ج 432: الخَبَر: هو العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر؛ يعني أنه إذا كان يتعلق العلم بالأخبار الظاهرة، والأشياء الظاهرة، والأمور الظاهرة، فهو الخبر.
أما الخُبْر: فهو المعرفة ببواطن الأمر؛ يعني إذا كان يتعلق العلم بالأمور الباطنة، وخفايا الأشياء وأسرارها ولطائفها وألغازها، فهو الخُبر.
اسطاعوا واستطاعوا:
س 433: قال تعالى: ﴿ فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ [الكهف: 97]، ما هي الحكمة من حذف التاء من الفعل في الجملة الأولى مع أنها أثبتت في الفعل نفسه في الجملة الثانية؟
ج 433: إن حذف التاء في الجملة الأولى للتخفيف؛ ولذلك يمكن أن نسميها تاء الخفَّة، ووجه الخفة أنَّ الجملة أخبرت عن عجزهم عن تسلُّق السّد، وهذا التسلق يحتاج إلى سرعة المتسلق ومهارته ورشاقته أولًا؛ ولذلك غالبًا ما يعجز البدين عن التسلق؛ لأنه يحتاج إلى خفة، ليتسلق بسرعة؛ ولذلك حذفت التاء من الفعل تسهيلًا وتخفيفًا.
أما الفعل الثاني: ﴿ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ فإنَّ التاء بقيت فيه؛ لأنَّ هذا هو الأنسب للسياق، والمتفق مع الجو العام، وذلك أنَّ نقب السّد وهدمه يحتاج إلى جهد ومشقة وثقل ووقت، يحتاج إلى أدوات للحفر والنقض، بقيت التاء للثقل، لتساعد في رسم جو الثقل والجهد في نقض السد.
واو الثمانية:
س 434: قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [الكهف: 22] في هذه الآية وردت الواو في قوله: ﴿ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ ولم ترد في الموضعين قبلها، فلماذا؟
ج 434: يقول المفسرون: وهذه الواو التي آذنت بأنَّ الذين قالوا: "سبعة وثامنهم كلبهم" هم على الصواب، والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: ﴿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾، وأتبع الثالث قوله: ﴿ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾، وقال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العدة؛ أي: لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها. وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات.
وقال ابن جرير عن ابن عباس: ﴿ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ قال: أنا من القليل كانوا سبعة من هذه النصوص نستدل على أنَّ الواو جاءت لبيان القول الحق وللتفريق بينه وبين الباطل الذي هو رجم بالغيب؛ [تفسير الكشاف وتفسير أبي السعود].
واستوى:
س 435: قال الله تعالى في سورة القصص عن سيدنا موسى عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾. وقال في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ بدون كلمة ﴿ وَاسْتَوى ﴾، فلماذا ذكرها عند ذكر موسى ولم يذكرها عند ذكر يوسف؟
ج 435: السبب كما جاء في كتب التفاسير أنه سبحانه لم يذكر كلمة ﴿ وَاسْتَوى ﴾ عند ذكر يوسف عليه السلام؛ لأنه أوحي إليه في صباه بخلاف سيدنا موسى عليه السلام، فكان إثباتها في الآية الأولى وحذفها من الآية الثانية الخاصة بسيدنا يوسف لسبب وهذا في غاية الدقة؛ [مجلة الجندي المسلم 38/ 85].
الأسلوب الحكيم في الدعوة:
س 436: قال تعالى بلسان مؤمن آل فرعون: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾، والسؤال: لمَ نكَّر رَجُلًا؟
ج 436: ليوهمهم أنه لا يعرفه، فقد استدرجهم الرجل المؤمن بطريق النصح والملاطفة، فلم يقل لهم: أتقتلون نبيّ الله؟ أو أتقتلون رجلًا مؤمنًا؟ [مختصر تفسير الطبري].
تقديم الكذب لحكمة:
س 437: قال تعالى بلسان مؤمن آل فرعون: ﴿ وَإِنْ يَكُ كاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾، والسؤال: لم قدَّم الكذب في خطابه، وجاء بصيغة تدلُّ على الشك؟
ج 437: وذلك مراعاة لشعورهم، لئلا يعتقدوا أنه متعصب له؛ [مختصر تفسير الطبري].
التقية:
س 438: قال تعالى بلسان مؤمن آل فرعون: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾، لماذا ختم حديثه بذلك وقد كان يتحدث قبلها عن موسى؟
ج 438: ختم حديثه بما يفهم منه أنه ليس بمصدق له، وفيه تعريض بفرعون دقيق، بكذبه وطغيانه، وهذا من أسرار إعجاز القرآن؛ [مختصر تفسير الطبري].
إيجاز وإعجاز:
س 439: قال النحاس عن بعض آية: هذا من معجز ما جاء في القرآن، مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه، والمعنى: إن خفت من قوم بينك وبينهم عهد خيانة، فانبذ إليهم العهد؛ أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد فيكون ذلك خيانة وغدرًا، فما هي الآية الكريمة؟
ج 439: قوله تعالى: ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ﴾ [الأنفال: 58]؛ [مختصر تفسير الطبري].
المباشرة الزوجية في القرآن:
س 440: كنَّى الله تعالى عن الجماع بكنايات لطيفة، ليُعلِّم الأمة الأدب الرفيع، وليتخلقوا بأخلاق القرآن، والكناية إنما تكون فيما لا يحسن التصريح به. فما هذه الكنايات؟
ج 440:
1- الحرث: ﴿ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223].
2- السر: ﴿ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ [البقرة: 235].
3- اللباس: ﴿ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187].
4- الملامسة: ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ﴾ [النساء: 43].
5 - المماسة: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] [البقرة: 237].
6- الرفث: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187].
7- الغشيان: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾ [الأعراف: 189].
8- المباشرة: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ﴾ [البقرة: 187].
9- الإفضاء: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 21].
10- الاقتراب: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].
11- الدخول: ﴿ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23].
12- الإتيان: ﴿ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222].
13- المراودة: ﴿ وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ ﴾ [يوسف: 23].
14- الطمث: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: 56].
15- الهجر: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ﴾ [النساء: 34].
وجزاء سيئة سيئة مثلها:
س 441: قال تعالى: ﴿ وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ﴾ [الشورى: 40]، ورد لفظ سيئة مرتين في الآية بلفظ واحد ومعنيين مختلفين، فما هما؟
ج 441: سيئة الأولى معصية، والثانية عدل؛ لأنها جزاء على المعصية، ويسمى هذا عند علماء البلاغة بالمشاكلة، وهي الاتفاق باللفظ دون المعنى؛ [مختصر تفسير الطبري 1/ 14].
الظلمات والنور:
س 442: قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام: 1]، لماذا أفرد النور وجمع الظلمات؟
ج 442: يقول ابن القيم- رحمه الله-: إنَّ طريق الحق واحد؛ إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعِّبة متعددة؛ فإنها لا ترجع إلى شيء موجود، ولا غاية لها يوصل إليها؛ بل هي بمنزلة بنيات الطريق، وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود، فهي وإن تنوَّعت فأصلها طريق واحد. ولما كانت الظلمة بمنزلة طريق الباطل، والنور بمنزلة طريق الحق، أفرد النور وجمع الظلمات، وهذا من إعجاز القرآن؛ [بدائع الفوائد]. -
الترغيب في الزواج:
س 279: رغَّب الإسلام في الزواج، ودلَّ على ذلك آيات قرآنية كريمة، فما هي؟
ج 279: 1 - قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيرًا وَنِساءً ﴾ [النساء: 1]. 2 - وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها ﴾ [الأعراف: 189]. 3 - وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: 38]. 4 - وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ﴾ [النحل: 72]. 5 - وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]. 6 - وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجًا ﴾ [فاطر: 11]. 7 - وقوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها ﴾ [الزمر: 6].
8 - وقوله تعالى: ﴿ فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا ﴾ [الشورى: 11].
معاملة الزوجة:
س 280: أوصى القرآن الكريم بمعاملة الزوجة والإحسان إليها، وملاطفتها ومؤانستها، وتطييب القول لها بكلمتين اثنتين في إحدى آيات القرآن الكريم، فما هي الآية الكريمة؟
ج 280: قوله تعالى: ﴿ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].
الزواج غنى:
س 281: يلفت الإسلام نظر الرجل إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلًا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرًا على التغلب على أسباب الفقر، فما الآية الكريمة التي تضمنت هذا المعنى؟
ج 281: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32].
الذرية الصالحة:
س 282: من أول أهداف الأسرة في القرآن الكريم: الذرية الصالحة التي تكون قرة أعين للأبوين، ما الآيات الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 282: 1 - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: 72]. 2 - وقوله تعالى مخبرًا عن عباد الرحمن: ﴿ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ﴾ [الفرقان: 74]. 3 - وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: 100، 101]. 4 - وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [مريم: 5، 6].
الزواج آية من آيات الله:
س 283: الزواج هو أساس تكوين الأسرة، فهو يربط بين رجل وامرأة رباطًا شرعيًّا وثيق العرى، مكين البنيان، مؤسسًا على تقوى من الله ورضوان، وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آية من آيات الله، مثل خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان من تراب، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك والتي أشارت إلى الدعائم الثلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية؟
ج 283: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
الزواج ميثاق غليظ:
س 284: سمَّى القرآن الكريم الارتباط بين الزوجين مِيثاقًا غَلِيظًا كما ورد في إحدى سور القرآن، فما الآيات التي ورد فيها ذلك؟
ج 284: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].
الزواج سكن واطمئنان:
س 285: أشارت آية كريمة إلى أن الزواج هو أحسن وضع طبيعي، وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلُّع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحلَّ الله، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 285: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
الصفات المرغوبة في الزوجة:
س 286: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوجة؛ وهي: طاعة الله، وطاعة زوجها، وحفظ نفسها في غيبة زوجها، وحفظ ماله عن التبذير، وذلك بحفظ الله لها، فما هي الآية الكريمة التي تعد مفتاح الخير والسعادة للزوجة في الدنيا والآخرة؟
ج 286: قوله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34].
الصفات المرغوبة في الزوج:
س 287: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوج، وقد جاءت الآية على لسان إحدى ابنتي شعيب وهي البنت التي تزوَّجها سيدنا موسى عليه السلام، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 287: قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26]، والصفتان المرغوبتان في الزوج هما: القوة والأمانة.
مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة:
س 288: في آية من آيات القرآن الكريم وردت مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة، وهي المؤهلات الأخلاقية التي ارتضاها الله تعالى لها، فما الآية الكريمة؟
ج 288: قوله تعالى: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: 5].
الخير فيما اختاره الله تعالى:
س 289: يكره الرجل المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خيرٌ كثيرٌ لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها شرٌّ كثير لا يعرفه، فلا ينبغي أن يجعل المعيار هواه؛ بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه، وفي كتاب الله عز وجل آية كريمة تشير إلى هذا المعنى، فما هي؟
ج 289: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
تحريم نكاح المشركة والمشرك:
س 290: حرَّم الله تعالى نكاح المشركة والمشرك، فالمسلم لا يحل له نكاح المشركة، والمسلمة لا يحل لها نكاح المشرك، ما الآية الدالة على ذلك في كتاب الله عز وجل؟
ج 290: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: 221]، والمشركات هن الوثنيات اللاتي لا دين لهنَّ، ولا يدخل في الآية نساء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى أحل نكاحهن.
تفسير الدرجة:
س 291: ما تفسير الدرجة في قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]؟
ج 291: قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أنَّ الله تعالى ذكره، قال: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ عقب قوله: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]... ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن بعض ما أوجب الله لهم عليهنَّ.
وعلق على قول الطبري الأستاذ محمود شاكر محقق التفسير قائلًا: ولم يكتب الطبري ما كتب على سبيل الموعظة؛ بل كتب بالبرهان والحجة الملزمة، واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة، ففيها بيان تعادل حقوق الرجل على المرأة، وحقوق المرأة على الرجل، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة، لا ينال المرء نبلها إلا بالعزم والتسامي، وهي أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته.
هذه الجملة حثٌّ وندب للرجال على السموِّ إلى الفضل، لا خبرًا عن فضل قد جعله الله مكتوبًا له، أحسنوا فيما أمرهم به أم أساءوا؛ [مجلة النور 157/ 37].
الزواج من زوجة الابن المتبنَّى:
س 292: ما الدليل من كتاب الله عز وجل على جواز نكاح زوجة الابن المتبنَّى إذا طَلَّقها وفارقها؟
ج 292: قوله تعالى: ﴿ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: 37].
جواز المغالاة في المهور:
س 293: المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية، وليس له قدر محدد؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، فتركت الشريعة التحديد ليعطى كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حدَّ لأكثر المهر إشارة إلى آية كريمة في كتاب الله تعالى، فما هي الآية؟
ج 293: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]، قال العلامة القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأنَّ الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وذكر قصة عمر وفيها قوله: أصابت امرأة وأخطأ عمر؛ [آيات الأحكام للصابوني].
الحقوق الزوجية:
س 294: للزوجة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، مثل ما عليها من الطاعة لزوجها. ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي الآية؟
ج 294: قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].
العفاف لمن لم يملك نفقة الزواج:
س 295: في آية كريمة من آيات القرآن الكريم أمرنا الله تعالى أن نلزم العفاف، وأن نحفظ الفروج إن لم نقدر على الزواج، فما هي الآية؟
ج 295: قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33].
القرآن يحث المرأة على التعلُّم:
س 296: حثَّ القرآن الكريم المرأة على التعلم والتعليم في إحدى الآيات الكريمة، فما هي هذه الآية؟
ج 296: قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: 34].
المهر في كتاب الله تعالى:
س 297: يقول الطبري عن المهر في تفسيره: اعطوا النساء مهورهنَّ عطية واجبة وفريضة لازمة، فإن طابت لكم أنفسهنَّ بشيء من المهر فكلوه هنيئًا مريئًا، وقد ذكر المهر في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة، فما هي؟
ج 297: 1 - قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].
2 - وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21]. 3 - وقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: 24]. 4 - وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 25]. 5 - وقوله تعالى: ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ﴾ [المائدة: 5]. 6 - وقوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 50]. 7 - وقوله تعالى: ﴿ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10].
المحرمات من النساء:
س 298: آيتان كريمتان من آيات القرآن الكريم جمعتا المحرَّمات من النساء تحريمًا مؤبدًا بسبب النسب والمصاهرة والرضاعة، فما الآيتان؟
ج 298: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [النساء: 22، 23].
تحريم الجمع بين الأختين:
س 299: حرَّم الإسلام الجمع بين الأختين في آن واحد، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
ج 299: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].
الإنفاق على الزوجة والأولاد:
س 300: فرض الله تعالى على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده، وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى، فما الآيات؟
ج 300: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ﴾ [البقرة: 233]، وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 6، 7].
مدة الحمل الشرعي:
س 301: كم هي مدة الحمل الشرعي؟
ج 301: أجمع الفقهاء على أنَّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر.
قال ابن العربي في تفسيره: روي أنَّ امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها، فقال ابن عباس لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم، قال الله عز وجل: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، فالحمل ستة أشهر، والفصال أربع وعشرون شهرًا، فخلَّى عثمان- رضي الله عنه- سبيلها. وفي رواية أن: عليَّ بن أبي طالب قال له ذلك.
قال ابن العربي: وهو استنباط بديع؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 245].
المحرمات من النساء بسبب المصاهرة:
س 302: من هن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، مع ذكر الدليل من كتاب الله عز وجل؟
ج 302: 1 - زوجة الأب لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ﴾ [النساء: 22]. 2 - زوجة الابن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [النساء: 23]. 3 - أم الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]. 4 - بنت الزوجة إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23].
قوامة الرجل:
س 303: للرجال درجة القوامة على نسائهم بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير، وخصهم به من الكسب والإنفاق، في كتاب الله تعالى آية كريمة بهذا الأمر، فما هي؟
ج 303: قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].
نكاح نساء أهل الكتاب:
س 304: أحلَّ الله تعالى نكاح العفائف الحرائر من نساء أهل الكتاب الذين آمنوا بما في التوراة والإنجيل، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 304: قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ ﴾ [المائدة: 5].
المباشرة، متى وأين؟
س 305: بين الله تعالى في كتابه العزيز متى وكيف وأين يأتي الرجل أهله، وهو مكان الحرث والذرية، في قبلها لا في دبرها، وهي طاهرة من الحيض، كيف شاء من وجوه المأتى، فما الآيات التي أشارت إلى هذا الأمر؟
ج 305: قوله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: 222، 223].
أخذ رأي المرأة في زواجها:
س 306: يقول الطبري في معنى الآية: إذا طلقتم النساء، وانقضت عدتهن، فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضى الأزواج والنساء، وأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بنكاح جديد، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟
ج 306: قوله تعالى: ﴿ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 234].
المرأة أقل عقلانية من الرجل:
س 307: آية كريمة من آيات القرآن الكريم تقول: إن المرأة أقل ضبطًا وعقلانية من الرجل وأقل تذكرًا منه للأمور، وأنَّ عاطفتها تنسيها الأشياء، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 307: قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ﴾ [البقرة: 282].
غير أولي الإربة من الرجال:
س 308: قال تعالى: ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ﴾ [النور: 31] هؤلاء ممن استثناهم الله تعالى وجعلهم كالمحارم تمامًا؛ كالأخ والزوج والأب، وجوَّز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها من غير تبرُّج، فما هي صفة هؤلاء الرجال؟
ج 308: هم كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله، ولا همة لهم إلى النساء، ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله.
وفي تفسير أبي السعود: هم البُلْه الذين يتتبعون الناس لفضل طعامهم، ولا يعرفون شيئًا من أمور النساء؛ [تفسير ابن كثير].
الوالدة حقها أكبر:
س 309: وجب الإحسان للوالدين معًا؛ لكنَّ الوالدة هي التي تعاني من آلام الحمل والوضع ما لا يعانيه الآباء، وقد تخص الأمهات بالإحسان والبر أكثر من الآباء، وفي القرآن الكريم آيتان كريمتان نوهتا بخصوصية الأم وفضلها، فما هما؟
ج 309: 1 - قوله تعالى: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]. 2 - وقوله تعالى: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ [الأحقاف: 15].
العروب:
س 310: قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكارًا* عُرُبًا أَتْرابًا ﴾ [الواقعة: 35 - 37]، ما معنى قوله تعالى: ﴿ عُرُبًا ﴾؟
ج 310: ﴿ عُرُبًا ﴾؛ أي: عاشقات لأزواجهنَّ، جمع عروب؛ وهي المحبة العاشقة لزوجها.
الترائب:
س 311: قال تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ﴾ [الطارق: 5 - 7]، ما هي الترائب؟
ج 311: الترائب: عظام الصدر، جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل، قال ابن كثير: ترائب المرأة يعني صدرها، وهو قول ابن عباس ومجاهد.
الإنفاق:
س 312: الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة، إلَّا في آية واحدة فإن المراد به المهر، وهو صدقة في الأصل تصدَّق الله بها على النساء، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 312: قوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: 11]؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 188].
شاهدا عدل:
س 313: روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
ج 313: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
الظِّهار:
س 314: الظِّهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْر أمي. والظِّهار كان طلاقًا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظِّهار محرمًا للمرأة حتى يكفِّر زوجها.
وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرَّمت الظِّهار؟
ج 314: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: 2].
كفارة الظهار:
س 315: ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟
ج 315: الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 3، 4].
الإيلاء:
س 316: الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسَّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدًّا لهذا العمل الضار، فوقَّته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عَلَّه يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلَّا طلق، ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟
ج 316: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 226، 227].
حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع:
س 317: قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنَّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها؛ لتفتدي نفسها منه، فما هي هذه الآية الكريمة؟
ج 317: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
الرغبة في التزوج بالمعتدة:
س 318: يقول الطبري في تفسير الآية: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على نكاحهن، فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟
ج 318: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، وهذه التي تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثًا، فيجوز التعريض لها دون التصريح.
الإصلاح بين الزوجين:
س 319: أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، بإرسال حَكَمَين عدلين، واحد من أقارب الزوج، وواحد من أقارب الزوجة؛ لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 319: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35].
الصلح خير:
س 320: إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغض لها لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضًا بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 320: قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128].
العدل بين النساء:
س 321: لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى، ولو كنتم حريصين على ذلك، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟
ج 321: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129]، أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى؛ [مختصر تفسير الطبري].
علاج النشوز:
س 322: أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءت عِشرة زوجها، وركبت رأسها، وطغت وبغت، فما الآية الكريمة التي تدل على ذلك؟
ج 322: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]. وهذا العلاج خير من طلاقها؛ لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنًا وجميلًا؛ [مختصر تفسير الطبري].
الميل المنهي عنه:
س 323: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة، فما الآية الكريمة الدالَّة على ذلك؟
ج 323: قوله تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129].
لا يجوز الإضرار بالزوجة:
س 324: لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمَّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يُسرِّحها بإحسان، وهذا التكليف نصَّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟
ج 324:
1 - قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ [البقرة: 229].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231].
3 - وقوله تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 2].
الخمر والجيوب:
س 325: قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، ما هي الخمر؟ وما هي الجيوب؟
ج 325: قال ابن كثير: الخُمُر: جمع خمار وهو ما يُغطى به الرأس.
والجيوب؛ أي: النحور والصدور.
فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي.
والمراد بالآية كما رواه ابن أبي حاتم: أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن؛ لئلا يُرى منها شيء؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 145].
ملك اليمين:
س 326: قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: 50].
ما المراد بملك اليمين؟
ج 326: أي: أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة؛ كصفية وجويرية؛ [تفسير الطبري].
المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب:
س 327: قال الإمام الواحدي في كتابه البسيط: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبت محرمًا عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟
ج 327: قوله تعالى: ﴿يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: 32].
النهي عن التبتُّل للقادر على الزواج:
س 328: نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟
ج 328: قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87].
آيات الحجاب:
س 329: الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين، وهو واجب شرعي محتم، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترًا للزينة والثياب ولجميع البدن، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقًا عليها، وإنما تشريفًا لها وتكريمًا وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد، وانتشار الفاحشة، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟
ج 329:
1 - قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى﴾ [الأحزاب: 33].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾ [الأحزاب: 53].
3 - وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
4 - وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31].
قدسية الزواج:
س 330: الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان، وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟
ج 330: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: 7]، وقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].
النساء الصالحات:
س 331: ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، فمَنْ هنَّ؟
ج 331: الصالحات هن: حواء، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمهات المؤمنين: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن، وزوجة سيدنا إبراهيم، وأم وأخت وزوجة سيدنا موسى، وزوجة سيدنا زكريا، وزوجة سيدنا أيوب، وملكة سبأ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة، والواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة.
النساء العاصيات:
س 332: ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هنَّ؟
ج 332: العاصيات هنَّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.
كانت العدَّة حولًا ثم خُفِّفت:
س 333: كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولًا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ﴾ [البقرة: 240] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟
ج 333: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.
وجوب المتعة:
س 334: من عدل الإسلام، إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة تعويضًا لها عمَّا فاتها، وقد أجمع العلماء على أنَّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة، فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟
ج 334: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا﴾ [البقرة: 236].
نفقة المعتدة:
س 335: للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟
ج 335: المعتدة الرجعية: قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، والمعتدة الحامل: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
المطلقة قبل الدخول بها:
س 336: هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.
ج 336: ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].
للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع:
س 337: إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 337: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6].
حرمة عقد النكاح على المعتدة:
س 338: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 338: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلَّت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنَّ العقد فاسد ويجب فسخه؛ لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 377].
المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر:
س 339: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورًا، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 339: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ [البقرة: 237].
طلاق الرجعة:
س 340: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف، فيحسن صحبتها، أو يفارقها ويسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئًا. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟
ج 340: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
لا يجوز خروج المعتدَّة:
س 341: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟
ج 341: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1].
لا يحل استرجاع المهر من المطلقة:
س 342: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرًا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجِماع، فما هي هذه الآية؟
ج 342: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20، 21].
لا يجوز الطلاق في الحيض:
س 343: روى البخاري أن عبدالله بن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».
وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 343: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: 1].
المطلقة ثلاثًا:
س 344: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوَّجها بقصد الإحلال كان زواجه صوريًّا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
ج 344: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾ [البقرة: 230]، والمعنى: فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها، فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد؛ [مختصر تفسير الطبري].
عدة الحامل:
س 345: ما عدَّة الزوجة الحامل إذا طُلِّقت أو توفي عنها زوجها؟
ج 345: عدَّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
عدة المتوفى عنها زوجها:
س 346: ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا؟
ج 346: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنها وهي زوجته.
عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها:
س 347: ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟
ج 347: عليها العدة كما لو كان قد دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.
عدة المطلقة الحائض:
س 348: ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولًا بها ومن ذوات الحيض؟
ج 348: عدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
عدة المطلقة غير الحائض:
س 349: ما عدَّة المطلقة غير الحائض؟
ج 349: إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
كيد النساء:
س 350: جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، مرتين على لسان يوسف عليه السلام، ومرة على لسان العزيز، فما هي الآيات؟
ج 350:
1 - قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: 33].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 50].
3 - وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: 28].
الإسلام حفظ للأنثى كرامتها:
س 351: يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن يتلقى ولادتهنَّ بالعبوس والانقباض، وقد أشارت آية كريمة إلى هذا الأمر، فما هي الآية؟
ج 351: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 58، 59].
المرأة والرجل متساويان في الثواب عن العمل:
س 352: المرأة والرجل متساويان في الأجر والثواب عن العمل، والمنافسة هي العمل والإخلاص فيه لله تعالى، وفي كتاب الله تعالى آيات كريمة أشارت إلى هذه المساواة، فما هي؟
ج 352:
1 - قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124].
3 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
4 - وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].
5 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40].
6 - وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32].
7 - كما أنهما متساويان في العقاب: قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 38].
8 - وقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2].
الذكر والأنثى:
س 353: سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية؛ حيث خلق الله تعالى الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ولا في القيمة والأهمية.
والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مساوٍ لشطر، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 353: قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: 36 - 39].
وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45، 46].
من كتاب جواهر قرآنية سؤال وجواب في القرآن
قاسم عاشور

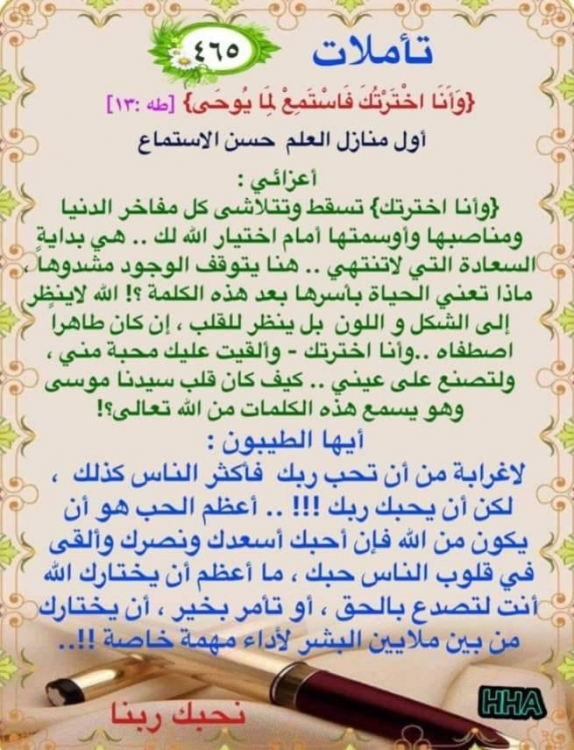

تدبر آية من القرآن
في ساحة القرآن الكريم العامة
قامت بالمشاركة · Report reply
﴿ رحماء بينهم ﴾ المؤمن مهما تكدر صفو علاقته بأخيه ؛ يبقى قلبه رحيما عليه .. متمنيا له الخير .
-بعض الناس لايعرف من التسامح إلا التسامح مع الكافر في حين أنه يمارس التباغض مع أقاربه وجيرانه وأهله (أشداءعلى الكفار رحماء بينهم)
-فهم من الإسلام ﴿ أشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ ﴾ ولم يفهم ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ فلا يقبل من مسلم حسنة ولا يتجاوز له عن خطأ !!
-( رحماء بينهم} {إن تمسسكم حسنة تسؤهم} {وفيكم سماعون لهم) في كل مجتمع مسلم مؤمنون رحماء بينهم ، ومنافقون يتربصون بالمؤمنين ويكيدون لهم !!
(محمد رسول الله) هذه هي الحقيقة الأزلية التي لايزال البعض يجادل ويشكك بها فإن تيقنوا بها فهم مفلحون وإن صدّوا عنها فلا حسرة عليهم .
رقة قلوبنا على بعضنا تعلمناها من مدرسة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم .. وقد نزلت هذه الآية بعد رفض قريش كتابة (محمد رسول الله) في ورقة الصلح ، فمحاها النبي من الورقة وأثبتها الله في كتابه تُتلى إلى يوم القيامة .