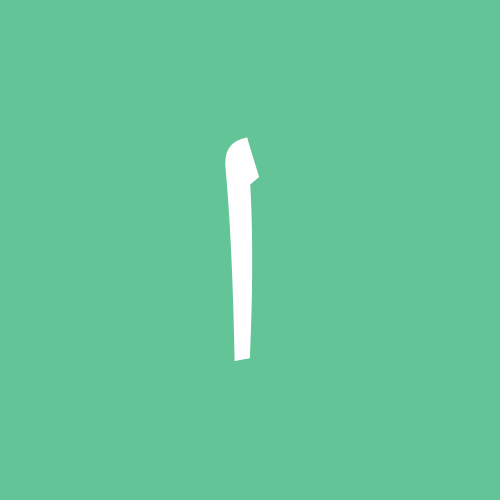-
المتواجدات الآن 0 عضوات, 0 مجهول, 60 زوار (القائمه الكامله)
لاتوجد عضوات مسجلات متواجدات الآن
-
العضوات المتواجدات اليوم
3 عضوات تواجدن خلال ال 24 ساعة الماضية
أكثر عدد لتواجد العضوات كان 13، وتحقق
إعلانات
- تنبيه بخصوص الصور الرسومية + وضع عناوين البريد
- يُمنع وضع الأناشيد المصورة "الفيديو كليب"
- فتح باب التسجيل في مشروع "أنوار الإيمان"
- القصص المكررة
- إيقاف الرسائل الخاصة نهائيًا [مع إتاحة مراسلة المشرفات]
- تنبيه بخصوص المواضيع المثيرة بالساحة
- الأمانة في النقل، هل تراعينها؟
- ضوابط و قوانين المشاركة في المنتدى
- تنبيه بخصوص الأسئلة والاستشارات
- قرار بخصوص مواضيع الدردشة
- يُمنع نشر روابط اليوتيوب
-
أحدث المشاركات
-
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
سأل رجل مهموم حكيماً فقال: أيها الحكيم، لقد أتيتك وما لي حيلة فيما أنا فيه من الهم؟ فقال الحكيم: سأسألك سؤالين، وأريد إجابتها. فقال الرجل: اسأل. فقال الحكيم: أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: أمر لم تأت به، ولن يذهب معك.. الأجدر ألا يأخذ منك كل هذا الهم، فكن صبوراً على أمر الدنيا، وليكن نظر إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض يكن لك ما أردت. إن المؤمن بين أمرين: يُسر وعُسر، وكلاهما «نعمة» لو أيقن؛ ففي اليُسر: يكون الشكر، (وَسَيَجزي اللَّهُ الشَّاكِرينَ) [آل عمران: 144]. و في العُسر : يكون الصّبر، (إنّمَا يُوَفي الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيْر حِسَاب) [الزمر: 10]. سئل حكيم : كيف تعرفُ ودَّ أخيك؟ فقال: يحملُ همّي..ويسألُ عنّي.. يغفرُ زلّتي..ويذكّرني بربّي.. فقيل له : وكيف تكافئه؟ قال : أدعو له بظهر الغيب . سئل حكيم من تعزّ من الناس ؟ قال : من أخلاقه كريمة ، ومجالسته غنيمة ، ونيته سليمة ، ومفارقته أليمة ، كالمسك كلما مر عليه الزمن زاده قيمة. سُئل حكيم من هو الذكي؟ فَقال : هو الفطِن المُتغافِل الذي يَرى الأخطاء ولا يراها , ويَرى حاسِده ولا يهتم , ويرى عَدوه ولا يلتَفت , ويرى الفِتنة فلا يَنظر , ومبتعد عن القِيل والقَال , فيبيت وقلبهُ نقي ونفسهُ راضية فلا تعب ولا فِكر ولا كَدر ولا همّ . بقلبك شيء على أحد؟! ردد : اللهم اجعلني من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس... سُئِل حكيم ما الصَّعب ؟ وما القسوة ؟ وما قمة الاحتِياج ؟ فقـال : الصَّعب في الدنيا أن تكسبَ شخصاً واحداً وتخسر الكلَّ لأجله والقسوة أن يخونك هذا الشخص وتتذكر أنك تركت الكلَّ لأجله ،وفي قمة احتياجك لا تجد هذا الشخص لكنك تجد حولك من تركتهم من أجله ، فلا تُضَحِّ كثيراً . -
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
الشيخ خالد عطية برواية ورش عن نافع ربع ( ان قارون ،كان من قوم موسى) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ كَانَ قَارُونُ مِنْ قَوْمِ مُوسَى الْإِسْرَائِيلِيِّينَ، فَتَكَبَّرَ عَلَى قَوْمِهِ وَاحْتَقَرَهُمْ بِسَبَبِ غِنَاهُ، وَقَدْ آتَاهُ اللَّهُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً مُدَّخَرَةً، لَا يَسْتَطِيعُ حَمْلَ مَفَاتِيحِهَا الْجَمَاعَةُ الْأَشِدَّاءُ مِنَ الرِّجَالِ؛ فَهِيَ تُمِيلُهُمْ بِثِقَلِهَا، إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا تَفْرَحْ وَتَبْطَرْ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ الْبَطِرِينَ، وَاطْلُبْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَأَنْفِقْ مِنْهُ فِي الْخَيْرِ، وَلَا تَتْرُكْ حَظَّكَ مِنَ التَّنَعُّمِ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَحْسِنْ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَإِلَى خَلْقِ اللَّهِ، كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فَقَالَ قَارُونُ: إِنَّمَا أُوتِيتُ هَذِهِ الْكُنُوزَ؛ لِأَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ! أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ مَنْ كَانَ أَقْوَى مِنْهُ، وَأَكْثَرَ جَمْعًا لِلْأَمْوَالِ؟! فَخَرَجَ قَارُونُ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي زِينَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ ضِعَافُ الْإِيمَانِ– حِينَ رَأَوْا زِينَةَ قَارُونَ: يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ الَّذِي أُوتِيَهُ قَارُونُ؛ إِنَّهُ لَذُو نَصِيبٍ وَافِرٍ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا! فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ: وَيْلَكُمْ، نَعِيمُ الْجَنَّةِ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا: خَيْرٌ مِنْ مُلْكِ قَارُونَ، وَلَا يُوَفَّقُ لِذَلِكَ إِلَّا الصَّابِرُونَ. ثُمَّ خَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَارُونَ وَبِدَارِهِ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ، فَلَمْ يَكُنْ لِقَارُونَ جَمَاعَةٌ يَمْنَعُونَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ بِنَفْسِهِ أَوْ قُوَّتِهِ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا لِقَارُونَ يَقُولُونَ: وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يُوَسِّعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُنَّا قَدْ طَغَيْنَا مِثْلَ طُغْيَانِ قَارُونَ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِنَا كَمَا خَسَفَ بِهِ، وَيْكَأَنَّهُ لَا يَفُوزُ الْكَافِرُونَ. ثُمَّ يُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى سُنَّةً مِنْ سُنَنِهِ الَّتِي لَا تَتَخَلَّفُ، فَيَقُولُ: تِلْكَ الدَّارُ – وَهِيَ الْجَنَّةُ – نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ تَكَبُّرًا فِي الْأَرْضِ، وَلَا إِفْسَادًا فِيهَا بِالْمَعَاصِي، وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ- فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ- لِلْمُتَّقِينَ. عِبَادَ اللَّهِ.. وَمِنْ أَهَمِّ الْفَوَائِدِ وَالْعِبَرِ فِي قِصَّةِ قَارُونَ[1]: 1- الْقَوْمِيَّةُ لَا تَنْفَعُ أَصْحَابَهَا بِدُونِ إِيمَانٍ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾، وَإِنَّمَا النَّافِعُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَقَارُونُ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى، وَمَعَ ذَلِكَ بَغَى عَلَيْهِمْ[2]. 2- الْغِنَى سَبَبٌ لِلطُّغْيَانِ: لِأَنَّ قَارُونَ بَغَى وَطَغَى بِسَبَبِ مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْمَالِ[3]. 3- الْإِيتَاءُ الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ كَوْنِيًّا، وَشَرْعِيًّا: فَمِثَالُ الْكَوْنِيِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ﴾. وَمِثَالُ الشَّرْعِيِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ [الْإِسْرَاءِ: 2][4]. 4- الْفَرَحُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْفَرَحُ الْمُفْرِطُ: الَّذِي يَجْعَلُ صَاحِبَهُ مُتَعَلِّقًا بِالدُّنْيَا، وَيُنْسِيهِ الْعَمَلَ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ، وَمَتَى كَانَ الْفَرَحُ بِاللَّهِ، وَبِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ، مَقْرُونًا بِالْخَوْفِ وَالْحَذَرِ؛ لَمْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ، وَمَتَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ ضَرَّهُ، وَلَا بُدَّ[5]. 5- الْفَرَحُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ. فَالْمُطْلَقُ: جَاءَ فِي الذَّمِّ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾؛ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ [هُودٍ: 10]. وَالْمُقَيَّدُ نَوْعَانِ: الْأَوَّلُ: مُقَيَّدٌ بِالدُّنْيَا، يُنْسِي صَاحِبَهُ فَضْلَ اللَّهِ وَمِنَّتَهُ، فَهُوَ مَذْمُومٌ أَيْضًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [الْأَنْعَامِ: 44]. وَالثَّانِي: مُقَيَّدٌ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وَالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يُونُسَ: 58]؛ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: 170]. فَهَذَا مِنْ أَعْلَى مَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ[6]. 6- يَجِبُ عَلَى مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، أَوْ عِلْمًا، أَوْ نِعْمَةً مَا؛ أَنْ يُحْسِنَ النِّيَّةَ وَالْقَصْدَ فِي بَذْلِهِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾. وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حِينَ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَشِعَارُ الْمُحْسِنِينَ: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ [الْإِنْسَانِ: 9][7]. 7- يَنْبَغِي لِلدَّاعِي أَنْ يُذَكِّرَ الْمَدْعُوَّ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى: لِأَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ بِالنِّعْمَةِ؛ قَدْ يَخْجَلُ مِنَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِيهِ. فَإِنْ كَانَ مَنْصُوحًا بِطَلَبٍ، تُذْكَرُ الْعِلَّةُ تَرْغِيبًا؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾، وَإِنْ كَانَ مَنْصُوحًا بِنَهْيٍ، فَتُذْكَرُ الْعِلَّةُ تَخْوِيفًا؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾؛ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾[8]. 8- لَا تَجُوزُ نِيَّةُ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾؛ وَإِذَا حُرِّمَتْ نِيَّةُ الْفَسَادِ، فَالْفَسَادُ نَفْسُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى[9]. 9- مَنْ لَمْ يَنْسُبِ الْفَضْلَ لِلَّهِ فِي رِزْقِهِ وَكَسْبِهِ؛ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِقَارُونَ: فِي عَدَمِ اعْتِرَافِهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ؛ لِقَوْلِ قَارُونَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾[10]. 10- النَّهْيُ عَنْ إِضَافَةِ النِّعَمِ إِلَى أَسْبَابِهَا دُونَ الْمُنْعِمِ بِهَا: كَقَوْلِ قَارُونَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّمَرِ: 49]. وَلَا بَأْسَ بِإِضَافَتِهَا إِلَى الْأَسْبَابِ- مَعَ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهَا أَسْبَابًا، وَأَنَّ الْمُنْعِمَ بِهَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِشُكْرِ الْأَسْبَابِ أَيْضًا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لُقْمَانَ: 14][11]. 11- لِيَحْذَرِ الْإِنْسَانُ - كُلَّ الْحَذَرِ - مِنْ طُغْيَانِ "أَنَا"، وَ"لِي"، وَ"عِنْدِي": فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثَّلَاثَةَ ابْتُلِيَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَفِرْعَوْنُ، وَقَارُونُ؛ فَـ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الْأَعْرَافِ: 12] لِإِبْلِيسَ. وَ﴿ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ [الزُّخْرُفِ: 51] لِفِرْعَوْنَ. وَ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾لِقَارُونَ. وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ "أَنَا" فِي قَوْلِ الْعَبْدِ: "أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ، الْمُخْطِئُ، الْمُسْتَغْفِرُ، الْمُعْتَرِفُ، وَنَحْوِهِ". وَ" لِي"، فِي قَوْلِهِ: "لِيَ الذَّنْبُ، وَلِيَ الْجُرْمُ، وَلِيَ الْمَسْكَنَةُ"، وَ"عِنْدِي" فِي قَوْلِهِ: «اغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ)[12]. 12- الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَاقِلِ وَالْجَاهِلِ: أَنَّ الْعَاقِلَ: يَغْبِطُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ، وَنَيْلِ عُلُوِّ الدَّرَجَاتِ. وَالْجَاهِلَ: يَغْبِطُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الشَّهَوَاتِ، وَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى اللَّذَّاتِ الْمُحَرَّمَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى – حَاكِيًا عَنْ قَارُونَ: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾[13]. 13- أَهْلُ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ حَقَائِقَ الْأُمُورِ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ ﴾؛ فَهَذِهِ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَثَوَابُ الْآخِرَةِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْهَا. 14- لَا يُلَقَّى الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، وَجَزَاءَهَا، وَالْحُظُوظَ الْعَظِيمَةَ إِلَّا أَهْلُ الصَّبْرِ:﴿ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾؛ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الْعَنْكَبُوتِ: 58، 59][14]. 15- الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ؛ لِذَا كَانَتْ عُقُوبَةُ قَارُونَ بِالْخَسْفِ: لِأَنَّهُ كَانَ بَاغِيًا عَالِيًا مُتَكَبِّرًا، فَأُخِذَ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ، ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾؛ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْجَزَاءِ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ﴾ [الْعَنْكَبُوتِ: 40]. 16- إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْعُقُوبَةَ بِأَحَدٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ نَاصِرٌ دُونَ اللَّهِ: وَلَوْ عَظُمَتْ قُوَّتُهُ، وَكَثُرَ جُنْدُهُ، ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴾. 17- مَنْ أَرَادَ الْعُلُوَّ وَالْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فِي الْآخِرَةِ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، وَفِيهِ: أَنَّ النِّيَّةَ لَهَا أَثَرٌ؛ فَالْإِرَادَةُ بِمَعْنِى النِّيَّةِ[15]. [1] ذُكِرتْ قِصَّةُ قارون في [سورة القصص: 76-83]. [2] انظر: تفسير ابن عثيمين – القصص، (ص341). [3] انظر: المصدر نفسه، (ص340). [4] انظر: تفسير ابن عثيمين – الفاتحة والبقرة، (1/ 185). [5] انظر: مدارج السالكين، (3/ 108)؛ تفسير ابن عاشور، (20/ 178). [6] انظر: مدارج السالكين، (3/ 149). [7] انظر: تفسير ابن عثيمين – القصص، (ص351). [8] انظر: المصدر نفسه، (ص341). [9] انظر: المصدر نفسه، (ص352). [10] انظر: المصدر نفسه، (ص357). [11] انظر: شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام (ص251). [12] زاد المعاد، (2/ 434). [13] انظر: لطائف المعارف، لابن رجب (ص246). [14] انظر: مدارج السالكين، (2/ 153). [15] انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 500)؛ تفسير ابن عثيمين – القصص، (ص371). د. محمود بن أحمد الدوسري الألوكة -
بواسطة أمّ عبد الله · قامت بالمشاركة
جزاك الله خيرا على تذكرتك الطيبة أختي الحبيبة .. -
بواسطة أمّ عبد الله · قامت بالمشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أفقه فهمهم! نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا جزاك الله خيرا على حسن التذكرة يا حبيبة ..
-
-
آخر تحديثات الحالة المزاجية
-
خُـزَامَى تشعر الآن ب الحمدلله
-
**راضية** تشعر الآن ب راضية
-
أم أنيس تشعر الآن ب حزينة
-
حواء أم هالة تشعر الآن ب راضية
-
مناهل ام الخير تشعر الآن ب سعيدة
-
-
إحصائيات الأقسام
-
إجمالي الموضوعات182816
-
إجمالي المشاركات2536866
-
-
إحصائيات العضوات
منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤
< إنّ من أجمل ما تُهدى إليه القلوب في زمن الفتن أن تُذكَّر بالله، وأن تُعادَ إلى أصلها الطاهر الذي خُلِقت لأجله. فالروح لا تستقيم بالغفلة، ولا تسعد بالبعد، ولا تُشفى إلا بالقرب من الله؛ قريبٌ يُجيب، ويعلم، ويرى، ويرحم