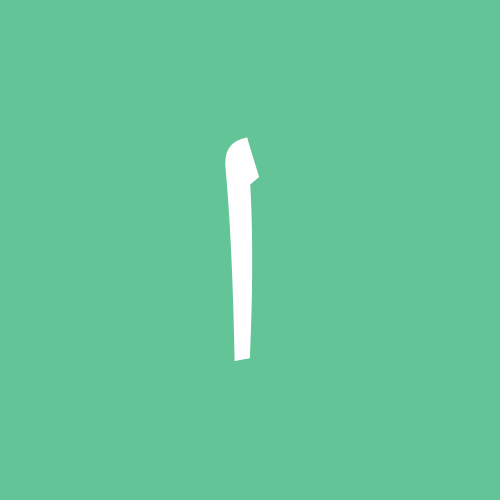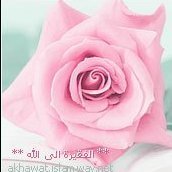المنتديات
-
"أهل القرآن"
-
ساحة القرآن الكريم العامة
مواضيع عامة تتعلق بالقرآن الكريم
- 57256
- مشاركات
-
ساحات تحفيظ القرآن الكريم
ساحات مخصصة لحفظ القرآن الكريم وتسميعه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" [صحيح الترغيب]- 109817
- مشاركات
-
ساحة التجويد
ساحة مُخصصة لتعليم أحكام تجويد القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الصحيح
- 9066
- مشاركات
-
-
القسم العام
-
الإعلانات "نشاطات منتدى أخوات طريق الإسلام"
للإعلان عن مسابقات وحملات المنتدى و نشاطاته المختلفة
 المشرفات:
المشرفات:
 المشرفات,
مساعدات المشرفات
المشرفات,
مساعدات المشرفات
- 284
- مشاركات
-
- 180512
- مشاركات
-
شموخٌ رغم الجراح
من رحم المعاناة يخرج جيل النصر، منتدى يعتني بشؤون أمتنا الإسلامية، وأخبار إخواننا حول العالم.
 المشرفات:
المشرفات:
 مُقصرة دومًا
مُقصرة دومًا
- 56695
- مشاركات
-

- المقاومة جهاد
- بواسطة أمّ عبد الله
-
همزة الوصل
ترحيب.. تهاني.. تعازي.. مواساة..
- 259983
- مشاركات
-
شكاوى واقتراحات
لطرح شكاوى وملاحظات على المنتدى، ولطرح اقتراحات لتطويره
- 23500
- مشاركات
-
-
فتياتنا الجميلات
-
أحلى صحبة
نقاشات، فوائد، قضايا تخص الفتيات
- 204494
- مشاركات
-

- ♥♥ زخــات الحب ♥♥
- بواسطة حواء أم هالة
-
- 117096
- مشاركات
-

- صويحباتي
- بواسطة أمّ عبد الله
-
- 136895
- مشاركات
-
- 20372
- مشاركات
-

- مذكرة فتاة مسلمة
- بواسطة مناهل ام الخير
-
-
ميراث الأنبياء
-
قبس من نور النبوة
ساحة مخصصة لطرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و شروحاتها و الفوائد المستقاة منها
 المشرفات:
المشرفات:
 سدرة المُنتهى 87
سدرة المُنتهى 87
- 8238
- مشاركات
-
مجلس طالبات العلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع"
- 32133
- مشاركات
-
- 4160
- مشاركات
-
أحاديث المنتدى الضعيفة والموضوعة والدعوات الخاطئة
يتم نقل مواضيع المنتدى التي تشمل أحاديثَ ضعيفة أو موضوعة، وتلك التي تدعو إلى أمور غير شرعية، إلى هذا القسم
 المشرفات:
المشرفات:
 إشراف ساحة الأحاديث الضعيفة
إشراف ساحة الأحاديث الضعيفة
- 3918
- مشاركات
-
- 25483
- مشاركات
-
- 1677
- مشاركات
-
-
الملتقى الشرعي
-
- 30256
- مشاركات
-
الساحة العقدية والفقهية
لطرح مواضيع العقيدة والفقه؛ خاصة تلك المتعلقة بالمرأة المسلمة.
 المشرفات:
المشرفات:
 أرشيف الفتاوى
أرشيف الفتاوى
- 52993
- مشاركات
-
أرشيف فتاوى المنتدى الشرعية
يتم هنا نقل وتجميع مواضيع المنتدى المحتوية على فتاوى شرعية
 المشرفات:
المشرفات:
 أرشيف الفتاوى
أرشيف الفتاوى
- 19530
- مشاركات
-
- 6678
- مشاركات
-
-
قسم الاستشارات
-
استشارات اجتماعية وإيمانية
لطرح المشاكل الشخصية والأسرية والمتعلقة بالأمور الإيمانية
 المشرفات:
إشراف ساحة الاستشارات
المشرفات:
إشراف ساحة الاستشارات
- 40679
- مشاركات
-
- 47550
- مشاركات
-
-
داعيات إلى الهدى
-
زاد الداعية
لمناقشة أمور الدعوة النسائية؛ من أفكار وأساليب، وعقبات ينبغي التغلب عليها.
 المشرفات:
المشرفات:
 جمانة راجح
جمانة راجح
- 21004
- مشاركات
-

- أهم صفات الداعية
- بواسطة أمّ عبد الله
-
إصدارات ركن أخوات طريق الإسلام الدعوية
إصدراتنا الدعوية من المجلات والمطويات والنشرات، الجاهزة للطباعة والتوزيع.
- 776
- مشاركات
-
-
البيت السعيد
-
بَاْبُڪِ إِلَے اَلْجَنَّۃِ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه." [صحيح ابن ماجه 2970]
 المشرفات:
المشرفات:
 جمانة راجح
جمانة راجح
- 6306
- مشاركات
-
- 97009
- مشاركات
-

- عاشروهن بالمعروف
- بواسطة أمّ عبد الله
-
آمال المستقبل
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" قسم لمناقشة أمور تربية الأبناء
 المشرفات:
~ محبة صحبة الأخيار~
المشرفات:
~ محبة صحبة الأخيار~
- 36838
- مشاركات
-
-
سير وقصص ومواعظ
-
- 31793
- مشاركات
-

- حكاوينا
- بواسطة حواء أم هالة
-
القصص القرآني
"لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثًا يُفترى"
 المشرفات:
المشرفات:
 ** الفقيرة الى الله **
** الفقيرة الى الله **
- 4883
- مشاركات
-
- 16438
- مشاركات
-
سيرة الصحابة والسلف الصالح
ساحة لعرض سير الصحابة رضوان الله عليهم ، وسير سلفنا الصالح الذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.."
 المشرفات:
المشرفات:
 سدرة المُنتهى 87
سدرة المُنتهى 87
- 15479
- مشاركات
-
على طريق التوبة
يقول الله تعالى : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } طه:82.
 المشرفات:
المشرفات:
 أمل الأمّة
أمل الأمّة
- 29721
- مشاركات
-
-
العلم والإيمان
-
العبادة المنسية
"وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ.." عبادة غفل عنها الناس
- 31147
- مشاركات
-
- 12926
- مشاركات
-
-
إن من البيان لسحرًا
-
- 50492
- مشاركات
-

- صفو الاكدار
- بواسطة أسما المشد
-
-
مملكتكِ الجميلة
-
- 41313
- مشاركات
-
منزلكِ الجميل
تصاميم.. لمسات تجميلية.. نصائح.. متعلقة بمنزلكِ
- 33904
- مشاركات
-
الطيّبات
- الأطباق الرئيسية
- قسم الحلويات
- قسم المقبلات
- قسم المعجنات والمخبوزات
- منتدى الصحة والرشاقة
- تطبيقات الطيبات
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ))
[البقرة : 172]- 91746
- مشاركات
-
-
كمبيوتر وتقنيات
-
- 32199
- مشاركات
-
جوالات واتصالات
قسم خاص بما يتعلق بالجوالات من برامج وأجهزة
- 13116
- مشاركات
-
- 34854
- مشاركات
-

- تصميم مواقع
- بواسطة Hannan Ali
-
- 65605
- مشاركات
-
وميضُ ضوء
صور فوتوغرافية ملتقطة بواسطة كاميرات عضوات منتدياتنا
- 6120
- مشاركات
-
الفلاشات
- || لَوْحَہٌ مِنْ اِبْدَاعِے ||
- || سَاحَہ الفلاَشْ اَلْتَعْلِيمِيَہْ ||
- || حَقِيَبہُ الْمُصَمِمَہْ ||
ساحة خاصة بأفلام الفلاشات
- 8966
- مشاركات
-
المصممة الداعية
يداَ بيد نخطو بثبات لنكون مصممات داعيـــات
- 4925
- مشاركات
-
-
ورشة عمل المحاضرات المفرغة
-
ورشة التفريغ
هنا يتم تفريغ المحاضرات الصوتية (في قسم التفريغ) ثم تنسيقها وتدقيقها لغويا (في قسم التصحيح) ثم يتم تخريج آياتها وأحاديثها (في قسم التخريج)
- 12904
- مشاركات
-
المحاضرات المنقحة و المطويات الجاهزة
هنا توضع المحاضرات المنقحة والجاهزة بعد تفريغها وتصحيحها وتخريجها
- 508
- مشاركات
-
-
le forum francais
-
- 7177
- مشاركات
-
-
IslamWay Sisters
-
English forums (36950 زيارات علي هذا الرابط)
Several English forums
-
-
المكررات
-
المواضيع المكررة
تقوم مشرفات المنتدى بنقل أي موضوع مكرر تم نشره سابقًا إلى هذه الساحة.
- 101648
- مشاركات
-
-
المتواجدات الآن 0 عضوات, 0 مجهول, 9 زوار (القائمه الكامله)
لاتوجد عضوات مسجلات متواجدات الآن
-
العضوات المتواجدات اليوم
2 عضوات تواجدن خلال ال 24 ساعة الماضية
أكثر عدد لتواجد العضوات كان 14، وتحقق
إعلانات
- تنبيه بخصوص الصور الرسومية + وضع عناوين البريد
- يُمنع وضع الأناشيد المصورة "الفيديو كليب"
- فتح باب التسجيل في مشروع "أنوار الإيمان"
- القصص المكررة
- إيقاف الرسائل الخاصة نهائيًا [مع إتاحة مراسلة المشرفات]
- تنبيه بخصوص المواضيع المثيرة بالساحة
- الأمانة في النقل، هل تراعينها؟
- ضوابط و قوانين المشاركة في المنتدى
- تنبيه بخصوص الأسئلة والاستشارات
- قرار بخصوص مواضيع الدردشة
- يُمنع نشر روابط اليوتيوب
-
أحدث المشاركات
-
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
(إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً )٩-الإسراء مَنْ كان يريد الأُسْوة الطيبة في عبودية الرسول لربه، هذه العبودية التي جعلتْه يسرى به إلى بيت المقدس، ثم يصعد به إلى السماء، ومَنْ كان يريد أن يكون مثل نوح في عبوديته لربه فأكرم ذريته من أجله، فعليه أنْ يسيرَ على دَرْبهم، وأنْ يقتديَ بهم في عبوديتهم لله تعالى، وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا في الأرض مرتين.
والذي يرسم لنا الطريق ويُوضِّح لنا الحق من الباطل هو القرآن الكريم: { إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. } [الإسراء: 9].
قول الحق تبارك وتعالى: { إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ .. } [الإسراء: 9].
هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل، ليقول: إن هذا القرآن؟
نقول: لم يكن القرآن كله قد نزل، ولكن كل آية في القرآن تُسمّى قرآناً، كما قال تعالى: { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } [القيامة: 18].
فليس المراد القرآن كله، بل الآية من القرآن قرآن. ثم لما اكتمل نزول القرآن، واكتملتْ كل المسائل التي تضمن لنا استقامة الحياة، قال تعالى: { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلٰمَ دِيناً .. } [المائدة: 3].
فإن استشرف مُسْتشرف أنْ يستزيد على كتاب الله، أو يأتي بجديد فليعلم أن منهج الله مُنزَّه عن النقص، وفي غِنىً عن زيادتك، وما عليك إلا أن تبحث في كتاب الله، وسوف تجد فيه ما تصبو إليه من الخير.
قوله: { يَِهْدِي .. } [الإسراء: 9].
الهداية هي الطريق الموصِّل للغاية من أقرب وَجْه، وبأقل تكلفة. وهو الطريق المستقيم الذي لا التواءَ فيه، وقلنا: إن الحق سبحانه يهدي الجميع ويرسم لهم الطريق، فمن اهتدى زاده هُدى، كما قال سبحانه: { وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ } [محمد: 17].
ومعنى: { أَقْوَمُ .. } [الإسراء: 9].
أي: أكثر استقامة وسلاماً. هذه الصيغة تُسمّى أفعل التفضيل، إذن: فعندنا (أقوم) وعندنا أقل منه منزلة (قَيّم) كأن نقول: عالم وأعلم.
فقوله سبحانه: { إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. } [الإسراء: 9].
يدل على وجود (القيّم) في نُظم الناس وقوانينهم الوضعية، فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما تعضُّهم المظالم ويشْقُون بها، فيُقنّنون تقنينات تمنع هذا الظلم.
ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء، فما وضعوه وإنْ كان قَيّماً فما وضعه الله أقوم، وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن تُعضَّ بشيء مُعوج غير قيّم، وإلا فماذا يلفتُك للقيم؟
أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية، ويمنع المرض من أساسه، فهناك فَرْق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض، فأصحاب القوانين الوضعية يُعدّلون نُظمهم لعلاج الأمراض التي يَشْقَون بها.
أما الإسلام فيضع لنا الوقاية، فإن حَدثْت غفلة من المسلمين، وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم: عودوا إلى المنهج: { إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. } [الإسراء: 9].
ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نروي ما حدث معنا في مدينة "سان فرانسيسكو" فقد سألنا أحدُ المستشرقين عن قول الحق تبارك وتعالى: { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ } [التوبة: 32].
وفي آية أخرى يقول: { هُوَ ٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ } [التوبة: 33].
فكيف يقول القرآن: { لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ .. } [التوبة: 33].
في حين أن الإسلام محصور، وتظهر عليه الديانات الأخرى؟
فقلتُ له: لو تأملتَ الآية لوجدت فيها الردّ على سؤالك، فالحق سبحانه يقول: { وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ } [التوبة: 32].
ويقول: { وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ } [التوبة: 33].
إذن: فالكافرون والمشركون موجودون، فالظهور هنا ليس ظهور اتّباع، ولم يقُل القرآن: إن الناس جميعاً سيؤمنون.
ومعنى الظهور هنا ظهور حُجّة وظهور حاجة، ظهور نظم وقوانين، ستضرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّي عن قوانينهم والأخذ بقوانين الإسلام؛ لأنهم وجدوا فيها ضَالّتهم.
فنظام الطلاق في الإسلام الذي كثيراً ما هاجموه وانتقدوه، ورأوا فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية، ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة، وشقي الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل في قوانينهم، وهكذا ألجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأنْ يُقنِّنوا للطلاق.
ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حُباً في الإسلام أو اقتناعاً به، بل لأن لديهم مشاكل لا حََّل لها إلا بالطلاق، وهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكريمتين، وهو ظهور بشهادتكم أنتم؛ لأنكم ستلجأون في حل قضاياكم لقوانين الإسلام، أو قريباً منها. ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام، فعارضوه وأنكروا هذا التحريم، إلى أن جاء "كِنز" وهو زعيم اقتصادي عندهم، يقول لهم: انتبهوا، لأن المال لا يؤدي وظيفته كاملة في الحياة إلا إذا انخفضتْ الفائدة إلى صفر.
سبحان الله، ما أعجب لجَجَ هؤلاء في خصومتهم مع الإسلام، وهل تحريم الربا يعني أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صفر؟ إنهم يعودون لمنهج الله تعالى رَغْماً عنهم، ومع ذلك لا يعترفون به.
ولا يخفى ما في التعامل الربوي من سلبيات، وهل رأينا دولة اقترضت من أخرى، واستطاعت على مَرّ الزمن أنْ تُسدد حتى أقساط الفائدة؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون: ألمانيا واليابان أخذت قروضاً بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك تقدمت ونهضت.
نقول لهم: كفاكم خداعاً، فألمانيا واليابان لم تأخذ قروضاً، وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها، تسمى معونة (مارشال).
وأيضاً من هذه القضايا التي ألجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة، فلما عَضَّتهم قَنَّنُوا لها.
فظهور دين الله هنا يعني ظهورَ نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف الحياة إلى الأخذ بها، وليس المقصود به ظهور اتّباع.
إذن: فمنهج الله أقوم، وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأَهْدى، وفي القرآن الكريم ما يُوضّح أن حكم الله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا في قصة مولاه "زيد بن حارثة"، وزيد لم يكن عبداً إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه، وانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة - رضي الله عنها - التي وهبتْه بدورها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان زيد في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن علم أهله بوجوده في مكة فأتوا ليأخذوه، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن خَيَّره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله، فاختار زيد البقاء في خدمة رسول الله وآثره على أهله. فقال صلى الله عليه وسلم: "فما كنت لأختار على مَنِ اختارني شيئاً" .
وفي هذه القصة دليل على أن الرقَّ كان مباحاً في هذا العصر، وكان الرقّ حضانةَ حنانٍ ورحمة، يعيش فيها العبد كما يعيش سيده، يأكل من طعامه، ويشرب من شرابه، يكسوه إذا اكتسى، ولا يُكلّفه ما لا يطيق، وإنْ كلّفه أعانه، فكانت يده بيده.
وهكذا كانت العلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين زيد؛ لذلك آثره على أهله، وأحب البقاء في خدمته، فرأى رسول الله أن يُكافئ زيداً على إخلاصه له وتفضيله له على أهله، فقال: "لا تقولوا زيد بن حارثة، قولوا زيد بن محمد" .
وكان التبني شائعاً في ذلك الوقت. فلما أراد الحق سبحانه أنْ يُحرِّم التبني، وأنْ يُحرِّم نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: { ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .. } [الأحزاب: 5].
والشاهد هنا: { هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ .. } [الأحزاب: 5].
فكأن الحكم الذي أنهى التبني، وأعاد زيداً إلى زيد بن حارثة هو الأقسط والأعدل، إذن: حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن جَوْراً، بل كان قِسْطاً وعدلاً، لكنه قسط بشري يَفْضُله ما كان من عند الحق سبحانه وتعالى.
وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلي، وأصبح الناس يقولون "زيد ابن حارثة"، فحزن لذلك زيد، لأنه حُرِم من شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعوَّضه الله تعالى عن ذلك وساماً لم يَنَلْه صحابي غيره، هذا الوسام هو أن ذُكِر اسمه في القرآن الكريم، وجعل الناس يتلونه، ويتعبدون به في قوله تعالى: { فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا .. } [الأحزاب: 37].
إذن: عمل الرسول قسط، وعمل الله أقسط.
قوله تعالى: { يَِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. } [الإسراء: 9].
لأن المتتبع للمنهج القرآني يجده يُقدّم لنا الأقوم والأعدل والأوسط في كل شيء. في العقائد، وفي الأحكام، وفي القصص.
ففي العقائد مثلاً، جاء الإسلام ليجابه مجتمعاً متناقضاً بين مَنْ ينكر وجود إله في الكون، وبين مَنْ يقول بتعدُّد الآلهة، فجاء الإسلام وَسَطاً بين الطرفين، جاء بالأقوم في هذه المسألة، جاء ليقول بإله واحد لا شريك له.
فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو أقوم وأوسط، فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر، فَلَه يَدٌ وسمع وبصر، لكن ليست يده كيدنا، وليس سمعه كسمعنا، وليس بصره كبصرنا: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ } [الشورى: 11].
وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبِّهة الذين شبّهوا صفات الله بصفات البشر، وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأوّلوها على غير حقيقتها.
كذلك في الخلق الاجتماعي العام، يلفتنا المنهج القرآني في قوله تعالى: { وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ } [يوسف: 105].
يلفتنا إلى ما في الكون من عجائب نغفل عنها، ونُعرِض عن تدبُّرها والانتفاع بها، ولو نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع شتى منها: أنها تُذّكرنا بعظمة الخالق سبحانه، ثم هي بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذي يُثري حياتنا، ويُوفّر لنا ترف الحياة ومتعتها.
فالحق سبحانه أعطانا مُقوّمات الحياة، وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء، فمَنْ أراد الكماليات فعليه أنْ يُعمِل عقله فيما أعطاه الله ليصل إلى ما يريد.
والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة في ظواهر الكون، اهتدى بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية، وسَهَّلَتْ عليها كثيراً من المعاناة.
فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بنى فكرتها على ثِقل وجده يتحرك بسهولة إذا وُضع تحته شيء قابل للدوران، فتوصل إلى استخدام العجلات التي مكَّنَتْهُ من نقل أضعافْ ما كان يحمله.
والذي أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار، وأنه يمكن أن يكون قوةً مُحرِّكة عندما شاهد القِدْر وهو يغلي، ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى، فاهتدى إلى استخدام البخار في تسيير القطارات والعربات.
والعالِم الذي اكتشف دواء "البنسلين" اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء نسميها "الريم" تتكون في أماكن استخدام الماء، وكان يشتكي عينه، فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ربما مصادفة، لاحظ أن عينه قد برئت، فبحث في هذه المسألة حتى توصّل إلى هذا الدواء.
إلى غير ذلك من الآيات والعجائب في كون الله، التي يغفل عنها الخَلْق، ويمرُّون عليها وهم معرضون.
أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة، فقد استخدموا عقولهم في المادة التي خلقها الله، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم؛ لأن الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان في الأرض أعدَّ له كُلَّ متطلبات حياته، وضمن له في الكون جنوداً إنْ أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها، وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض: { هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .. } [هود: 61].
والاستعمار أنْ تجعلها عامرة، وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود، وإلى مواهب متعددة تتكاتف، فلا تستقيم الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم، إذن: لا بد أنْ تُنظّم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعاند، وتتعاضد ولا تتعارض.
ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتي هي أقوم، وأحكم، وأعدل، كما قال تعالى في آية أخرى: { ٱللَّهُ ٱلَّذِيۤ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ .. } [الشورى: 17].
وإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر في ظواهر الكون، والتدبُّر في آيات الله في كونه، والبحث فيها لنصل إلى أسرار ما غُيّب عنا، فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا البعض، فقد حرَّم علينا التجسُّس وتتبُّع العورات، والبحث في أسرار الآخرين وغَيْبهم.
وفي هذا الأدب الإلهي رحمة بالخلق جميعاً؛ لأن الله تعالى يريد أن يُثري حياة الناس في الكون، وهَبْ أن إنساناً له حسنات كثيرة، وعنده مواهب متعددة، ولكن له سيئة واحدة لا يستطيع التخلّي عنها، فلو تتبعتَ هذه السيئة الواحدة فربما أزهدتْك في كل حسناته، وحرمتْك الانتفاع به، والاستفادة من مواهبه، أما لو تغاضيت عن هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع به.
وهَبْ أن صانعاً بارعاً في صنعته وقد احتجْتَه ليؤديَ لك عملاً، فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما، أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا في صَنْعته ومهارته، ولرغبت عنه إلى غيره، وإنْ كان أقلّ منه مهارة.
وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى، فالذي نهاك عن تتبُّع غيب الناس، والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضاً عن تتبُّع غَيْبك والبحث عن أسرارك؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمةً أعظمَ من حِفْظ الغيب عنده هو؛ لأنه ربّ، أما البشر فليس فيهم ربوبية، أمر البشر قائم على العبودية، فإذا انكشف لأحدهم غَيْبُ أخيه أو عيبٌ من عيوبه أذاعه وفضحه به.
إذن: فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلَعة في استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه، وفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون طُلَعة في تتبّع أسرار الناس والبحث عن غيبهم؛ لأنك إنْ تتبعتَ غيب الناس والتمسْتَ عيوبهم حرمْتَ نفسك من مصادر يمكن أنْ تنتفع بها. فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة، وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البنّاء، التنافس الذي يُثري الحياة، ولا يثير شراسة الاحتكاك، كما قال تعالى: { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ .. } [المطففين: 26].
كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مِثْله أو أفضل منه، وكأن الحق سبحانه يعطينا حافزاً للعمل والرُّقي، فالتنافس المقصود ليس تنافس الغِلِّ والحقد والكراهية، بل تنافس مَنْ يحب للناس ما يحب لنفسه، تنافس مَنْ لا يشمت لفشل الآخرين.
وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى في عدوه، ونحن نرى الكثير منا يغضب وتُثَار حفيظته إنْ كان له عدو، ويراه مصدر شرٍّ وأذى، ويتوقع منه المكروه باستمرار.
وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله في إيجاد هذا العدو لا تنفع به انتفاعاً لا يجده في الصديق، لأن صديقك قد يُنافقك أو يُداهنك أو يخدعك.
أما عدوك فهو لك بالمرصاد، يتتبع سقطاتك، ويبحث عن عيوبك، وينتظر منك كَبْوة ليذيعها ويُسمّع بك، فيحملك هذا من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين.
ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير، فتجتهد أنت في الخير حتى لا يسبقك إليه.
وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى: عِدَايَ لَهُمْ فَضْلٌ عليَّ ومِنَّةٌفَلاَ أبعَدَ الرحْمَنُ عَنّي الأعَادِياَ
هُمُو بحثُوا عَنْ زَلّتي فَاجْتنبْتُهاوهُمْ نَافَسُـوني فاكْتَسبْتُ المعَالِيا وهكذا نجد لكل شيء في منهج الله فائدة، حتى في الأعداء، ونجد في هذا التنافس المثمر الذي يُثري حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة.
أيضاً لكي يعيش المجتمع آمناً سالماً لا بُدّ له من قانون يحفظ توازنه، قانون يحمي الضعيف من بطش القوي، فجاء منهج الله تعالى لِيُقنّن لكل جريمة عقوبتها، ويضمن لصاحب الحق حَقّه، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس.
ثم حذَّر القوي أنْ تُطغيه قوته، وتدعوه إلى ظلم الضعيف، وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه، بل هي عَرَضٌ سوف يزول، وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى ضَعْف يحتاج معه إلى العون والمساعدة والحماية.
وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا: أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن، لأحمي ضعفك من قوة غيرك غداً.
أليس في هذا كله ما هو أقوم؟
ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله في مجال الإنفاق، وتصرُّف المرء في ماله، والمتأمل في هذا المنهج الأقوم يجده يختار لنا طريقاً وسطاً قاصداً لا تبذيرَ فيه ولا تقتير.
ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُثري حياته، وأن يرتقي بها، ويتمتع بترفها، ولا يُتاح له ذلك إنْ كان مُبذّراً لا يُبقي من دخله على شيء، بل لا بُدّ له من الاعتدال في الإنفاق حتى يجد في جعبته ما يمكنه أن يُثري حياته ويرتقي بها ويُوفّر لأسرته كماليات الحياة، فضلاً عن ضرورياتها.
جاء هذا المنهج الأقوم في قول الحق تبارك وتعالى: { وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً } [الفرقان: 67].
وفي قوله تعالى: { وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً } [الإسراء: 29].
فللإنسان في حياته طموحات تتتابع ولا تنتهي، خاصة في عصر كثُرت فيه المغريات، فإنْ وصل إلى هدف تطلع لما هو أكبر منه، فعليه إذن ألاّ يُبدّد كل طاقته، وينفق جميع دَخْله.
وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضاً عن البُخْل والإمساك؛ لأن البُخْل مذموم، والبخيل مكروه من أهله وأولاده، كما أن البُخْل سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التي تصيب المجتمع، فالممسك لا يتعامل مع المجتمع في حركة البيع والشراء، فيسهم ببُخْله في تفاقم هذه المشاكل، ويكون عنصراً خاملاً يَشْقى به مجتمعه.
إذنْ: فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم، والخير في أوسط الأمور، وهذا هو الأقوم الذي ارتضاه لنا المنهج الإلهي.
وكذلك في مجال المأكل والمشرب، يرسم لنا الطريق المعتدل الذي يحفظ للمرء سلامته وصحته، ويحميه من أمراض الطعام والتُّخْمة، قال تعالى: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } [الأعراف: 31].
فقد علَّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدْر طاقة الوقود الذي يحتاجه جسمه لا يشتكي ما يشتكيه أصحاب الإسراف في المأكل والمشرب.
والمتأمل في حال هؤلاء الذين يأكلون كلّ مَا لَذَّل وطاب، ولا يَحْرمون أنفسهم مما تشتهيه، حتى وإن كان ضاراً، نرى هؤلاء عند كِبَرهم وتقدُّم السِّنِّ بهم يُحْرمون بأمر الطبيب من تناول هذه الملذّات، فترى في بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع بخير سيده، في حين يأكل سيده أنواعاً محددة لا يتجاوزها، ونقول له:
لأنك أكلتها وأسرفتَ فيها في بداية الأمر، فلا بُدَّ أنْ تُحرَم منها الآن.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "كُلُوا واشربوا وتصدقوا، والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"
وأيضاً من أسباب السلامة التي رسمها لنا المنهج القرآني، ألاَّ يأكل الإنسان إلا على جوع، فالطعام على الطعام يرهق المعدة، ويجرُّ على صاحبه العطب والأمراض، ونلاحظ أن الإنسان يجد لذة الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع، فمع الجوع يستطيب كل شيء ولو كان الخبز الجاف.
وهكذا نجد المنهج الإلهي يرسم لنا الطريق الأقوم الذي يضمن لنا سلامة الحياة واستقامتها، فلو تدبرْتَ هذا المنهج لوجدته في أيِّ جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب.
في العقائد، في العبادات، في الأخلاق الاجتماعية العامة، في العادات والمعاملات، إنه منهج ينتظم الحياة كلها، كما قال الحق سبحانه: { مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَابِ مِن شَيْءٍ } [الأنعام: 38].
هذا المنهج الإلهي هو أَقْوم المناهج وأصلحها؛ لأنه منهج الخالق سبحانه الذي يعلم مَنْ خلق، ويعلم مَا يصلحهم، كما قلنا سابقاً: إن الصانع من البشر يعلم صَنْعته، ويضع لها من تعليمات التشغيل والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال.
فإذا ما استعملْتَ الآلة حَسبْ قانون صانعها أدَّتْ مهمتها بدقة، وسَلِمتْ من الأعطال، فالذي خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته، فيقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا: { أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ } [الملك: 14].
فآفة الناس في الدنيا أنهم وهم صَنْعة الحق سبحانه يتركون قانونه، ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم، وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانه، بل لا وَجْهَ للمقارنة بينهما. إذن: لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل.
ثم يقول تعالى: { وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً } [الإسراء: 9].
فالمنفذ لهذا المنهج الإلهي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها، وينعم بالأمن الإيماني، وهذه نعمة في الدنيا، وإنْ كانت وحدها لكانت كافية، لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشِّرنا بما هو أعظم منها، وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها، فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نَعيمَيْ الدنيا والآخرة.
نعيم الدنيا لأنك سِرْتَ فيها على منهج معتدل ونظام دقيق، يضمن لك فيها الاستقامة والسلام والتعايش الآمن مع الخَلْق.
ومن ذلك قول الحق سبحانه: { فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } [البقرة: 38].
وقوله تعالى في آية أخرى: { فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ } [طه: 123].
ويقول تعالى: { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } [النحل: 97].
وفي الجانب المقابل يقول الحق سبحانه: { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيۤ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ } [طه: 124-126].
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على منهجه خيري الدنيا والآخرة، ففي المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لا ظُلْماً منه، فهو سبحانه مُنَزَّه عن الظلم والجَوْر، بل عَدْلاً وقِسطاً بما نَسُوا آيات الله وانصرفوا عنها.
ومعنى: { يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ .. } [الإسراء: 9].
وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاحاً، أو على الأقل تُبقِي الصالح على صلاحه، ولا تتدخل فيه بما يُفسده.
وقوله: { أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً } [الإسراء: 9]. نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الأجر بأنه كبير، ولم يَأْتِ بصيغة أفعل التفضيل منها (أكبر)، فنقول: لأن كبير هنا أبلغ من أكبر، فكبير مقابلها صغير، فَوَصْف الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه، وفي هذا دلالة على عِظَم الأجر من الله تعالى.
أما لو قال: أكبر فغيره كبير، إذن: فاختيار القرآن أبلغ وأحكم.
كما قلنا سابقاً: إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير)، وليس من أسمائه أكبر، إنما هي وَصْف له سبحانه. ذلك لأن (الكبير) كل ما عداه صغير، أما (أكبر) فيقابلها كبير.
ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وفَرْض الله علينا أكبر من أيّ عمل دنيويّ، وهذا يعني أن من أعمال الدنيا ما هو كبير، كبير من حيث هو مُعين على الآخرة.
فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْبس، والمتأمل في هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة، ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً، لكن فَرْض الله أكبر من كل كبير.
ولأهمية العمل الدنيوي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الجمعة: 9-10].
والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع، واختار البيع دون غيره من الأعمال؛ لأنه الصفقة السريعة الربح، وهي أيضاً الصورة النهائية لمعظم الأعمال، كما أن البائع يحب دائماً البيع، ويحرص عليه، بخلاف المشتري الذي ربما يشتري وهو كاره، فتجده غير حريص على الشراء؛ لأنه إذا لم يشْتَرِ اليوم سيشتري غداً.
إذن: فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع، فتَرْك غيره من الأعمال أَوْلَى.
فإذا ما قُضِيَت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعي في مناكب الأرض، فأخرجنا للقائه سبحانه في بيته من عمل، وأمرنا بعد الصلاة بالعمل.
إذن: فالعمل وحركة الحياة (كبير)، ولكن نداء ربك (أكبر) من حركة الحياة؛ لأن نداء ربك هو الذي سيمنحك القوة والطاقة، ويعطيك الشحنة الإيمانية، فتُقبِل على عملك بهِمّة وإخلاص. التفسير العظيمة -
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. الأضاحي لها أحكام وآداب يجب على المسلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق. معنى الأضاحي: الأضحية: هي اسمٌ لما يذبحهُ المسلمُ مِن الإبل والبقر والغنم يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة؛ تقربًا إلى اللهِ تَعَالَى؛ (فقه السنة للسيد سابق ـ جـ4 ـ صـ176). قَالَ الإمَامُ النووي (رَحِمَهُ اللهُ): سُميت الْأُضْحِيَّة بهذا الاسم؛ لأنها تُفعَلُ في الضُّحَى، وَهُوَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ؛ (صحيح مسلم بشرح النووي ـ جـ7 ـ صـ127) مشروعية ذبح الأضاحي: الْأُضْحِيَّةُ ثابتةٌ بالقرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المباركة وإجماع عُلماء المسلمين، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]. رَوَى مُسلمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (جَانِبِ الْعُنُقِ)؛ (مسلم ـ حديث 1966). الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، يُكْرَهُ للمُسْلِمِ أن يتركها إذا كان يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهَا؛ (المجموع للنووي ـ جـ8 ـ صـ385). رَوَى مسلمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ؛ (مسلم ـ حديث 1977). فائدة مهمة: في هذا الحديث الشريف عَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُضْحِيَّةَ بالإرادة، والتعليقُ بالإرادة يُنَافي الوجُوب. * رَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق ـ جـ4 ـ صـ383). رَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ الضَّحِيَّةُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَقَدْ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ (إسناده صحيح). (مصنف عبدالرزاق ـ جـ 4ـ صـ 380). * قَالَ الإمَامُ مَالِكُ بْنُ أنَسٍ (رَحِمَهُ اللهُ): الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا؛ (موطأ مالك ـ جـ 1 ـ صـ 388). * قَالَ الإمَامُ الترمذي (رَحِمَهُ اللهُ): الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ؛ (سنن الترمذي ـ جـ 4 ـ صـ 78). الحكمة من ذبح الأضحية: نستطيع أن نوجز الحكمة من الأضحية في الأمور التالية: (1) التَّقَرُّب إلى اللهِ تَعَالَى بِهَا، قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: 162، 163]. والنُّسُكُ هُنَا هُوَ الذبح تقرُّبًا إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (2) إحْيَاء سُنَّة خليل الرحمن إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (3) التَّوْسِعة عَلى الأهْلِ يوم العيد، وإشاعة الرحمة والمودة بين الفقراء. (4) شُكْر الله تَعَالَى عَلى نِعَمِهِ العظيمة وعَلى مَا سَخَّرَه لنا مِنْ بهيمة الأنعام؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ـ صـ243). أنواع الأضاحي المشروعة: اتفقَ العُلماءُ على أنَّ الْأُضْحِيَّةَ لا تجوز إلا مِنَ الإبل والبقر، والغنم ومنها الماعز، بسائر أنواعها، فيشمل الذَّكَر والأنثى، والخصي، ولا تجزئ غير هذه الأنواع؛ لأنه لم ينقل أحَدٌ مِن العُلماء عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عَن الصحابة التضحية بغير هذه الأنواع مِن الأنعام، ولأن الْأُضْحِيةَ عِبادة تتعلق بالحيوان، فتختص بهذه الأنواع المذكورة فقط؛ (الفقه الإسلامي للزحيلي ـ جـ3 ـ صـ611). وأفْضَلُ ما يُضَحي به المسلمُ هو: الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الاشتراك في الإبل ثم الاشتراك في البقر؛ (المغني لابن قدامة ـ جـ13 ـ صـ 366). رَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا يُهْدِي أَحَدُكُمْ لِلَّهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَ لِكَرِيمِه؛ اللَّهُ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخُتِيرَ لَهُ؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق ـ جـ 4 ـ صـ 386). السِنُّ المشروع للأضاحي عند ذبحها: يُجْزئُ مِن الضَّأن والماعز ما له سَنَة كَامِلَة، ولكن إذا لم يتيسَّر مِن الضَّأن مَا له سَنَة، أجزأ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، ولا يجوز ذلك في الماعز. ويُجْزئ مِن البقر مَا له سَنَتان كاملتان، ويُجْزئ مِن الإبل مَا له خمس سنين، ولا يُجزئُ أقَل مِنْ ذَلِكَ؛ (الاستذكار لابن عبدالبر ـ جـ15 ـ صـ154). رَوَى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبدالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ"؛ (مسلم ـ حديث 1963). فتوى دار الإفتاء الـمصرية: * أقل ما يـجزئ في الأضحية مِن البقر الثنية منها، وهي ما كان لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتـحديد سِن الأضحية تـوقيفي، ولا عبرة لكثرة اللحم؛ لأن الاعتبار لبلوغ سِن التلقيح؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية ـ جـ8 ـ فتوى رقم:1130/ صـ2762). ينبغي على المسلم الذي يَحْرِصُ على اتباع سُنَّة نبينا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أن يتأكد مِنْ سِن الْأُضْحِيَّةِ عند شرائها، وذلك بسؤال أهْلِ الخبرة الصالحين في هذا الأمْر. حكم الأضحية بالأنعام المخصية: يجوزُ أن تكون الْأُضْحِيَّة بالْخَصِيِّ مِن الإبل أو البقر أو الغنم؛ (المغني لابن قدامة ـ جـ13ـ صـ371). رَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (خَصِيَّيْنِ) فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني ـ حديث 2531). معنى الخِصاء: الْخِصَاءُ: ذَهَابُ عُضْوٍ غَيْرِ مُسْتَطَابٍ، يَطِيبُ اللَّحْمُ بِذَهَابِهِ، وَيَكْثُرُ وَيَسْمَنُ. * قَالَ الْخَطَّابِيُّ (رحمهُ اللهُ): فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْخَصِيَّ فِي الضَّحَايَا غَيْر مَكْرُوه، وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم لِنَقْصِ الْعُضْو، وَهَذَا النَّقْص لَيْسَ بِعَيْبٍ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ يَزِيدُ اللَّحْمَ طِيبًا وَيَنْفِي فِيهِ الزُّهُومَة وَسُوء الرَّائِحَة؛ (معالم السنن للخطابي ـ جـ2ـ صـ197). ما لا يجـوز من الأضاحـي: رَوَى أبو داودَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا (عَرَجَهَا)، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى (لَيْسَ لَهَا مُخٌّ)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني ـ حديث 2431). * قَالَ الإمَامُ ابنُ عَبدالبر (رَحِمَهُ اللهُ): الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا، لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا دَاخِلٌ فِيهَا. فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَائِمَة، أَلَّا تَرَى أَنَّ الْعَوْرَاءَ إِذَا لَمْ تَجُزْ فِي الضَّحَايَا، فَالْعَمْيَاءُ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ، وَإِذَا لَمْ تَجُزِ الْعَرْجَاءُ، فَالْمَقْطُوعَةُ الرِّجْلِ أَحْرَى أَلَّا تَجُوزَ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ (الاستذكار لابن عبدالبر ـ جـ 15ـ صـ 124). يَجبُ أنْ يَعْلَمَ كُلُّ مُسْلِمٍ أنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيِّبًا؛ ولذا فإنَّ مِنْ شُروط الْأُضْحِيَّةِ أن تكون سليمة مِن العيوب التي تنقص اللحم، فلا يَجوزُ للمسلم أن يتقربَ إلى الله تَعَالى بأضحيةٍ بها عُيوب، فلا تُجزئ العمياء ولا العَوْرَاء ولا الْمَرِيضَةُ، التي لا يُرجَى شِفَاؤُهَا، ولا العرجاء، الظاهر عرجها، ولا التي يبس ضرعها، ولا التي ذَهَبَ أُذُنها أو قَرنها، ولا مقطوعة الإلية؛ (المغني لابن قدامة ـ جـ13ـ صـ369: صـ371). العيوب اليسيرة في الأضحية مَعفوٌّ عنها: * قَالَ الْخَطَّابِيُّ (رَحِمَهُ اللهُ): الْعَيْب الْخَفِيف فِي الضَّحَايَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: "بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَبَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَبَيِّنٌ ظَلْعُهَا"، فَالْقَلِيلُ مِنْهُ غَيْرُ بَيِّنٍ فَكَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ؛ (معالم السنن للخطابي ـ جـ2ـ صـ199). الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته: أهْلُ بيتِ الرَّجُلِ هُمُ الَّذِينَ تلزمه النفقة عليهم، قليلًا كانوا أو كثيرًا، والْأُضْحِيَّةُ بالشاة الواحدة تُجزئُ عنهم جميعًا؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية ـ جـ23 ـ صـ164). رَوَى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ؛ (البخاري ـ حديث 5548). * قَالَ العسقلاني (رَحِمَهُ اللهُ): قَوْلُهُ: (ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الذَّبْحَ الْمَذْكُور كَانَ على سَبِيل الْأُضْحِية، ثم قَالَ رحمهُ اللهُ: وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ضَحِيَّةَ الرَّجُلِ تُجْزِي عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني ـ جـ 10ـ صـ 8). * قَالَ القرطبي (رحمهُ اللهُ): لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بِأُضْحِيَّةٍ مَعَ تَكْرَارِ سِنِي الضَّحَايَا وَمَعَ تَعَدُّدِهِنَّ، وَالْعَادَةُ تَقْضِي بِنَقْلِ ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ، كَمَا نُقِلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الجزئيات؛ (فتح الباري لابن حجر العسقلاني ـ جـ 10ـ صـ 8). رَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني ـ حديث 2531). رَوَى الترمذيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 1261). رَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ يَقُولُ أَهْلُهُ: وَعَنَّا، فَيَقُولُ: وَعَنْكُمْ؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق ـ جـ 4ـ صـ 384). الاشتراك في الأضحية الواحدة: يجوز للمسلم أن يَشتركَ في الْأُضْحِيَّةِ مع غيره، إذا كانت مِن الإبل أو البقر، فيُجزئُ البعير الواحد أو البقرة الواحدة عَن سَبعة أفراد، بشرطِ مُرَاعَاة السِّن؛ (المغني ـ لابن قدامة ـ جـ13 ـ صـ392). رَوَى مسلمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدالله قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ (البعير) عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ؛ (مسلم ـ حديث 1318). ما يتجنبه صاحب الأضحية: رَوَى مسلمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْج النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ؛ (مسلم حديث 1977). النهي في هذا الحديث الشريف يَشْمَلُ شَعْر الرأسِ والشَّارِبِ والإبِطِ والعَانَةِ. وقت ذبح الأضاحي: يبدأ وَقْتُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الانتهاء مِن صلاة العيد والخطبة، أو مرور وقت بمقدار الانتهاء مِنْ صلاة العيد والخطبة، ويمتد الذبح ليلًا ونهارًا حتى آخِـــر أيام التشريق الثلاثة؛ (الاستذكار ـ لابن عبدالبر ـ جـ15 ـ صـ198). ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد: لا يَجوزُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةِ قبل صلاة العيد أو قبل مرور وقت بمقدار صلاة العيد؛ (سبل السلام للصنعاني ـ جـ4ـ صـ533). رَوَى البخاريُّ عَن الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ؛ (البخاري ـ حديث 965). رَوَى مُسْلمٌ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ؛ (مسلم ـ حديث 1960). حكم التوكيل في الأضاحي: مِنَ السُّنَّةِ أن يَقُومَ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ بذبحها بنفسه، اقتداءً بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَى البخاريُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا (جَانِبِ الْعُنُقِ) وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ؛ (البخاري ـ حديث5564). ويَجوزُ لصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ أن يُنيبَ غيره في ذَبْحِها والتصرف فيها بلا حَرَج، ولا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ في جَواز التوكيل؛ وذلكَ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بيده ثلاثًا وستين بَعِيرًا ثم أعطى السِّكِينَ لعَلي بن أبي طالب فنَحَرَ الباقي؛ (البخاري ـ حديث 1718/ مسلم ـ حديث 1218). الدعاء عند ذبح الأضحية: مِنَ السُّنَّةِ عند ذَبْح الْأُضْحِيَّةِ أن يقولَ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ، أو نائبه: (بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ) اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ (ويَذْكُر اسمه) وأهْلِهِ، ويَذْكُرُ الوكيلُ اسْمَ مَنْ أنَابَهُ؛ (مسلم ـ حديث 1967). أجـرة الجـزَّار: يَقُومُ صَاحِبُ الْأُضْحِيَّةِ بإعطاء الْجــَزَّار أُجْــرَةَ عمله مِنَ المال، ولا يجوز أن يعطيه أجرته مِنْ لحم الْأُضْحِيَّةِ، ولا يعطيه جلدها بدلًا مِنَ الأجـــرة؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ ذلكَ. رَوَى مُسْلمٌ عَنْ عَلِيِّ بنِ أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا؛ (مسلم ـ حديث 1317). فائدة مهمة: يَجوزُ لصَاحِب الْأُضْحِيَّةِ أن يُعطي الْجَزَّارَ شيئًا مِنْ لحم الْأُضْحِيَّةِ عَلَى سبيل الهدية، أو الصدقة؛ (المغني لابن قدامة ـ جـ13 ـ صـ 382:381). تقسيم لحوم الأضاحي: يُستحبُّ أن تُقَسَّمَ الْأُضْحِيَّة ثلاثة أقسام: فيأكل أهْلُ البيت ثُلُثَ الْأُضْحِيَّةِ، ويتصدَّقون بثُلُثٍ على الفقراء، ويُهدون الثُّلُثَ البَاقي للأقارب والجيران؛ (الاستذكار لابن عبدالبرـ جـ15ـ صـ173/ المغني ـ جـ13ـ صـ379). رَوَى مُسْلمٌ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (عَنْ لحوم الأضاحي): كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا؛ (مسلم ـ حديث 1791). أمور خاصة بالأضاحي: (1) إذا عَيَّنَ المسْلمُ أضحيةً، فولدت، فولدها تابعٌ لها، وحُكْمه حُكْمها، سواء كان حَملًا قبل التعيين، أو حَدَثَ بعده؛ (المغني لابن قدامة ـ جــ 13ـ صـ375). (2) إذا أَوْجَبَ المسْلمُ عَلَى نفْسِهِ أضحيةً سليمةً ثم أصابها عيب يمنع الإجزاء بتضحيتها، مِنْ غير إهمال منه، ذبحها ولا حَرَج؛ (الأم للشافعي ـ جـ2 ـ صـ225). (3) إذا أَوْجَبَ المسلمُ أضحيةً مُعَيَّنَةً ثُم أصَابَهَا تَلَفٌ أو سُرِقَت بإهمالٍ منه، وَجَبَ عليه أن يذبحَ مثلها، وأما إذا حَدَثَ ذلكَ بغير تفريطٍ منه فلا شيء عليه. (4) يَجوزُ استبدال الْأُضْحِيَّةِ بأفضل مِنْهَا، ولا يَجوزُ استبدالها بِأَقَلّ مِنْهَا. (5) لا يَجوزُ بيع شيء مِن الْأُضْحِيَّةِ، لا لحمها، ولا جِلْدَهَا، ولا صُوفها، واجبة كانت أو تطوُّعًا؛ لأنها تعيَّنت بالذبح، ويجوز الانتفاع بجلدها، أو التصدُّق به. (6) إذا نَذَرَ المسْلمُ أضحيةً نَذْرًا غير مُقَيَّدٍ بشخصٍ مُحَدَّدٍ، فله أن يأكل منها. (7) إذا عَيَّنَ المسْلمُ أضحيةً ومات قبل ذبحها، وَجَبَ عَلى ورثته ذبحها، ولا يجوز بيعها والتصدق بثمنها، ولا بيعها لسداد دَيْنه؛ لأن دَيْن الله أحق بالقضاء؛ (المغني لابن قدامة ـ جـ13ـ صـ391:373). أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وينفعَ به طلابَ العِلْمِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ. الشيخ صلاح نجيب الدق شبكة الالوكة -
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
يسَّر الله لي الاطلاع على عدد من كتب تفاسير القرآن الكريم؛ للتعرف على مدلولات تفسير الآية موضوع المقال، فشدَّني تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ لِما عرضه من تفصيل شامل ودقيق للآية، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإليكم ما ذكره رحمه الله على النحو الآتي: 1. إن "الإنسان" ليس شخصًا معينًا، بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى، فإنه يطغى. 2. معنى الطغيان: مجاوزة الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله، طغى ولم يبالِ، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكربات، وحصول المطلوبات، صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسِيَ المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسِيَ الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكُسوة نسِيَ العُري... وهكذا. 3. الإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد، متى رأى نفسه في غنًى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن؛ لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائمًا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه، وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، هذا هو المؤمن، لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72]. والمتأمل لحياة الناس اليومية يرى بوضوح صورًا من طغيان الإنسان في مجالات شتى، وبجهد المقل سأعرض جملة من الملامح التربوية التي تضمنتها الآية موضوع المقال؛ لعلها تُسهِم في ضبط السلوك الإنساني من الطغيان، وبالله التوفيق، وعليه التُّكْلان: أولًا: إن التسلح بالإيمان الصادق، والالتزام بشرع الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، هو السبيل الأمثل للبعد عن الطغيان، وتجاوز الحدود، ونشر الخير والمحبة، والفضيلة والسلام بين الناس على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم. ثانيًا: تختلف درجة طغيان الإنسان بحسب ما لديه من إيمان وتقوى، فكلما قَوِيَ الإيمان كان بعيدًا عن إيذاء من حوله، بخاصة أخوه الإنسان بأية صورة من صور الإيذاء؛ امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ((المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده))؛ [صحيح البخاري: 10، صحيح مسلم: 40]. وقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقِره ولا يخذُله))؛ [صحيح البخاري: 6064، صحيح مسلم: 2564]. ثالثًا: المؤمن المتقي في الغالب إن حصل منه طغيان وتعدٍّ على الآخرين، فسرعان ما يبادر بالاعتذار، وطلب الصفح؛ لأنه يخشى من جزاء الله تعالى وعقابه في الدنيا قبل الآخرة. وصدق الله العظيم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 201]؛ قال السدي رحمه الله: "إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكَّر وعَرَف أنه معصية، فأبصر فنزع عن مخالفة الله"؛ [البغوي، التفسير، الأعراف: 201]. رابعًا: من أهم بواعث الطغيان لدى الإنسان الغضبُ، وما يحصل معه من ظلم لأخيه الإنسان، وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير؛ كما ورد في الحديث الشريف: ((أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصِني، قال: لا تغضب، فردَّد مرارًا، قال: لا تغضب))؛ [صحيح البخاري: 6116]. قال ابن حجر رحمه الله: "الغضب يجمع الشر كله"؛ [فتح الباري، 17/297]. خامسًا: إن الاستزادة من العلم الشرعي والعناية به، والمحافظة على أداء الفرائض المكتوبة، والإكثار من النوافل، ومداومة ذكر الله تعالى - حصنٌ حصين من تسلُّط النفس الأمَّارة بالسوء والشيطان على الإنسان، فيكون دائمًا على بصيرة من إيذاء نفسه أو الآخرين، وهو في حفظ الله تعالى، فالله يحفظ من يحفظه، ويتولى من اعتنى بعبادته وأخلص فيها؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: 62]. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ((احفظ الله يحفظك))؛ [الألباني، صحيح الترمذي، 2516]. قال ابن عثيمين رحمه الله: "جملة تدل على أن الإنسان كلما حفِظ دين الله حفِظه الله، ولكن حفِظه في ماذا؟ حفظه في بدنه، حفظه في ماله، في أهله، في دينه، وهذا أهم الأشياء أن الله يحفظك في دينك، يسلمك من الزيغ والضلال؛ لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدًى". سادسًا: أورد القرآن الكريم ثلاث حالات تَعرِض للنفس الإنسانية: النفس الأمارة بالسوء؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف: 53]، والنفس اللوامة؛ قال تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: 1، 2]، والنفس المطمئنة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: 27 - 30]. ولا شكَّ أن النفس المطمئنة هي نفس المؤمن التقيِّ النقيِّ الْمُمْتَثِل لشرع الله أمرًا ونهيًا، وهناك ارتباط وثيق بين كل نوع من هذه الأنفس ودرجة الطغيان، فعندما يكون الإنسان متلبِّسًا بالنفس الأمارة بالسوء، يعُمُّ أذاه ويقل خيره، أما النفس اللوامة، فهي على خير لِما يحصل من لوم صاحبها على الطغيان إن حصل، فيؤوب إلى رشده نادمًا على ما بدر منه، أما النفس المطمئنة، فهي في سلام دائم، فإذا لم يحصل منها خير للآخرين، لم يلحقهم منه ضرر ألبتة، ولعل هذه المراحل للنفس الإنسانية تتشابه إلى حد كبير مع قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: 32]. والإنسان العاقل الموفَّق أعرف بنفسه من غيره، فالواجب أن يرتقيَ بنفسه ويُربِّيها شيئًا فشيئًا على القيم والمبادئ، والأخلاق الإسلامية الفاضلة؛ حتى يلحَقَ بركب النفس المطمئنة؛ حيث يأمن الناس من طغيانه، ويعم خيره، ويقل ضرره. سابعًا: من أقوى مسببات طغيان الإنسان على أخيه الإنسان التعصبُ الديني، أو المذهبي، أو القَبَلي، أو العرقي، وما شابه ذلك؛ ولذلك فالمهذب الأول والضابط لسلوك الناس في كل زمان ومكان هو الالتزام بشرع الله تعالى، ويعضُّد ذلك ويقويه ما تَضَعُه الدول والحكومات من أنظمة وقوانين لتنظيم الحياة الاجتماعية لسلامة أفراد المجتمع الواحد مما قد يحصل من إيذاء بعضهم بعضًا، ولضمان استتباب الأمن بين أفراد المجتمع للعيش بأمن وسلام وحياة كريمة، ولكن في كلا الحالين لضمان الالتزام بشرع الله، وتنفيذ أنظمة الجهات الرسمية يحتاج الأمر إلى جهات رسمية مخوَّلة بالمتابعة وتطبيق العقوبات المناسبة عند حدوث أية مخالفات، سواء كانت شرعية أو نظامية. ولله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي شبكة الالوكة -
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
آية الذرية في سورة العنكبوت ومضامينها التربوية قال الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت: 27]، ونستفيد من توجيهات هذه الآية: ثواب صلاح الوالدين في الدنيا: إن صلاح الوالدين له بركاته في الدنيا والآخرة على نفس الإنسان بالدرجة الأولى، فأما في الدنيا فإن الله جل وعلا يرزقه زوجة صالحة، ورزقًا واسعًا، وذرية مباركة، وثناءً حسنًا، وذكرًا جميلًا، وهذا يؤكده ما جاء في قصة الخضر مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عند قتل الخضر الغلام، واعتراض موسى عليه السـلام على فعله؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: 80، 81]. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وكان ذلك الغلام، قد قُدِّر عليه، أنه لو بَلَغَ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا؛ أي: لحملهمـا على الطغيان والكفـر؛ إما لأجل محبتهما إياه، أو للحاجة إليه يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته، لاطلاعي على ذلك؛ سلامةً لدين أبويـه المؤمنين، وأي فائـدة أعظم مـن هـذه الفائـدة الجليلـة؟ وهـو وإن كـان فيـه إساءة إليهمـا، وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سـيعطيهما مـن الذرية ما هو خـير منـه، ولهـذا قال: ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾؛ أي: ولدًا صالحًا، زكيًّا، واصلًا لرحمه، فإن الغلام الذي قُتل لو بلغ لعقهما أشدَّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. وإن الإنسان المسلم كلما ترقى في صلاحه وتقواه وورعه، نال من الله الدرجات العلا في الدنيا، وما أعده الله تعالى للصالحين من عباده في الآخرة أعلى وأعظم، فحينئذ يجب على المسلم الحرص الشديد على طاعة ربه، والتزام أوامره واجتناب نواهيه. ثواب صلاح الوالدين في الآخرة: إن ثواب صلاح الإنسان في الآخرة، يكون بأن يرفع الله درجته؛ ليكون مع أفضل خلق الله تعالى؛ مصداقًا لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: 69]. ولا شك أن هذه الكوكبة النيِّـرة من عباد الله تعالى الصالحين، يتقدمهم صفوة الخلق: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في أفضل إنعام وأرقى درجات الجنان التي أعدها الله تعالى لهم، ولذلك يجب على الإنسان المسلم أن يحرص على صلاح نفسه أولًا باتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والبعد كل البعد عن أسباب الغواية؛ من تحكيم شهواته، والحذر من الشبهات التي هي أسباب كل شر، والعياذ بالله، ثم إن هذا الصلاح للنفس - كما هو واضح من الشواهد الشرعية المشار إليها - سبيل صلاح الذرية بعون الله وتوفيقه. آية الذرية في سورة غافر ومضامينها التربوية قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [غافر: 8]. تتضمن الآية الكريمة - وما سبقها وتلاها - توجيهين تربويين مهمين؛ هما: التوبة الصادقة نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، والبشارة بزيادة الثواب العظيم للتائبين الصالحين، وفيما يلي عرض لهما: أولًا: التوبة الصادقة نجاة للعبد في الدنيا والآخرة: هذه الآية الكريمة جاءت في سياق التوبة لمن أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب - وإن عظُمت - فإن الله يقبل التوبة من عباده إذا صدقوا فيها، ونهجوا طريق الصلاح والتقوى والعمل الصالح، وختم الله تعالى حياتهم وهم على ذلك، فيكون جزاؤهم عند الله عظيمًا، وهو إدخالهم جنات دائمة التي هي رجاء كل مسلم وأمله وطموحه؛ بل إن دعاءنا كله يتمحور حولها، وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ((كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُـوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ))[1]. ثانيًا: البشارة بزيادة الثواب العظيم للتائبين الصالحين: إن مَن أخلص في توبته ونهج طريق الاستقامة؛ فإن الله تعالى - بفضله ورحمته - يزيد في إكرامه، بأنه جل وعلا سيُلْحِق به من صلح في إيمانه وعمله من آبائه وأزواجه وأولاده. ومما أورد القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية قوله: "قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: يدخل الرجل الجنة فيقول: يا رب، أين أبي وجَدِّي وأمي؟ وأين ولدي وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيُقال: إنهم لم يعملوا كعملك، فيقول: يا رب، كنت أعمل لي ولهم، فيُقـال: أدخلهـم الجنـة، ثم تلا: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [غافر: 7، 8]. وقد أشارت الآية الكريمة هذه إلى أسلوب تربوي هو: البشارة بمضاعفة وزيادة الأجر للعاملين، وهو أسلوب تحتاجه النفس البشرية في مختلف المراحل العمرية، وفي مختلف المجالات الحياتية؛ فعلى المعنيِّين بهذه المجالات الأخذ بهذا الأسلوب القرآني، وسيجدون بإذن الله تعالى فوائده العظيمة في: مضاعفة الجهد، وزيادة الإنتاج من العامليـن. [1] (سنن أبي داوود، حديث رقم: 792، كتاب الصـلاة، باب في تخفيف الصلاة). آية الذرية في سورة الأحقاف ومضامينها التربوية قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: 15]. نستفيد من هذه الآية الكريمة مجموعة من التوجيهات التربوية المهمة وهي: الحرص على بر الوالدين، وأهمية التهيؤ والحذر لمن بلغ سن الأربعين، وأهمية صلاح الـوالدين، والتوبة والإنابة إلى الله من المعاصي والذنوب، والدعاء بصلاح الأولاد، وفيما يلي عرض لهذه التوجيهات: أولًا: الحرص على بر الوالدين: الأخذ بوصية الله تعالى بالحرص الشديد على بر الوالدين بكل وسيلة من وسائل البر: بتأمين حوائجهم، والتلطف معهم في الحديث؛ نظير ما عانوه من مشقة في تربية الأولاد. وهذا الموضوع مما اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتمامًا كبيرًا في الكثير من التوجيهات: في القرآن الكريم، والسنة المطهرة، قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: 23]. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: "أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمـر بالإحسان إلى الوالدين، وجعل بر الوالدين مقرونًا بعبادته وحده جل وعــلا، والمذكور هنا ذَكَره في آيات أُخَرَ، وهي: قوله تعالى في: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: 83]، وقوله تعـالى: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14]، ويضيف الشيخ الشنقيطي القول: "إن الله تعالى بيَّن في موضع آخر أن برَّهما لازمٌ، ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: 15]، وقوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [العنكبوت: 8]، ثم يختم ذلك بقوله: "وذِكرُ الله تعالى في هذه الآيات بر الوالدين مقرونًا بتوحيده جل وعلا في عبادته - يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين". ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بالوالدين ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحُسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك))[1]. وهذا الموضوع المهم للغاية لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الحديث، أو كتب الأدب والتربية قديمًا وحديثًا، بل إنهم يضعونه في أول الموضوعات؛ لمكانته وأهميته، ما يدل على أنه تجب العناية بهذا الموضوع من قِبل المؤسسات التربوية المختلفة، وغرسه في نفوس الناشئة والشباب، وبيان خطورة عقوق الوالدين، وأنها من كبائر الذنوب التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك باللـه، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فمـا زال يقولهـا حتـى قلت: لا يسكت))[2]. ثانيًا: أهمية التهيؤ والحذر لمن بلغ سن الأربعين: تمضي بالإنسان السنون، وهو لا يشعر بها في كثير من الأحيان، وهو يُسوِّف بالاستقامة والعمل الصـالح، وهذا التسويف لا يجدي ألبتة؛ لأن الإنسان لا يعلـم متى يحين أجله؛ فالأجـل يأتي بغتة، وقد يكون في العمر متسع للتوبة النصوح وقد لا يكون، أما إذا أكرمه الله وبقي حتى سن الأربعين - وهي أشد المراحل العمرية أهمية؛ لبلوغ الإنسان فيها مرحلة النضج العقلي، الذي به يستطيع التمييز بين مـا يصلح له وما لا يصلح - فمن أعظم المصائب أن يبلغ الإنسان هذه السن دون أن يصحو من سكرته، ويفيق من غفوته، ويتوب إلى ربه قبل نزول الموت به. فإذا بلغ الإنسان الموفَّق الأربعين من عمره، طلب من الله أن يوفقه لشكر النعم عليه وعلى والديه، ونعم الإله جل وعلا على العباد كثيرة ووفيرة لا تعد ولا تحصى، فالمراد من الآية موضوع البحث الحث على شكر النعم، والإقرار للمنعم بها، والقيام بحق شكر الله سبحانه فيها، كما قال تعالى عن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل: 19]. ثالثًا: أهمية صلاح الوالدين: إن صلاح الوالدين له بركاته في الدنيا والآخرة على نفس الإنسان بالدرجة الأولى، فأما في الدنيا، فبالزوجة الصالحة، والرزق الواسع، والذرية المباركة، والمنزل الواسع، والثناء الحسن، والذكر الجميل. وهذا يؤكده ما جاء في قصة الخضر مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: 80، 81]. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: "وكان ذلك الغلام قد قُدِّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا؛ أي: لحملهمـا على الطغيان والكفـر، إما لأجل محبتهما إياه، أو للحاجة إليه يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعي على ذلك؛ سلامة لدين أبويـه المؤمنين، وأي فائـدة أعظم مـن هـذه الفائـدة الجليلـة؟ وهـو وإن كـان فيـه إساءة إليهمـا وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سـيعطيهما مـن الذرية ما هو خـير منـه؛ ولهـذا قال: ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: 81]؛ أي: ولدًا صالحًـا، زكيًّا، واصلًا لرَحِمه، فإن الغلام الذي قُتل لو بلغ، لعقَّهما أشد العقوق؛ بحملهما على الكفر والطغيان". وإن الإنسان المسلم كلما ترقى في صلاحه وتقواه وورعه، نال من الله الدرجات العلا في الدنيا، وما أعده الله تعالى للصالحين من عباده في الآخرة أعلى وأعظم؛ فحينئذ يجب على المسلم الحرص الشديد على طاعة ربه والتزام أوامره واجتناب نواهيه. رابعًا: التوبة والإنابة إلى الله تعالى من المعاصي والذنوب: لا يوجد إنسان لا يخطئ ويذنب - ما عدا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فقد عصمهم الله من الخطأ والزلل - وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـال: ((كل ابن آدم خطَّاء، وخير الخطائين التوابون))؛ سنن الترمذي، حديث رقم: 2499، كتاب: صفة القيامة، باب: في استعظام المؤمن ذنوبه. والمضامين الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الموضوع كثيرة جدًّا، وليس هذا مجال بسطها، ولكن هدفنا هنا التذكير بأهمية التوبة والاستغفار في حياة المسلم، فالله تعالى تواب رحيم يقبل توبة عباده، ويفرح بها سبحانه وتعالى مهما بلغت درجة ذنوبهم وعصيانهم، ولعل ذكر شيء من المضامين الشرعية التي تحض على التوبة يذكرنا والقارئ الكريم بأهميتها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: 8]، وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأَيِسَ منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخِطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح))؛ صحيح مسلم، حديث رقم: 6960، كتاب: التوبـة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها. وإنني أؤكد هنا تأكيدًا جازمًا أن مَن كان بالله أعرف،كان منه أخوف؛ فمن عرف الله حق المعرفة بأنه الخالق، المدبر، القادر، الغفور الرحيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: 82]، فلن يجرؤ إنسان - كائنًا من كان - على عصيانه، بل يكون شديد الحرص على كسب مرضاته وطاعته، وإن عرض له عارض من زلة أو معصية، تذكَّر الله تعالى فعاد إليه فورًا تائبًا نادمًـا، قـال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 201]. خامسًا: الدعاء بصلاح الأولاد: إن الدعاء عبادة عظيمة يتجلى فيها الافتقار والخضوع والحاجة لله جل وعلا، وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قولـه: ((الدعاء هو العبادة))؛ سنن أبي داود، حديث رقم 1479، كتاب: الوتر، باب: الدعاء - ثم إن الدعاء بحـول الله تعالى يرد الشر، ويستعجل الخير، قـال رسول الله صلى الله عليـه وسلم: ((لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليُحرم الرزق بخطيئة يعملها))؛ سنن ابن ماجـة، حديث رقم: 90، كتاب: السنة، باب: في القدر. وإن الله تعالى لا يرد من دعاه وتوجـه إليه بصدق؛ فهو الكريم الجواد اللطيف بعباده، وقد تأكد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186]. فالأهم أن ندعو الله تعالى، ونصدق في دعائه، فالإجابة مضمونة؛ لأنه سبحانه وعد بهـا، ومَن أصدق من الله تعالى وعدًا ووفاءً؟ وأفضل ما يسأله المسلم من ربه جل وعلا أن يجعله من الموحدين له تعالى قولًا وسلوكًا، وأن يسأل ربه جل وعلا صلاح ذريته؛ لأن صلاحهم مطلب كل والدين ينشدان الخير، والاستقامة لأولادهم وأولاد أولادهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد سمعت أذناي أكثر من مرة آباء يدعون لأولادهم بالهداية والصلاح بعد أن تلقفتهم الشهوات، وأصدقاء السوء والعياذ بالله؛ فانحرفوا عن جادة الطريق، وبعد مناجاة وإلحاح وقرب من الله تعالى، رأيت هؤلاء الأولاد قد عادوا إلى الطريق المستقيم؛ فحافظوا على الصلوات، وبروا والديهم، ووصلوا أرحامهم، وأكملوا مشوارهم العلمي والعملي. فاحرص أيها الأب وأيتها الأم على هذا التوجيه المبارك؛ فله من الخير والبركة ما لا يخطر في بالكما. ونضيف إلى ما سبق قصة أوردها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره تُبيِّن أهمية الدعاء بعامة، والدعاء بهذه الآية بخـاصة، فقال: "قال مالك بن مغول[3]: اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مُصرف[4]، فقال: استعنْ عليه بهذه الآية وتلا: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: 15]". [1] صحيح مسلم، حديث رقم: 6500، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: بر الوالدين وأيهما أحق. [2] صحيح البخاري، حديث رقم: 5976، كتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر. [3] محـدث، ثقة، ثبت، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. [4] تابعي، يسمى: سيد القراء، انظر: طبقات القراء لابن الجزري. آية الذرية في سورة الطور ومضامينها التربوية قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْبِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: 21]. نستفيد من هذه الآية الكريمة توجيهات تربوية؛ منها: أهمية الإيمان والعمل الصالح، وبشارة أهل الجنة بزيادة نعيمهم، وفيما يلي عرض لهذه التوجيهات: أولًا: أهمية الإيمان والعمل والصالح: إن فضل الله تعالى واسع ليس له حدود، ومن سنن الله تعالى أن جعل رضوانه وجنته لمن آمن أولًا وعمل صالحًا ثانيًا، وعلى هذا الأساس يكون تفاضل الناس يوم القيامة؛ قال تعالى: ﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 156]، ومما يشير إليه الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية أن رحمة الله تعالى في الآخرة قريبة للمتقين صغائر الذنوب وكبائرها، والذين يؤدون الزكاة الواجبة، والذين يؤمنون بآيات الله، ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا، في أصول الدين وفروعه، ولذلك يجب على المسلم أن يهتم بالعمل الصالح، وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل في أكثر من خمسين آية؛ منها: قول الله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 25]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 277]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: 122]، وقال تعـالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [هود: 23]. ثانيًا: بشارة أهل الجنة بزيادة نعيمهم: إن من رحمة الله جل وعلا بعباده - وقد علم قوة ولع الوالدين بأبنائهم، وشدة تعلق الأصول بالفروع، وحرصهم على القرب منهم - أنه قد وعد الصالحين من عباده، المؤدين أوامره، المجتنبين نواهيه، إضافة إلى تكرُّمِه تعالى بإدخالهم جنانه ذات النعيم المقيم - وعدهم بأن تكون ذرياتهم معهم في الجنة، ولكن شريطة صلاحهم، وتأديتهم لما فُرض عليهم من حقوق وواجبات. وأورد ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه"، وهذا التوجيه يؤكد لنا أمرين مهمين هما: أولًا: تحفيز الوالدين بزيادة العمل الصالح والقرب من الله تعالى؛ فإن ذلك مردوده عليهم عظيم، وأي فضل أعظم من أن تكون مع الإنسان ذريته في الآخرة؟ حتى ولو لم تعمل ذريته نفس عمل الأب، ولكن بصلاح الأب ارتفعت الذرية في الجنة. ثانيًا: بذل مزيد من الجهد والعناية في تربية الأولاد، والمحافظة عليهم، وحسن رعايتهم رعاية تحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم؛ لأن ذلك سيكون سببًا في سعادتهم بهم في الدنيا، كما سيكون سببًا في سعادتهم بهم أكثر في الآخرة، نسأل الله تعالى من فضله. فيا أيها الآباء والأمهات، هلا بذلتم مزيدًا من العمل الصالح، ومزيدًا من العناية في تربية أولادكم تربية إسلامية صحيحة؛ لتحصلوا على هذه البشرى العظيمة، والجائزة الثمينة من الله تعالى. وقفة: عدم تواكل الأولاد على الآباء: إن تواكل الأولاد على الآباء له مخاطر جسيمة على الآباء من جهة، وعلى الأولاد أنفسهم من جهة ثانية، فأما مخاطره على الآباء، فيكون بعدم قيام الأولاد ببرهم في وقت حاجتهم لهم، وأما خطره على الأولاد، فقد يكون سببًا في عجزهم وقصورهم عن أداء أي عمل نافع لهم، وقد يكون سببًا لانحرافهم وإسرافهم على أنفسهم بالمعاصي والذنوب؛ ما قد يؤدي إلى هلاكهم في الدنيا والآخرة، ولذلك ينبغي على الآباء العناية التامة بغرس الإيمان في نفوس أولادهم، فهو الحصن الحصين للمسلم من الزيغ والانحراف، وذلك بتربيتهم التربية الإسلامية السليمة القائمة على مخافة الله تعالى، وعلى أداء فرائضه، واجتناب نواهيه. د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي شبكة الالوكة -
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
إنّ سنن الله الكونيّة في عباده -الّتي لا تتبدّل ولا تتغيّر- كثيرةٌ ومتنوّعةٌ، ولا يردّها قويٌّ مهما بلغت قوّته، ولا تتعجّل لمستعجلٍ حتّى تبلغ أجلها الّذي ضربه الله جل جلاله لها، قال تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 62]. وإنّ مِن سنن الله عز وجل في عباده، سَوقُ الظّالمين إلى مهالكهم، وأخذهم بما كسبت أيديهم، وهي سنّةٌ في الظّالمين ثابتةٌ لا تتخلّف أبدًا، سواءٌ كان ظلمهم لأنفسهم أم كان لغيرهم، وإنّ كلّ الأمم الّتي عذّبها الله وأهلكها، علّق هلاكها بظلمها، قال تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ * فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} [الأعراف: 4-5]. ولقد أتى التّعبير بكلمة "كَمْ" الّتي تستخدمها العرب لتكثير العدد، ليدلّ على كثرة تلك القرى الّتي أخذها الله عز وجل، وفي ذلك بشارةٌ للمظلومين، وحسرةٌ للظّالمين، فليوقن المظلومون أنّ الله سبحانه منتقمٌ من الظّالمين لا محالة، عاجلًا أو آجلًا، فَللكونِ ربٌّ يدبّره، وله حُكمٌ يَفرضه، وقدَرٌ يُنفذه، وسننٌ يمضيها، فلا ييأسنّ مسلمٌ يعلم ذلك، ويوقن به. نعم، قد يستبطئ المظلوم هلاك الظّالم، لشدّة ما يُعاني مِن الظّلم، وكثرة ما يجد مِن القهر، لا سيّما إذا كان الظّلم سفكًا للدّماء، وانتهاكًا للأعراض، وتهجيرًا من الدّيار، وسلبًا للأموال، ولكن سرعان ما يرتاح المسلم المظلوم المقهور، عندما يتدبّر قول الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَل الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42]. 1- لماذا يسلّط الله علينا الظّالمين ثمّ يمهلهم؟ ما تزال فئاتٌ مِن النّاس يُلحّون على هذا السّؤال المكرّر والمعاد، حيث يقولون: إنّنا مؤمنون بربّنا جل جلاله، فلماذا يُسلّط علينا أعداءه الكفرة المجرمين، مِن هؤلاء الّذين يعيثون في الأرض فسادًا، ألم يَعدِ الله سبحانه المسلمين بالحماية والتّأييد والنّصر، فلماذا لا يُعجّل بهلاك الظّالمين؟ وأين رحمته بالمستضعفين الّذين يكتوون بنار الظّلم والقهر، والّذين تُلقَى عليهم الحِممُ البركانيّة فوق رؤوسهم؟ وأين عذاب الله القويّ العزيز لهؤلاء المجرمين؟ وكلّ هذه الأسئلة نتيجةٌ للابتعاد عن الوعي، وتحوّل حال هؤلاء النّاس إلى التّمسك بالشّعارات، وابتعادهم عن المضامين والمبادئ والأحكام، وإلّا فإنّ الواعي الّذي يعي حقيقة الإسلام، لا يمكن أن يقف عند هذا الإشكال، ولا يُوجِع رأسه بهذا السّؤال، ومع ذلك فإنّنا سنجمل الإجابة عليه في النّقاط الآتية: أوّلًا: إنّ الله عز وجل يُمهل ولا يُهمل: فلا يُؤاخذ الظّالم فور ظلمه، بل يُمهله ويُمهله حتّى لا يبقى له عذرٌ، قال سبحانه: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: 75]. ولعلّه أن يرجع إلى الله بالتّوبة، ولو آخذ الظّالم فور ظلمه، ما ترك أحدًا على وجه الأرض، قال تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [النّحل: 61]. ثانيًا: إنّ الدّنيا دار عملٍ لا دار جزاءٍ: فالله جل جلاله يمهل الظّالم ليتمادى في الظّلم، فيسمع به أهل الأرض، عندئذٍ يأمر الله سبحانه بهلاكه، فكلّما ارتفع الظّالم وعلا، كان أبيَنَ لسقوطه والاعتبار به، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ) قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: 102]. [ 1 ] ثالثًا: إنّ مِن سنن الله جل جلاله في عباده أن يبتلي النّاس بعضهم ببعضٍ: ليعلم الصّادق في إيمانه، والصّابر على قضائه، مِن الكاذب السّاخط على أمر الله، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا} [الفرقان: 20]. ففي الوقت الّذي يُمهل الله سبحانه فيه الظّالم ليزداد ظلمًا، فتشتدّ عليه العقوبة في الدّنيا قبل الآخرة، يبتلي الله المؤمنين به لترتفع درجاتهم في الجنّات، قال تعالى: {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمّد: 4]. فلا بدّ مِن التّمحيص والاختبار بالصّبر على البلاء والشّدائد، حتّى يتميّز الخبيث مِن الطّيب، قال سبحانه: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِه} [آل عمران: 179]. 2- طغيانُ الباغينَ مُؤذِنٌ بالفرجِ من ربِّ العالمينَ إنّ الله تعالى يغار على دِينه أكثر مِن غيرة عباده وأشدّ، فلقد أهلك جبابرة القرون الّذين خلوا لمّا بلغوا في الظّلم والإفساد مبلغًا عظيمًا، قال تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} [الزّخرف: 55]. وخاطب نبيّه صلى الله عليه وسلم بقوله: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ *قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [الزّخرف: 23-25]. وفي زواجر القرآن مِن أخبار الأمم ما يدعو للاعتبار، قال جل جلاله على سبيل الإجمال: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الرّوم: 47]. وإنّ النّظام المجرم وحلفاءه مِن دول الغرب والكفر، قد بلغوا مِن الإفساد والإجرام والطّغيان، مبلغًا يُؤذن بقرب زوالهم، يعلم هذا مَن أدرك واقع هذه الأنظمة العفنة، ثمّ عرف الله سبحانه وآمن بأسمائه وصفات جلاله وكماله، ومِن ذلك: أنّه ملكٌ جبّارٌ عزيزٌ مهيمنٌ ذو انتقام، يغضب ويغار على محارمه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشِ). [ 2 ] لقد أهلك الله عز وجل مِن الأمم الماضية، مَن لم يُعرف إلّا بذنبٍ مع الكفر، حيث أهلك قوم لوطٍ بفاحشتهم، وأهلك قوم شعيبٍ بتطفيف الكيل والميزان، وقوم عادٍ بتكبّرهم وتجبّرهم، وغيرهم مِن الأمم الّتي جعلها الله سبحانه أحاديث للنّاس، فبادت بعدما سادت، وعادت أثرًا بعد عينٍ، فكيف والنّظام المجرم اليوم وحلفاؤه قد بلغوا مِن الاستطالة على المحارم والمقدّسات مبلغًا يُضارعون فيه تلك الأمم السّالفة! فاستشراء الفواحش فيهم ظاهرٌ، والإجرام والوحشيّة في القصف المُمَنهج، والصّواريخ والحمم البركانيّة الّتي يلقيها فوق النّساء والأطفال الأبرياء قد بلغ غايته، وإنّها لبراميلٌ مِن الحقد والإجرام تُلقى فوق رؤوس شعبنا الضّعيف المقهور، لا تستطيع الجبال الرّاسيات أن تتحمّل شيئًا منها، وهذا كلّه يُؤذن بقرب حلول نقمة الله جل جلاله بهم، ولكن في الوقت الّذي يريده، قال تعالى: {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا} [الكهف: 59]. ولا شكّ أنّ في تأخير انتقام الله عز وجل مِن الظّالمين حكمةٌ من حِكَمِه الّتي لا يعلمها إلّا هو، ومنْ لم تكنْ له معرفةٌ بالسّنن وأخبار الأمم، يجزم بذلك إذا عرف ربّه، و صِدْق وعده، قال سبحانه: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59]. خاتمةٌ: عندما يرى الله جل جلاله أنّ هذه الأمّة قد آل أمرها إلى العصيان بعد الطّاعة، وإلى التّفرّق بعد الوحدة، فإنّه لا يؤدّبها باستئصالٍ جماعيٍّ، بغرقٍ أو خسفٍ ونحوهما، كما أهلك الأمم السّابقة، بل إنّما يُسلّط عليها عدوّها، ويمدّ له، حتّى ترجع هذه الأمّة إلى ربّها، وتصحو من نومها. وإنّه جل جلاله لا يعجل بعجلة أحدنا، فلقد أوصى نبيّه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالصّبر وعدم الاستعجال لهلاك المجرمين، قال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ} [الأحقاف: 35]. وهذا ما يجب أن نكون عليه في ظلّ هذه الظّروف المريرة الّتي نمرّ بها، ونحن نخوض فيها أقسى المعارك، مع الطّغاة المجرمين، فلْنتحلَّ بالصّبر الجميل، والثّقة الكاملة بالله، بأنّه ناصرٌ دينه، ومهلكٌ عدوّه، وليكنْ عندنا الأمل الواسع بالنّصر القريب، والفتح المبين المُرتقب، ولا ينبغي أن يحملنا استبطاء النّصر على اليأس مِن رحمة الله جل جلاله، وليعتبرِ الظّالمون بمَن سبقهم، ولينتهوا، فوعد الله حقٌّ، وعذابه أليمٌ ، وأمره كلمح البصر أو هو أقرب. ولنعلمْ أنّ شدّة طغيان الظّالمين المجرمين، مؤذنٌ بقرب موعد هلاكهم، فما حدث لجبابرة الأمس مِن عذابٍ وانتقامٍ، سيحدث مثله لجبابرة هذا العصر، اليوم أو غدًا، وإنّ غدًا لناظره قريبٌ. 1 - صحيح البخاريّ: 4686 2 - صحيح البخاريّ: 7403 رابطة العلماء السوريين
-
-
أكثر العضوات تفاعلاً
لاتوجد مشارِكات لهذا الاسبوع
-
آخر تحديثات الحالة المزاجية
-
أم أنيس تشعر الآن ب حزينة
-
حواء أم هالة تشعر الآن ب راضية
-
مناهل ام الخير تشعر الآن ب سعيدة
-
سارة سيرو تشعر الآن ب مكتئبة
-
samra120 تشعر الآن ب غير مهتمة
-
-
إحصائيات الأقسام
-
إجمالي الموضوعات181947
-
إجمالي المشاركات2535182
-
-
إحصائيات العضوات
منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤
أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..