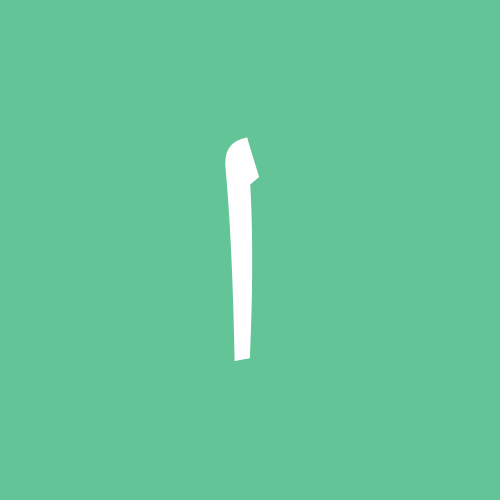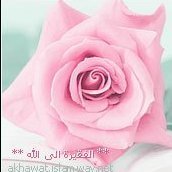المنتديات
-
"أهل القرآن"
-
ساحة القرآن الكريم العامة
مواضيع عامة تتعلق بالقرآن الكريم
- 57262
- مشاركات
-
ساحات تحفيظ القرآن الكريم
ساحات مخصصة لحفظ القرآن الكريم وتسميعه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" [صحيح الترغيب]- 109817
- مشاركات
-
ساحة التجويد
ساحة مُخصصة لتعليم أحكام تجويد القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الصحيح
- 9066
- مشاركات
-
-
القسم العام
-
الإعلانات "نشاطات منتدى أخوات طريق الإسلام"
للإعلان عن مسابقات وحملات المنتدى و نشاطاته المختلفة
 المشرفات:
المشرفات:
 المشرفات,
مساعدات المشرفات
المشرفات,
مساعدات المشرفات
- 284
- مشاركات
-
- 180514
- مشاركات
-
شموخٌ رغم الجراح
من رحم المعاناة يخرج جيل النصر، منتدى يعتني بشؤون أمتنا الإسلامية، وأخبار إخواننا حول العالم.
 المشرفات:
المشرفات:
 مُقصرة دومًا
مُقصرة دومًا
- 56695
- مشاركات
-

- المقاومة جهاد
- بواسطة أمّ عبد الله
-
همزة الوصل
ترحيب.. تهاني.. تعازي.. مواساة..
- 259983
- مشاركات
-
شكاوى واقتراحات
لطرح شكاوى وملاحظات على المنتدى، ولطرح اقتراحات لتطويره
- 23500
- مشاركات
-
-
فتياتنا الجميلات
-
أحلى صحبة
نقاشات، فوائد، قضايا تخص الفتيات
- 204494
- مشاركات
-

- ♥♥ زخــات الحب ♥♥
- بواسطة حواء أم هالة
-
- 117096
- مشاركات
-

- صويحباتي
- بواسطة أمّ عبد الله
-
- 136895
- مشاركات
-
- 20372
- مشاركات
-

- مذكرة فتاة مسلمة
- بواسطة مناهل ام الخير
-
-
ميراث الأنبياء
-
قبس من نور النبوة
ساحة مخصصة لطرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و شروحاتها و الفوائد المستقاة منها
 المشرفات:
المشرفات:
 سدرة المُنتهى 87
سدرة المُنتهى 87
- 8238
- مشاركات
-
مجلس طالبات العلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع"
- 32133
- مشاركات
-
- 4160
- مشاركات
-
أحاديث المنتدى الضعيفة والموضوعة والدعوات الخاطئة
يتم نقل مواضيع المنتدى التي تشمل أحاديثَ ضعيفة أو موضوعة، وتلك التي تدعو إلى أمور غير شرعية، إلى هذا القسم
 المشرفات:
المشرفات:
 إشراف ساحة الأحاديث الضعيفة
إشراف ساحة الأحاديث الضعيفة
- 3918
- مشاركات
-
- 25483
- مشاركات
-
- 1677
- مشاركات
-
-
الملتقى الشرعي
-
- 30256
- مشاركات
-
الساحة العقدية والفقهية
لطرح مواضيع العقيدة والفقه؛ خاصة تلك المتعلقة بالمرأة المسلمة.
 المشرفات:
المشرفات:
 أرشيف الفتاوى
أرشيف الفتاوى
- 52993
- مشاركات
-
أرشيف فتاوى المنتدى الشرعية
يتم هنا نقل وتجميع مواضيع المنتدى المحتوية على فتاوى شرعية
 المشرفات:
المشرفات:
 أرشيف الفتاوى
أرشيف الفتاوى
- 19530
- مشاركات
-
- 6678
- مشاركات
-
-
قسم الاستشارات
-
استشارات اجتماعية وإيمانية
لطرح المشاكل الشخصية والأسرية والمتعلقة بالأمور الإيمانية
 المشرفات:
إشراف ساحة الاستشارات
المشرفات:
إشراف ساحة الاستشارات
- 40679
- مشاركات
-
- 47550
- مشاركات
-
-
داعيات إلى الهدى
-
زاد الداعية
لمناقشة أمور الدعوة النسائية؛ من أفكار وأساليب، وعقبات ينبغي التغلب عليها.
 المشرفات:
المشرفات:
 جمانة راجح
جمانة راجح
- 21004
- مشاركات
-

- أهم صفات الداعية
- بواسطة أمّ عبد الله
-
إصدارات ركن أخوات طريق الإسلام الدعوية
إصدراتنا الدعوية من المجلات والمطويات والنشرات، الجاهزة للطباعة والتوزيع.
- 776
- مشاركات
-
-
البيت السعيد
-
بَاْبُڪِ إِلَے اَلْجَنَّۃِ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه." [صحيح ابن ماجه 2970]
 المشرفات:
المشرفات:
 جمانة راجح
جمانة راجح
- 6306
- مشاركات
-
- 97009
- مشاركات
-

- عاشروهن بالمعروف
- بواسطة أمّ عبد الله
-
آمال المستقبل
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" قسم لمناقشة أمور تربية الأبناء
 المشرفات:
~ محبة صحبة الأخيار~
المشرفات:
~ محبة صحبة الأخيار~
- 36838
- مشاركات
-
-
سير وقصص ومواعظ
-
- 31793
- مشاركات
-

- حكاوينا
- بواسطة حواء أم هالة
-
القصص القرآني
"لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثًا يُفترى"
 المشرفات:
المشرفات:
 ** الفقيرة الى الله **
** الفقيرة الى الله **
- 4883
- مشاركات
-
- 16438
- مشاركات
-
سيرة الصحابة والسلف الصالح
ساحة لعرض سير الصحابة رضوان الله عليهم ، وسير سلفنا الصالح الذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.."
 المشرفات:
المشرفات:
 سدرة المُنتهى 87
سدرة المُنتهى 87
- 15479
- مشاركات
-
على طريق التوبة
يقول الله تعالى : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } طه:82.
 المشرفات:
المشرفات:
 أمل الأمّة
أمل الأمّة
- 29721
- مشاركات
-
-
العلم والإيمان
-
العبادة المنسية
"وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ.." عبادة غفل عنها الناس
- 31147
- مشاركات
-
- 12926
- مشاركات
-
-
إن من البيان لسحرًا
-
- 50492
- مشاركات
-

- صفو الاكدار
- بواسطة أسما المشد
-
-
مملكتكِ الجميلة
-
- 41313
- مشاركات
-
منزلكِ الجميل
تصاميم.. لمسات تجميلية.. نصائح.. متعلقة بمنزلكِ
- 33904
- مشاركات
-
الطيّبات
- الأطباق الرئيسية
- قسم الحلويات
- قسم المقبلات
- قسم المعجنات والمخبوزات
- منتدى الصحة والرشاقة
- تطبيقات الطيبات
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ))
[البقرة : 172]- 91746
- مشاركات
-
-
كمبيوتر وتقنيات
-
- 32199
- مشاركات
-
جوالات واتصالات
قسم خاص بما يتعلق بالجوالات من برامج وأجهزة
- 13116
- مشاركات
-
- 34854
- مشاركات
-

- تصميم مواقع
- بواسطة Hannan Ali
-
- 65605
- مشاركات
-
وميضُ ضوء
صور فوتوغرافية ملتقطة بواسطة كاميرات عضوات منتدياتنا
- 6120
- مشاركات
-
الفلاشات
- || لَوْحَہٌ مِنْ اِبْدَاعِے ||
- || سَاحَہ الفلاَشْ اَلْتَعْلِيمِيَہْ ||
- || حَقِيَبہُ الْمُصَمِمَہْ ||
ساحة خاصة بأفلام الفلاشات
- 8966
- مشاركات
-
المصممة الداعية
يداَ بيد نخطو بثبات لنكون مصممات داعيـــات
- 4925
- مشاركات
-
-
ورشة عمل المحاضرات المفرغة
-
ورشة التفريغ
هنا يتم تفريغ المحاضرات الصوتية (في قسم التفريغ) ثم تنسيقها وتدقيقها لغويا (في قسم التصحيح) ثم يتم تخريج آياتها وأحاديثها (في قسم التخريج)
- 12904
- مشاركات
-
المحاضرات المنقحة و المطويات الجاهزة
هنا توضع المحاضرات المنقحة والجاهزة بعد تفريغها وتصحيحها وتخريجها
- 508
- مشاركات
-
-
le forum francais
-
- 7177
- مشاركات
-
-
IslamWay Sisters
-
English forums (36956 زيارات علي هذا الرابط)
Several English forums
-
-
المكررات
-
المواضيع المكررة
تقوم مشرفات المنتدى بنقل أي موضوع مكرر تم نشره سابقًا إلى هذه الساحة.
- 101648
- مشاركات
-
-
المتواجدات الآن 0 عضوات, 0 مجهول, 63 زوار (القائمه الكامله)
لاتوجد عضوات مسجلات متواجدات الآن
-
العضوات المتواجدات اليوم
3 عضوات تواجدن خلال ال 24 ساعة الماضية
أكثر عدد لتواجد العضوات كان 14، وتحقق
إعلانات
- تنبيه بخصوص الصور الرسومية + وضع عناوين البريد
- يُمنع وضع الأناشيد المصورة "الفيديو كليب"
- فتح باب التسجيل في مشروع "أنوار الإيمان"
- القصص المكررة
- إيقاف الرسائل الخاصة نهائيًا [مع إتاحة مراسلة المشرفات]
- تنبيه بخصوص المواضيع المثيرة بالساحة
- الأمانة في النقل، هل تراعينها؟
- ضوابط و قوانين المشاركة في المنتدى
- تنبيه بخصوص الأسئلة والاستشارات
- قرار بخصوص مواضيع الدردشة
- يُمنع نشر روابط اليوتيوب
-
أحدث المشاركات
-
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
يحتاج المسلم في مسيرة حياته لما فيها من عقبات وابتلاءات وشدائد ومتطلبات إلى قوة يتعلق بها ويسعد بقربها ويستمد منها العون والتأييد، وقد فطرت النفس الإنسانية على التعلق بالله والاستعانة به في كل الأحوال والظروف؛ لأنه هو الخالق -سبحانه وتعالى-، وهو الرب وهو الملك وهو الرازق والمحيي والمميت، وهو الذي بيده كل شيء ولا يعجزه شيء؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) [فاطر:3]، وقال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الروم: 40]. وظل الإنسان على هذه الفطرة يعبد الله ويرجوه ويطلب منه ويستعين به، حتى إذا ضعف إيمانه وقل يقينه بسبب كثرة ذنوبه ومعاصيه واتباعه للشيطان وشبهاته واغتراره بالدنيا وشهواتها وتعلقه بالماديات من حوله وبالأشخاص والذوات، واعتقاده بقدرتهم على النفع والضر، حتى أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانًا، وفي صحيح مسلم، عن عياض -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقول اللَّـه تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَرَتْهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا". والإنسان عند الضرورة ووقت الشدة تهديه فطرته إلى أن يعود إلى الله معترفًا بربوبيته، موقنًا بقوته وقدرته، فيستجيب الله له ويعطيه الفرصة تلو الأخرى للاستقامة والتوبة، حتى إذا أقام عليه الحجة أخذه أخذ عزيز مقتدر، ووكله إلى نفسه، فتزيد حسرته وتسوء أحواله قال تعالى: (وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ) [لقمان:32]. وكلما زاد الإيمان في قلب المسلم وحافظ عليه وقام بما فرض الله عليه من الطاعات والعبادات؛ زاد يقينه واطمأنت نفسه وتعلق بخالقه سبحانه واستشعر عظمته وقوته ورحمته، عند ذلك تهون كل الصعاب. ورد في السير أنه لما عــاد -صلى الله عليه وسلم- من الطائف وقد رجم بالحجارة من قبل السفهاء والمجانين، وسدّت في وجهة طرق البلاغ لدين الله وحاربه قومه وقتل أصحابه؛ توجه إلى القوة التي لا تهزم، والسند والمعين الذي لا يضعف قائلاً: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟! إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل عليّ غضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك". فلم يلجأ إلا إلى الله، ولم يطلب غيره ولم يتعلق إلا به ولا يطلب إلا رضاه. أيها المؤمنون عباد الله: اليوم كثير من الأفراد والمجتمعات والدول والجماعات والأحزاب يعلقون آمالهم على غيرهم من البشر، طلباً للرزق ودفعاً للضر وجلباً للنصر وتحقيقاً للطموحات وتلبية للرغبات، ويبذلون من أجل طلب رضاهم وموافقتهم واتباع هواهم الكثير من الأعمال، حتى ولو كانت على حساب الدين والقيم والأخلاق والأوطان، ومع ذلك لم يجدوا شيئاً وإن ظهرت بعض الدلائل على تحقيق المطلوب فإنما هو من باب استدراج المولى -سبحانه وتعالى- مع ظلمة تصيب القلوب وضنك في العيش وفساد في الأحوال؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله،سخط الله عليه وأسخط عليه الناس". رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع 6010. وقف الشاعر ابن هانئ الأندلسي أمام المعز الفاطمي يمدحه ويطلب رضاه فقال: ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ *** فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ هذا الذي ترجى النجاة ُ بحبِّهِ *** وبـه يحطُّ الإصـرُ والأوزار لقد جعله بوصفه هذا إلهًا من دون الله، فهل نفعه هذا؟! كلا، فقد سخط عليه المعز بعد زمن وحبسه في السجن، وابتلي بمرض فكان يعوي كالكلب ويردد أبياتًا من الشعر يندب حاله يقول فيها: أبعين مفتقرٍ إليك نظرتني *** فأهنتني وقذفتني من حالقِ لست الملوم أنا الملوم لأنني *** علقت آمالي بغير الخالق قال تعالى: (وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) [الحج: 18]، قال ابن القيم: "من تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله -عز وجل- بتعلقه بغيره، والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل؛ قال الله تعالى: (وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً . كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً) [مريم:82،81]، وقال تعالى: (وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ) [يس:75،74]. فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله...". طريق الهجرتين ص70. عباد الله: إذا كانت مقادير كل شيء بيده سبحانه، ومصير العباد إليه، وآجالهم وأرزاقهم عنده، بل سعادتهم وشقاؤهم في الدنيا والآخرة لا يملكها أحد سواه؛ وجب أن تتعلق القلوب به وحده، وأن لا تذل إلا له، ولا تعتز إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تركن إلا إليه: (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ) [التوبة:51]، فالنفع والضر بيده سبحانه، ولا يملكهما غيره، ولا يقعان إلا بقدره: (قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً) [الأحزاب:17]. قال الإمام أحمد: حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال: نعم، أوحى الله -تبارك وتعالى- إلى نبيه داوُد -عليه السلام-: "يا داوُد: أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبدٌ من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلتُ له من بينهن مخرجاً، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوقٍ دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعتُ أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك". وانظروا إلى التاريخ والأحداث واقرؤوا القرآن، كيف نصر الله أولياءه وعصم أصفياءه وحفظ عباده وأسبغ عليهم نعمه عندما تعلقت قلوبهم به رغم ضعفهم وقلة عددهم وتعرضهم للبلاء، وكيف هزم عدوهم وخذل الجبابرة وقصم الظلمة وأذل المتكبرين، فما نفعتهم أموالهم ولا جيوشهم ولا حصونهم؛ قال تعالى: (فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) [فصلت:15]، ومهما علا الباطل وتجبر وتعلق الناس به وانبهروا بقوته فإنه إلى زوال؛ قال تعالى: (إنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) [القصص:8]، فثقوا بربكم وتوكلوا عليه، وعلقوا آمالكم به، ولا تذلوا نفوسكم لغيره، ولا تركنوا إلى مخلوق مثلكم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فما بالكم لغيره؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) [فَاطِر: 15]. فقيرًا جئت بابك يا إلهي *** ولست إلى عبادك بالفقـير غني عنهــم بيقين قلبي *** وأطمع منك في الفضل الكبير إلهي ما سألت سواك عونًا *** فحسبي العون من رب قدير إلهي ما سألت سواك عفوًا *** فحسبي العفو من رب غفور إلهي ما سألت سواك هديًا *** فحسبي الهدي من رب بصير إذا لم أستعن بك يـا إلهي *** فمن عوني سواك ومن مجيري عباد الله: عند الشدائد والمحن ينبهر الناس بالأمور المادية، وتتعلق قلوبهم بها، ويعتقدون أن تحقيق الآمال مرتبط بها، وتغيير الأحوال متوقف عليها، ويوم حنين خير شاهد، نظر المسلمون إلى عددهم وعدتهم فأيقنوا بالنصر وتعلقوا بهذا، ونسوا أن النصر من عند الله يأذن به متى شاء، فكانت الحادثة درسًا للأمة المسلمة إلى قيام الساعة؛ قال تعالى: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) [التوبة:25]. وفي عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتر اليهود بحصونهم وسلاحهم وعددهم وتعلقوا بها، وظنوا أنهم في مأمن من عذاب الله تعالى، فأخزاهم، وجعل تدبرهم تدميرًا عليهم؛ يقول -جل وعز-: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ) [الحشر:2]. عباد الله: إننا اليوم بحاجة إلى تعمير قلوبنا بالإيمان والعمل بهذا الدين، والتعلق بالله لتستقيم حياتنا وتتبدل أوضاعنا ونخرج من الإحباط الذي تعيشه أمتنا أفرادًا وجماعات. ولتعلم -أيها المسلم- أنه قد يتحول كل شي ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن كل شي معك، ومن عرف الله بالرخاء يعرفه بالشدة. فاللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً. هذا؛ وصلوا وسلموا -رحمكم الله- على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة؛ نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب:56]. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. -
تفسير الشيخ الشعراوي سورة الاسراء 13-14-15(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ..)
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
تفسير الشيخ الشعراوي سورة الاسراء 15-14-13 {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا(13)}
كلمة(طائره) أي: عمله وأصلها أن العرب كانوا في الماضي يزجرون الطير، أي: إذا أراد أحدهم أنْ يُمضيَ عملاً يأتي بطائر ثم يطلقه، فإنْ مَرَّ من اليسار إلى اليمين يسمونه (السانح) ويتفاءلون به، وإنْ مَرّ من اليمين إلى اليسار يسمونه (البارح) ويتشاءمون به، ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل، ولا ذنب له ولا جريرة. إذن: كانوا يتفاءلون باليمين، ويتشاءمون باليسار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ولا يحب التشاؤم؛ لأن الفَأْل الطيب يُنشّط أجهزة الجسم انبساطاً للحركة، أما التشاؤم فيدعو للتراجع والإحجام، ويقضي على الحركة والتفاعل في الكون.
والحق سبحانه هنا يُوضّح: لا تقوِّلوا الطائر ولا تتهموه، بل طائرك أي: عملك في عنقك يلازمك ولا ينفكّ عنك أبداً، ولا يُسأل عنه غيره، كما أنه لا يُسأل عن عمل الآخرين، كما قال تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى..} [الإسراء: 15].
فلا تُلقي بتبعة أفعالك على الحيوان الذي لا ذنب له. وقوله تعالى: {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القيامة كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً} [الإسراء: 13].
وهو كتاب أعماله الذي سجَّلتْه عليه الحفظة الكاتبون، والذي قال الله عنه: {وَيَقُولُونَ ياويلتنا مَالِ هذا الكتاب لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} [الكهف: 49].
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشوراً. أي: مفتوحاً مُعدَّاً للقراءة.
ثم يقول الحق سبحانه: {اقرأ كتابك كفى بِنَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً}.
{اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(14)}
الحق تبارك وتعالى يُصوّر لنا موقفاً من مواقف يوم القيامة، حيث يقف العبد بين يديْ ربه عزَّ وجل، فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه، ليكون هو حجة على نفسه، ويُقِر بما اقترف، والإقرار سيد الأدلة. فهذا موقف لا مجالَ فيه للعناد أو المكابرة، ولا مجالَ فيه للجدال أو الإنكار، فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شاهداً من جوارحه، فيُنطقها الحق سبحانه بقدرته.
يقول تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [النور: 24].
ويقول سبحانه: {وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أَنطَقَنَا الله الذي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} [فصلت: 21].
وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرةً على جوارحه في الدنيا، وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه في خير أو شر، فبيده يضرب ويعتدي، وبيده يُنفق ويقيل عثرة المحتاج، وبرجْله يسعى إلى بيت الله أو يسعى إلى مجلس الخمر والفساد.
وجوارحه في كل هذا مُسخَّرة طائعة لا تتأبى عليه، حتى وإن كانت كارهة للفعل؛ لأنها منقادة لمراداتك، ففِعْلها لك ليس دليلاً على الرضى عنك؛ لأنه قد يكون رضى انقياد. وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية، فأمره نافذ على جنوده، حتى وإن كان خطئاً، فإذا ما فقد هذا القائد السيطرة وأصبح الجنود أمام القائد الأعلى باحوا له بكل شيء.
كذلك في الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه، فلا تتخلف عنه أبداً، لكنها قد تفعل وهي كارهة وهي لاعنةٌ له، وهي مُبغِضة له ولِفعْله، فإذا كان القيامة وانحلَّت من إرادته، وخرجتْ من سجن سيطرته، شهدتْ عليه بما كان منه. {كفى بِنَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً} [الإسراء: 14].
أي: كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهداً على نفسك.
{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا(15)}
قوله تعالى: {مَّنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ..} [الإسراء: 15].
لأن الحق سبحانه لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية، وهو سبحانه الغنيّ عن عباده، وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان الذي جعله خليفة له في أرضه، وقبل أنْ يخلقه أعدَّ له مُقوّمات الحياة كلها من أرض وسماء، وشمس وقمر، وهواء وجبال ومياه.
فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الخَلْق، إذن: فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيئاً، كما أن معصيتهم لن تضره سبحانه في شيء.
وهنا قد يسأل سائل: فلماذا التكليفات إذن؟
نقول: إن التكليف من الله لعباده من أجلهم وفي صالحهم، لكي تستمر حركة حياتهم، وتتساند ولا تتعاند؛ لذلك جعل لنا الخالق سبحانه منهجاً نسير عليه، وهو منهج واجب التنفيذ لأنه من الله، من الخالق الذي يعلم من خلق، ويعلم ما يصلحهم ويُنظم حياتهم، فلو كان منهج بشر لبشر لكان لك أنْ تتأبّى عليه، أما منهج الله فلا ينبغي الخروج عليه. لذلك نسمع في الأمثال الدارجة عند أهل الريف يقولون: الأصبع الذي يقطعه الشرع لا ينزف، والمعنى أن الشرع هو الذي أمر بذلك، فلا اعتراض عليه، ولو كان هذا بأمر البشر لقامت الدنيا ولم تقعُدْ. ومن كماله سبحانه وغِنَاهُ عن الخَلْق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم من أحكام أو تجنٍّ أو تقصير؛ ذلك لأن كل شيء عنده بمقدار، ولا يُقضى أمر في الأرض حتى يُقضى في السماء، فإذا كلَّفْتَ واحداً بقضاء مصلحة لك، فقصّر في قضائها، أو رفض، أو سعى فيها ولم يُوفّق نجدك غاضباً عليه حانقاً. وهنا يتحمّل الخالق سبحانه عن عباده، ويُعفيهم من هذا الحرج، ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه، فلا تلوموا الناس، فلكل شيء ميلاد، ولا داعيَ لأنْ نسبق الأحداث، ولننتظر الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولاً.
ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن نَعِد بعمل شيء لابد أنْ نسبقه بقولنا: إنْ شاء الله لنحمي أنفسنا، ونخرج من دائرة الحرج أو الكذب إذا لم نستطع الوفاء، فأنا إذن في حماية المشيئة الإلهية إنْ وُفِّقْتُ فبها ونِعمت، وإن عجزت فإن الحق سبحانه لم يشأ، وأخرج أنا من أوسع الأبواب.
إذن: تشريعات الله تريد أن تحمي الناس من الناس، تريد أن تجتث أسباب الضِّغن على الآخر، إذا لم تقض حاجتك على يديه، وكأن الحق سبحانه يقول لك: تمهل فكل شيء وقته، ولا تظلم الناس، فإذا ما قضيتَ حاجتك فاعلم أن الذي كلَّفْته بها ما قضاها لك في الحقيقة، ولكن صادف سَعْيُه ميلادَ قضاء هذه الحاجة، فجاءت على يديه، فالخير في الحقيقة من الله، والناس أسباب لا غير.
وتتضح لنا هذه القضية أكثر من مجال الطب وعلاج المرضى، فالطبيب سبب، والشفاء من الله، وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق والقبول عند الناس جعل مجيئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان.
ومن هنا نجد بعض الأطباء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذه الحقيقة، فيقول أحدهم: ليس لنا إلا في(الخضرة).
والخضرة معناها: الحالة الناجحة التي حان وقت شفائها.
وصدق الشاعر حين قال:
والناسُ يلْحون الطَّبيِبَ وإنَّما *** خَطَأُ الطَّبِيبِ إصَابَةُ الأَقْدَارِ
فقول الحق تبارك وتعالى: {مَّنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ..} [الإسراء: 15] أي: لصالح نفسه.
والاهتداء: يعني الالتزام بمنهج الله، والتزامك عائد عليك، وكذلك التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضاً، وأنت المنتفع في كل الأحوال بهذا المنهج؛ لذلك حينما ترى شخصاً مستقيماً عليك أن تحمد الله، وأن تفرحَ باستقامته، وإياك أن تهزأ به أو تسخر منه؛ لأن استقامته ستعود بالخير عليك في حركة حياتك.
وفي المقابل يقول الحق سبحانه: {وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا..} [الإسراء: 15].
أي: تعود عليه عاقبةُ انصرافه عن منهج الله؛ لأن شرَّ الإنسان في عدم التزامه بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله، فيشقى هو بشرّه، ويشقى به المجتمع. ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى مُنحرفاً أو سيء السلوك ينظر إليه نظرة بُغْض وكراهية، ويدعو الله عليه، وهو لا يدري أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة، ويُوسِّع الخُرْق على الراقع كما يقولون.
فهذا المنحرف في حاجة لمَنْ يدعو الله له بالهداية، حتى تستريح أولاً من شرِّه، ثم لتتمتع بخير هدايته ثانياً. أما الدعاء عليه فسوف يزيد من شرِّه، ويزيد من شقاء المجتمع به.
ومن هذا المنطلق علَّمنا الإسلام أن مَنْ كانت لديه قضية علمية تعود بالخير، فعليه أنْ يُعديها إلى الناس؛ لأنك حينما تُعدّي الخير إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم، فكما انتفعوا هم بآثار خِلاَلك الحميدة، فيمكنك أنت أيضاً الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم.
لذلك حرّم الإسلام كَتْم العلم لما يُسبِّبه من أضرار على الشخص نفسه وعلى المجتمع.
يقول صلى الله عليه وسلم: «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». وكذلك من الكمال الذي يدعونا إليه المنهج الإلهي أن يُتقِن كل صاحب مهنة مهنته، وكل صاحب صَنْعة صَنْعته، فالإنسان في حركة حياته يُتقِن عملاً واحداً، لكن حاجاته في الحياة كثيرة ومتعددة.
فالخياط مثلاً الذي يخيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة، وهو يحتاج في حياته إلى مِهَن وصناعات كثيرة، يحتاج إلى: الطبيب والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح.. إلخ.
فلو أتقن عمله وأخلص فيه لَسخّر الله له مَنْ يتقن له حاجته، ولو رَغْماً عنه، أو عن غير قصد، أو حتى بالمصادفة.
إذن: من كمالك أن يكون الناس في كمال، فإنْ أتقنتَ عملك فأنت المستفيد حتى إنْ كان الناس من حولك أشراراً لا يتقنون شيئاً فسوف يُيسِّر الله لهم سبيل إتقان حاجتك، من حيث لا يريدون ولا يشعرون.
وقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى..} [الإسراء: 15].
أي: لا يحمل أحدٌ ذنبَ أحدٍ، ولا يُؤاخَذ أحدٌ بجريرة غيره، وكلمة: {تَزِرُ وَازِرَةٌ..} [الإسراء: 15].
من الوزر: وهو الحِمْل الثقيل، ومنها كلمة الوزير: أي الذي يحمل الأعباء الثقيلة عن الرئيس، أو الملك أو الأمير.
فعدْلُ الله يقتضي أنْ يُحاسب الإنسان بعمله، وأنْ يُسأل عن نفسه، فلا يرمي أحد ذنبه على أحد، كما قال تعالى: {لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً..} [لقمان: 33]. وحول هذه القضية تحدَّث كثير من المستشرقين الذين يبحثون في القرآن عن مأخذ، فوقفوا عند هذه الآية: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى..} [الإسراء: 15].
وقالوا: كيف نُوفِّق بينها وبين قوله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ..} [العنكبوت: 13].
وقوله تعالى: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيامة وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ} [النحل: 25].
ونقول: التوفيق بين الآية الأولى والآيتين الأخيرتين هيِّن لو فهموا الفرق بين الوِزْر في الآية الأولى، والوِزْر في الآيتين الأخيرتين.
ففي الأولى وزر ذاتيٌّ خاص بالإنسان نفسه، حيث ضَلَّ هو في نفسه، فيجب أنْ يتحمّل وزْر ضلاله. أما في الآية الثانية فقد أضلَّ غيره، فتحمَّل وِزْره الخاص به، وِتحمَّل وِزْر مَنْ أضلَّهم.
ويُوضِّح لنا هذه القضية الحديث النبوي الشريف: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).
وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15].
العذاب: عقوبة على مخالفة، لكن قبل أنْ تُعاقبني عليها لابد أن تُعلِّمني أن هذه مخالفة أو جريمة(وهي العمل الذي يكسر سلامة المجتمع)، فلا جريمة إلا بنصٍّ ينصُّ عليها ويُقنّنها، ويُحدِّد العقاب عليها، ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها في الجرائد الرسمية لكي يطلع عليها الناس، وبذلك تُقام عليهم الحجة إنْ خالفوا أو تعرَّضوا لهذه العقوبة.
لذلك حتى في القانون الوضعي نقول: لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنصٍّ، ولا نصَّ إلا بإعلام.
فإذا ما اتضحت هذه الأركان في أذهان الناس كان للعقوبة معنى، وقامت الحجة على المخالفين، أما أنْ نعاقب شخصاً على جريمة هو لا يعلم بها، فله أن يعترضَ عليك من منطلق هذه الآية.
أما أنْ يُجرَّم هذا العمل، ويُعلَن عنه في الصحف الرسمية، فلا حجة لمَنْ جهله بعد ذلك؛ لأن الجهل به بعد الإعلام عنه لا يُعفِي من العقوبة.
فكأن قول الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15] يجمع هذه الأركان السابقة: الجريمة، والعقوبة، والنص، والإعلام، حيث أرسل الله الرسول يُعلِّم الناس منهج الحق سبحانه، ويُحدّد لهم ما جرمه الشرع والعقوبة عليه.
لذلك يقول تعالى في آية أخرى: {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24].
ويقول: {يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ على فَتْرَةٍ مِّنَ الرسل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ..} [المائدة: 19].
إذن: قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذير صلى الله عليه وسلم.
وقد وقف العلماء أمام هذه القضية فقالوا: إن كانت الحجة قد قامت على مَن آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما بال الكافر الذي لم يؤمن ولم يعلم منهج الله؟ وكأنهم يلتمسون له العذر بكفره.
نقول: لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولاً بعقله، وبما ركّبه فيه خالقه سبحانه من ميزان إيماني هو الفطرة، هذه الفطرة هي المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود، وإنْ لم يأتِ رسول، والأمثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية:
هَبْ أنك قد انقطعتْ بك السُّبل في صحراء واسعة شاسعة لا تجد فيها أثراً لحياة، وغلبك النومُ فنمْتَ، وعندما استيقظتَ فوجئت بمائدة منصوبة لك عليها أطايب الطعام والشراب.
بالله أَلاَ تفكِّر في أمرها قبل أن تمتدّ يدُك إليها؟ ألاَ تلفت انتباهك وتثير تساؤلاتك عَمَّنْ أتى بها إليك؟
وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لابد أنْ يهتديَ إلى أن للكون خالقاً مُبْدِعاً، ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن وليدَ المصادفة، وهل عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التي خلقها الله فينا؟
لقد جئنا إلى الحياة فوجدنا عالماً مستوفياً للمقوِّمات والإمكانيات، وجدنا أمام أعيننا آياتٍ كثيرة دالّة على الخالق سبحانه، كل منها خيط لو تتبعته لأوصلك. خذ مثلاً الشمس التي تنير الكون على بُعْدها تطلع في الصباح وتغرب في المساء، ما تخلَّفتْ يوماً، ولا تأخرت لحظة عن موعدها، أَلاَ تسترعي هذه الآية الكونية انتباهك؟
وقد سبق أنْ ضربنا مثلاً ب (أديسون) الذي اكتشف الكهرباء، وكم أخذ من الاهتمام والدراسة في حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج إلى أدوات وأجهزة وأموال، وهي عُرْضة للأعطال ومصدر للأخطار، فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التي لا تحتاج إلى مجهود أو أموال أو صيانة أو خلافه؟
والعربي القُحُّ الذي ما عرف غير الصحراء حينما رأى بَعْر البعير وآثار الأقدام استدلَّ بالأثر على صاحبه، فقال في بساطة العرب: البَعْرة تدلّ على البعير، والقدم تدلّ على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟
إذن: بالفطرة التكوينية التي جعلها الله في الإنسان يمكن له أن يهتدي إلى أن للكون خالقاً، وإنْ لم يعرف مَنْ هو، مجرد أن يعرف القوة الخفية وراء هذا الكون.
وحينما يأتي رسول من عند الله يساعده في الوصول إلى ما يبحث عنه، ويدلّه على ربه وخالقه، وأن هذه القوة الخفية التي حيَّرتْك هي(الله) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومَن فيه.
وهو سبحانه واحد لا شريك له، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ولم يعارضه أحد ولم يَدَّعِ أحد أنه إله مع الله، وبذلك سَلِمَتْ له سبحانه هذه الدعوى؛ لأن صاحب الدعوة حين يدَّعيها تسلم له إذا لم يوجد معارض لها.
وهذه الفطرة الإيمانية في الإنسان هي التي عنَاهَا الحق سبحانه في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بلى..} [الأعراف: 172].
وهذا هو العَهْد الإلهي الذي أخذه الله على خَلْقه وهم في مرحلة الذَّرِّ، حيث كانوا جميعاً في آدم عليه السلام فالأنْسَال كلها تعود إليه، وفي كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم، هذه الذرة هي التي شهدتْ هذا العهد، وأقرَّتْ أنه لا إله إلا الله، ثم ذابتْ هذه الشهادة في فطرة كل إنسان؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية.
ونقول للكافر الذي أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها، وهي تدعوه إلى معرفة الله: كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام؟ وكيف تشعر بالعطش فتطلب الماء؟ أرأيت الجوع أو لمسْتَه أو شَمَمْته؟ إنها الفطرة والغريزة التي جعلها الله فيك، فلماذا استخدمت هذه، وأغفلت هذه؟
والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه في حين أن الكون كله من حوله بكل ذراته يُسبِّح بحمد ربّه، فذراتُ الكون وذراتُ التكوين في المؤمن وفي الكافر تُسبِّح بحمد ربها، كما قال تعالى: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..} [الإسراء: 44] فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مُسبّحة، فإن كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه انسجام واتفاق، وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية مع إيمان ذراته، فترى المؤمن مُنْسجماً مع نفسه مع تكوينه المادي.
ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذرّاته وأعضائه في ظاهرة النوم، فالمؤمن ذرّاته وأعضائه راضية عنه تُحبه وتُحب البقاء معه لا تفارقه؛ لأن إرادته في طاعة الله، فترى المؤمن لا ينام كثيراً مجرد أن تغفل عينه ساعةً من ليل أو نهار تكفيه ذلك؛ لأن أعضاءه في انسجام مع إرادته، وهؤلاء الذين قال الله فيهم: {كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ..} [الذاريات: 17].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، لأنه في انسجام تام مع إرادته صلى الله عليه وسلم.
وما أشبه الإنسان في هذه القضية بسيد شرس سيء الخُلق، لديه عبيد كثيرون، يعانون من سُوء معاملته، فيلتمسون الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيئة.
على خلاف الكافر، فذراته مؤمنة وإرادته كافرة، فلا انسجام ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادي له، لذا ترى طبيعته قلقة، ليس هناك تصالح بينه وبين ذراته، لأنها تبغضه وتلعنه، وتود مفارقته.
ولولا أن الخالق سبحانه جعلها مُنْقادةً له لما طاوعتْه، وإنها لتنتظر يوم القيامة يوم أنْ تفكّ من إرادته، وتخرج من سجنه، لتنطق بلسان مُبين، وتشهد عليه بما اقترف في الدنيا من كفر وجحود؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيراً، وكأن أعضاءه تريد أن ترتاح من شره.
ولا بُدّ أن نعلم أن ذرات الكون وذرات الإنسان في تسبيحها للخالق سبحانه، أنه تسبيح فوق مدارك البشر؛ لذلك قال تعالى: {ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..} [الإسراء: 44].
فلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَنْ منحه الله القدرة على هذا، كما منح هذه الميزة لداود عليه السلام فقال: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال يُسَبِّحْنَ والطير وَكُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 79].
وهنا قد يقول قائل: ما الميزة هنا، والجبال والطير تُسبّح الله بدون داود؟
والميزة هنا لداود عليه السلام أن الله تعالى أسمعه تسبيح الجبال وتسبيح الطير، وجعلها تتجاوب معه في تسبيحه وكأنه(كورس) أو نشيد جماعي تتوافق فيه الأصوات، وتتناغم بتسبيح الله تعالى، ألم يقل الحق سبحانه في آية أخرى: {ياجبال أَوِّبِي مَعَهُ والطير..} [سبأ: 10].
أي: رَجِّعي معه وردِّدي التسبيح.
ومن ذلك أيضاً ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من معرفة منطق الطير أي لغته، فكان يسمع النملة وهي تخاطب بني جنسها ويفهم ما تريد، وهذا فضل من الله يهبه لمَنْ يشاء من عباده، لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة، وفهم ما تريده من تحذير غيرها تبسم ضاحكاً: {وَقَالَ رَبِّ أوزعني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ..} [النمل: 19].
إذن: لكل مخلوق من مخلوقات الله لغة ومنطق، لا يعلمها ولا يفهمها إلا مَنْ يُيسِّر الله له هذا العلم وهذا الفهم.
وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كُتَّاب السيرة مثلاً يقولون: سبَّح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم: تعبيركم هذا غير دقيق، لأن الحصى يُسبِّح في يده صلى الله عليه وسلم كما يُسبِّح في يد أبي جهل، لكن الميزة أنه صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
والحق سبحانه يريد أنْ يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون، وهي كما أن لك حياة خاصة بك، فاعلم أن لكل شيء دونك حياة أيضاً، لكن ليستْ كحياتك أنت، بدليل قول الحق سبحانه: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ..} [القصص: 88].
فكل ما يُطلق عليه شيء مهما قَلَّ فهو هالك، والهلاك ضد الحياة؛ لأن الله تعالى قال: {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ويحيى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ..} [الأنفال: 42] فدلَّ على أن له حياة تُناسبه.
ونعود إلى قوله الحق سبحانه: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15].
فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه، فمن الذي يُعْلِمه بمرادات الخالق سبحانه منه، إذن: لابد من رسول يُبلِّغ عن الله، ويُنبِّه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى. نداء الايمان
-
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا(12)}الاسراء
الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلاً ونهاراً ظرفاً للأحداث، وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتّى مع الآخر، فهما متقابلان لا متضادان، فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل؛ لأن لكل منهما مهمة، والتقابل يجعلهما متكاملين.
ولذلك أراد الله تعالى أن يُنظِّر بالليل والنهار في جنس الإنسان من الذكورة والأنوثة، فهما أيضاً متكاملان لا متضادان، حتى لا تقوم عداوة بين ذكورة وأنوثة، كما نرى البعض من الجنسين يتعصَّب لجنسه تعصبُّاً أعمى خالياً من فَهْم طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى.
فالليل والنهار كجنس واحد لهما مهمة، أما من حيث النوع فلكل منهما مهمة خاصة به، وإياك أن تخلط بين هذه وهذه.
وتأمل قول الحق سبحانه: {والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى وَمَا خَلَقَ الذكر والأنثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لشتى} [الليل: 1-4].
فلا تجعل الليل ضِداً للنهار، ولا النهار ضداً لليل، وكذلك لا تجعل الذكورة ضِداً للأنوثة، ولا الأنوثة ضداً للذكورة.
قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا الليل والنهار آيَتَيْنِ..} [الإسراء: 12].
جعلنا: بمعنى خلقنا، والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة والمشاهدة، ومعرفتنا هذه أوضح من أنْ نعرِّفهما، فنقول مثلاً: الليل هو مَغِيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية، والنهار هو شروق الشمس على نصف الكرة الأرضية.
إذن: قد يكون الشي أوضح من تعريفه.
والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار، وجعل لكل منهما حكمة ومهمة، وحينما يتحدّث عنهما، يقول تعالى: {والضحى والليل إِذَا سجى} [الضحى: 1-2].
ويقول: {والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى} [الليل: 1-2] فبدأ بالليل.
ومرة يتحدث عن اللازم لهما، فيقول: {وَجَعَلَ الظلمات والنور} [الأنعام: 1].
لأن الحكمة من الليل تكمن في ظُلْمته، والحكمة من النهار تكمُن في نوره، فالظُّلْمة سكَنٌ واستقرار وراحة. وفي الليل تهدأ الأعصاب من الأشعة والضوء، ويأخذ البدن راحته؛ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: «أطفئوا المصابيح إذا رقدتم».
في حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة التي نراها الآن مظهر حضاري، وهم غافلون عن الحكمة من الليل، وهي ظلمته.
والنور للحركة والعمل والسَّعْي، فمَن ارتاح في الليل يُصبح نشيطاً للعمل، ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة، وارتاحت أعضاؤه، ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل.
لذلك قال الحق سبحانه: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليل والنهار..} [القصص: 73].
لماذا؟ {لِتَسْكُنُواْ فِيهِ..} [القصص: 73].
أي: في الليل. {وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ..} [القصص: 73] أي: في النهار.
إذن: لليل مهمة، وللنهار مهمة، وإياك أنْ تخلط هذه بهذه، وإذا ما وُجد عمل لا يُؤدِّي إلا بالليل كالحراسة مثلاً، نجد الحق سبحانه يفتح لنا باباً لنخرج من هذه القاعدة العامة.
فيقول تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بالليل والنهار..} [الروم: 23].
فجعل النهار أيضاً محلاً للنوم، فأعطانا فُسْحة ورُخْصة، ولكن في أضيق نطاق، فَمَنْ لا يقومون بأعمالهم إلا في الليل، وهي نسبة ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التي ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم حركة حياتنا.
فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة، وتمرَّد على هذا النظام الإلهي، فإن الحق سبحانه يَردعه بما يكبح جماحه، ويحميه من إسرافه على نفسه، وهذا من لُطْفه تعالى ورحمته بخَلْقه.
هذا الردْع إما رَدْع ذاتيّ اختياري، وإما رَدْع قَهْريّ الردع الذاتي يحدث للإنسان حينما يسعى في حركة الحياة ويعمل، فيحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجري في أعضائه، فإنْ زادتْ الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه، وتبدو عليه أمارات التعب والإرهاق، لأن الدم المتوارد إلى رئته لا يكفي هذه الحركة.
وهذا نلاحظه مثلاً في صعود السُّلَّم، حيث حركة الصعود مناقضة لجاذبية الأرض لك، فتحتاج إلى قوة أكثر، وإلى دم أكثر وتنفس فوق التنفس العادي.
فكأن الحق سبحانه وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعاً ذاتياً في الإنسان، إذا ما تجاوز حَدّ الطاقة التي جعلها الله فيه.
أما الردْع القهري فهو النوم، يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر وغالط نفسه، وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة، فهنا يأتي دور الرادع القَسْري، فينام رغماً عنه ولا يستطيع المقاومة، وكأن الطبيعة التي خلقها الله فيه تقول له: ارحم نفسك، فإنك لم تَعُدْ صالحاً للعمل.
فالحق تبارك وتعالى لا يُسلِم الإنسان لاختياره، بل يُلقي عليه النوم وفقدان الوعي والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه.
لذلك نرى الواحد مِنّا إذا ما تعرّض لمناسبة اضطرته لعدم النوم لمدة يومين مثلاً، لابد له بعد أن ينتهي من مهمته هذه أنْ ينَام مثل هذه المدة التي سهرها؛ ليأخذ الجسم حَقَّه من الراحة التي حُرم منها.
وقوله تعالى: {آيَتَيْنِ..} [الإسراء: 12].
قلنا: إن الآية هي الشيء العجيب الذي يدعو إلى التأمل، ويُظهِر قدرة الخالق وعظمته سبحانه، والآية تُطلَق على ثلاثة أشياء: تُطلَق على الآيات الكونية التي خلقها الله في كونه وأبدعها، وهذه الآيات الكونية يلتقي بها المؤمن والكافر، ومنها كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر} [فصلت: 37].
{وَمِنْ آيَاتِهِ الجوار فِي البحر كالأعلام} [الشورى: 32].
وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
- وتُطلق الآيات على المعجزات التي تصاحب الرسل، وتكون دليلاً على صدْقهم، فكل رسول يُبعَث ليحمل رسالة الخالق لهداية الخَلْق، لابد أن يأتي بدليل على صِدْقه وأمارة على أنه رسول.
وهذه هي المعجزة، وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا؛ لتكون أوضح في إعجازهم وأدْعَى إلى تصديقهم.
قال تعالى: {وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بالآيات إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأولون..} [الإسراء: 59].
وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام.
إذن: هذه أنواع ثلاثة في كل منها عجائب تدعوك للتأمل، ففي الأولى: هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق، وفي الثانية: آيات الإعجاز، حيث أتى بشيء نبغ فيه القوم، ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله، وفي الثالثة: آيات القرآن وحاملة الأحكام؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة.
فقول الحق سبحانه: {وَجَعَلْنَا الليل والنهار آيَتَيْنِ..} [الإسراء: 12].
أي: كونيتين، ولا مانع أنْ تفسر الآياتُ الكونية آيات القرآن.
وقوله: {فَمَحَوْنَآ آيَةَ الليل..} [الإسراء: 12].
أي: بعد أنْ كان الضوء غابت الشمس فَحَلَّ الظلام، أو مَحوْناهَا: أي جعلناها هكذا، كما قلنا: سبحان مَنْ بيَّض اللبن.
أي خلقه هكذا، فيكون المراد: خلق الليل هكذا مظلماً.
{وَجَعَلْنَآ آيَةَ النهار مُبْصِرَةً..} [الإسراء: 12].
أي: خلقنا النهار مضيئاً، ومعنى مبصرة أو مضيئة أي: نرى بها الأشياء؛ لأن الأشياء لا تُرى في الظلام، فإذا حَلَّ الضياء والنور رأيناها، وعلى هذا كان ينبغي أن يقول: وجعلنا آية النهار مُبْصَراً فيها، وليست هي مبصرة.
وهذه كما في قوله تعالى في قصة موسى وفرعون: {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً..} [النمل: 13].
فنسب البصر إلى الآيات، كما نسب البصر هنا إلى النهار.
وهذه مسألة حيَّرتْ الباحثين في فلسفة الكون وظواهره، فكانوا يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرئي فتراه. إلى أن جاء العالم الإسلامي «ابن الهيثم» الذي نَوَّر الله بصيرته، وهداه إلى سِرِّ رؤية الأشياء، فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ، فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئي لأمكنك أن ترى الأشياء في الظُّلمة إذا كنتَ في الضوء.
إذن: الشعاع لا يأتي من العين، بل من الشيء المرئي، ولذلك نرى الأشياء إنْ كانت في الضوء، ولا نراها إن كانت في الظلام.
وعليه يكون الشيء المرئيّ هو الذي يبصرك من حيث هو الذي يتضح لك، ويساعدك على رؤيته، ولذلك نقول: هذا شيء يُلفت النظر أي: يرسل إليك مَا يجعلك تلتفت إليه.
إذن: التعبير القرآني: {وَجَعَلْنَآ آيَةَ النهار مُبْصِرَةً..} [الإسراء: 12].
على مستوى عال من الدقة والإعجاز، وصدق الله تعالى حين قال: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاق وفي أَنفُسِهِمْ حتى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق} [فصلت: 53].
وقوله تعالى: {لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ..} [الإسراء: 12].
وهذه هي العلة الأولى لآية الليل والنهار.
أي: أن السعي وطلب الرزق لا يكون إلا في النهار؛ لذلك أتى طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار، ومعلوم أن الإنسان لا تكون له حركة نشاطية وإقبال على السَّعي والعمل إلا إذا كان مرتاحاً ولا تتوفر له الراحة إلا بنوم الليل.
وبهذا نجد في الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد في قوله تعالى: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليل والنهار لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ..} [القصص: 73].
فالترتيب في الآية يقتضي أن نقول: {لِتَسْكُنُواْ فِيهِ..} [القصص: 73].
أي: في الليل، {وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ..} [القصص: 73] أي: في النهار، وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل، فهما إذن متكاملان.
والحق سبحانه وتعالى جعل النهار مَحلاً للحركة وابتغاء فضل الله؛ لأن الحركة أمرٌ ماديّ وتفاعل ماديّ بين الإنسان ومادة الكون من حوله، كالفلاح وتفاعله مع أرضه، والعامل تفاعله مع آلته.
هذا التفاعل المادي لا يتم إلا في ضوء؛ لأن الظلمة تغطي الأشياء وتُعميها، وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس، أما في السعي والحركة فلابد من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له، ففي الظلمة قد تصطدم بما هو أقوى منك فيحطمك، أو بما هو أضعف منك فتحطمه.
إذن: فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبيّن الإنسان المادة التي يتفاعل معها. لذلك، فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء. فقال تعالى: {وَجَعَلَ الظلمات والنور} [الأنعام: 1].
لأن النور محلٌّ للحركة، ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد راحة، والراحة لا تكون إلا في ظُلْمة الليل.
وقوله تعالى: {وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السنين والحساب..} [الإسراء: 12].
وهذه هي العِلَّة الأخرى لليل والنهار، حيث بمرورهما يتمّ حساب السنين.
وكلمة {عَدَدَ} تقتضي شيئاً له وحدات، ونريد أن نعرف كمية هذه الوحدات؛ لأن الشيء إنْ لم تكُنْ له كميات متكررة فهو واحد.
وقوله: {السنين والحساب..} [الإسراء: 12].
لأنها من لوازم حركتنا في الحياة، فعن طريق حساب الأيام نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة، أو وقت سقوط المطر، أو هبوب الرياح. وفي العبادات نحدد بها أيام الحج، وشهر الصوم، ووقت الصلاة، ويوم الجمعة، هذه وغيرها من لوازم حياتنا لا نعرفها إلا بمرور الليل والنهار.
ولو تأملتَ عظمة الخالق سبحانه لوجدتَ القمر في الليل، والشمس في النهار، ولكل منهما مهمة في حساب الأيام والشهور والسنين، فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذي أنت فيه، حيث يبدأ اليوم بشروقها وينتهي بغروبها، أما بالقمر فتستطيع حساب الأيام والشهور؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على أساسها، فهو في أول الشهر هلال، ثم يكبر فيصير إلى تربيع أول، ثم إلى تربيع ثان، ثم إلى بدر، ثم يأخذ في التناقص إلى أن يصل إلى المحاق آخر الشهر.
إذن: نستطيع أن نحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر، ومن هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار، فتثبت رؤية رمضان ليلاً أولاً، ثم يثبت نهاراً، فنقول: الليلة أول رمضان، لذلك قال تعالى: {هُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضِيَآءً والقمر نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السنين والحساب} [يونس: 5].
فقوله: {وَقَدَّرَهُ..} [يونس: 5] أي: القمر؛ لأن به تتبين أوائل الشهور، وهو أدقّ نظام حسابي يُعتمد عليه حتى الآن عند علماء الفلك وعلماء البحار وغيرهم.
و{مَنَازِلَ..} [يونس: 5] هي البروج الاثنى عشر للقمر التي أقسم الله بها في قوله تعالى: {والسمآء ذَاتِ البروج واليوم الموعود وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 1-3].
ولأن حياة الخَلْق لا تقوم إلا بحساب الزمن، فقد جعل الخالق سبحانه في كَوْنه ضوابط تضبط لنا الزمن، وهذه الضوابط لا تصلح لضبط الوقت إلا إذا كانت هي في نفسها منضبطة، فمثلاً أنت لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير منضبطة(تُقدّم أو تُأخّر).
لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت في كَوْنه: {الشَّمْسُ والقمر بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: 5].
أي: بحساب دقيق لا يختلّ، وطالما أن الخالق سبحانه خلقها بحساب فاجعلوها ضوابط لحساباتكم.
وقوله تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً..} [الإسراء: 12].
معنى التفصيل أن تجعل بَيْناً بين شيئين، وتقول: فصلْتُ شيئاً عن شيء، فالحق سبحانه فصَّل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل، حتى لا يلتبس علينا الأمر في كل نواحي الحياة.
ومثال ذلك في الوضوء مثلاً يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق} [المائدة: 6].
فأطلق غَسْل الوجه؛ لأنه لا يختلف عليه أحد، وحدَّد الأيدي إلى المرافق، لأن الأيدي يُختلف في تحديدها، فاليد قد تكون إلى الرُّسْغ، أو إلى المرفق، أو إلى الكتف، لذلك حددها الله تعالى، لأنه سبحانه يريدها على شكل مخصوص.
وكذلك في قوله تعالى: {وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين} [المائدة: 6].
فالرأس يناسبها المسْح لا الغَسْل، والرِّجْلاَن كاليد لابد أنْ تُحَدَّد. فإذا لم يوجد الماء أو تعذَّر استعماله شرع لنا سبحانه التيمم، فقال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ..} [النساء: 43].
والتيمم يقوم مقام الوضوء، من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء الحق سبحانه وتعالى، وقد يظن البعض أن الحكمة من الوضوء الطهارة والنظافة، وكذلك التيمُّم؛ لذلك يقترح بعضهم أن نُنظّف أنفسنا بالكولونيا مثلاً.
نقول: ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة، بل المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى، وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب؟
هذا الاستعداد للصلاة هو الذي جعل سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه يَصْفرّ وجهه عند الوضوء، وعندما سُئِل عن ذلك قال: أتعلمون على مَنْ أنا مُقبل الآن؟
فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن حساباً، وأنْ يستعدّ للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى.
نداء الايمان
-
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فغض البصر مما جاء الأمر به في القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾[النور: 30]، وقال الله عز وجل: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾[النور: 31]. وعن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إيَّاكم والجلوس في الطُّرُقات))، قالوا: ما لنا بدٌّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: ((فإذا أبيتم إلا ذلك، فأعطوا الطريق حقَّها)) قالوا: وما حقُّ الطريق؟ قال: ((غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر))؛ [أخرجه البخاري]، ومن أطلق لعينيه العنان في النظر إلى ما حرَّم الله عز وجل، فقد جعلهما تزنيان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العينانِ تزنيانِ وزناهما النظر))؛ [أخرجه البخاري ومسلم]. والإنسان يمدح بغض بصره عن نساء الآخرين، يقول عنترة: وأغضُّ طرفي ما بَدَتْ لي جارتي حتى يُواري جارتي مأواها فينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه في غض البصر، فهو داء مهلك، يؤثر في قلب الإنسان، وفي تلذذه بطاعة الله جل وعلا، وقد يكون من أسباب انتكاسة البعض عن طريق الهداية والاستقامة، نسأل الله الكريم أن يعيننا على مجاهدة أنفسنا في غضِّ أبصارنا عمَّا حَرَّم الله. للسلف رحمهم الله أقوال في غضِّ البصر، جمعت بعضًا منها، أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع. حفظ البصر عن النظر إلى ما لا يحل له: عن سعيد بن جبير، رحمه الله، في قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: 30]؛ يعني: يحفظوا من أبصارهم...عمَّا لا يحلُّ لهم النظر إليه. عن الربيع رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ قال: لا ينظر إلى عورة أحد. وصية بغضِّ البصر عن النظرإلى الحرام: قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فتفهم يا أخي ما أوصيك به، إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصِه بنعمه، وعامله بغضه عن الحرام تربح، واحذر أن تكون العقوبة سلب تلك النعمة، وكل زمن الجهاد في الغضِّ لحظة، فإن فعلت ذلك نلت الخير الجزيل. غُضَّ طرفك عمَّا هو عليك من أعظم الآثام، وهو النظرإلى ما لا يحل لك من حرم الأنام...وليكن بصرك من النظر إلى المحارم معدولًا. الاقتداء بالسلف في غضِّهم من أبصارهم: خرج حسان بن أبي سنان رحمه الله يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها؟ فلما أكثرت عليه، قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. خرج الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر. صوم الصالحين يكون بأمور، منها: غضُّ البصر: قال الإمام الغزالي رحمه الله: صوم الصالحين...تمامه بستة أمور: الأول: غض البصر...إلى كل ما يذم ويكره، وإلى كل ما يشغل القلب عن ذكر الله. أضرار النظر المحرم على قلب العبد: قال خالد بن أبي عمران رحمه الله: إن الرجل لينظر نظرة فينغل قلبه، كما ينغل الأديم، فيفسد قلبه حتى لا ينتفع به. عن العلاء بن زياد رحمه الله قال: كان يقال: لا تتبعن بصرك حسن رداء امرأة، فإن النظر يجعل شبقًا في القلب. قال الإمام السمعاني رحمه الله: عن بعض السلف قال: إن النظر يزرع الشهوة في القلب، ورُبَّ شهوةٍ أورثت حزنًا طويلًا. قال الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله: البصر هو الباب الأكبر للقلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب الحذر منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أضرُّ شيءٍ على القلب إرسال البصر، فإنه يُريه ما يشتدُّ طلبُه، ولا صبر له عنه، ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرُ رأيت الذي لا كلُّه أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابرُ النظرة تفعلُ في القلب ما يفعلُ السهم في الرميَّة، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشَّرارة من النار تُرمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل: كلُّ الحوادث مبداها من النَّظر ومُعظمُ النارِ مِن مُستصغر الشَّرَرِ كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوسٍ ولا وترِ والمرءُ ما دام ذا عين يُقلبُها في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر يسُرُّ مقلته ما ضرَّ مهجته لا مرحبًا بسرورٍ عاد بالضَّررِ الناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النظر داعية إلى فساد القلب. قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب. قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: النظر يجعل القلب شيئًا فشيئًا في ظلمة. من أضرار النظر المحرم: أنه مِفْتاح الزنا: قال الإمام الغزالي رحمه الله: النظر يُحرِّك القلب، والقلب يُحرِّك الشهوة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أمر تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم...ولما كان مبدأ ذلك من قِبَل البصر، جعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشَّرَر، فتكون نظرة، ثم خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة. وقال رحمه الله: الله سبحانه ابتلى...الإنسان بعدوٍّ لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيلُه من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل...والفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم، لا يفوتنكم،....ودونكم ثغر العين، فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعِدُه وأُمنِّيه حتى أقوي عزيمته، وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: بدأ سبحانه بالغض...قبل حفظ الفرج؛ لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج. النظر المحرم أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل، ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته: قال الإمام جعفر بن محمد الصادق لابنه رحمهما الله: يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. إطلاق البصر مفتاح العشق: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إطلاق البصر يُوجِب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويُوقِع في سكر العشق وقال: الله سبحانه وتعالى جعل لكل خيرٍ وشرٍّ مِفْتاحًا وبابًا يُدخَل منه إليه...وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق. من يطلق بصره في الحرام لا يستلذُّ بالقرآن كثيرًا: قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: أعظم ما يصد به المرء عن القرآن: النظر، والغناء....وإذا تأملت فإن الذي يطلق نظره، ويسعى في الشهوات من جهة النظر المحرمإلى النساء لا يستلذُّ للقرآن كثيرًا. من آفات النظر أنه يُورِث الحسرات: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من آفات النظر: أنه يُورِث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه، ولا قدرة لك على بعضه، وقال رحمه الله: من أطلق نظره دامت حسرته. خطورة النظر إلى الأمرد: قال ابن كثير: كثير من السلف كانوا ينهون أن يحدَّ الرجل نظره إلى الأمرد. قال العلامة السعدي رحمه الله: ﴿ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ عن النظر...إلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: اعلم- وفقك الله- أن هذا الباب من أعظم أبواب الفتن...فإن الشيطان إنما يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخول، إلى أن يُدرِجه إلى غاية ما يمكنه من الفتن، فإنه لا يأتي إلى العابد فيحسن له الزنا في الأول، وإنما يزين له النظر، والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما باب النظر إلى النساء الأجانب، لبعد مصاحبتهن وامتناع مخالطتهن، والصبي مخالط لهما، فليحذر من فتنته. نظر...إلى غلام في بعض الأسواق، فبُلي به...وطال به البلاء...ولما سُئل عن قصته، قال: رُبَّ ذنبٍ استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من ثبير، وحقيق لمن تعرض للنظر الحرام أن تطول به الأسقام ثم بكى، وقال: أخاف أن يطول في النار شقائي. من فوائد ومنافع غضُّ البصر: قال أبو عمرو بن نجيد رحمه الله: كان شاه الكرماني حادَّ الفراسة، لا يخطئ، ويقول: من غضَّ بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السُّنة، وتعوَّد أكل الحلال لم تخطئ فراسته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: غضُّ البصر عن الصورة التي نُهي عن النظر إليها يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئًا لله عوَّضَه اللهُ خيرًا منه، ويورث نور القلب والفراسة، وقوة القلب وثباته وشجاعته. قال الإمام القرطبي رحمه الله: غضُّ البصر وحفظُ الفرج أطهرُ في الدين، وأبعدُ عن دنس الأنام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: في غضِّ البصر عدة منافع: أحدها: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. الثانية: أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة: أنه يورث القلب أُنْسًا بالله وجمعية على الله. الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة: أنه يُكسِب القلب نورًا، كما أن إطلاقه يُكسِبه ظلمةً. السادسة: أنه يورثه فراسةً صادقةً يتميز بها المُحِق والمُبطِل، والصادق والكاذب. السابعة: أنه يورث القلب ثباتًا وشجاعةً وقوةً. الثامنة: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة. التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يُشتِّته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قيل: من حفظ بصره أورثه اللهُ نورًا في بصيرته. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: يقال: إن كلَّ مَنْ كان أتقى لله، فشهوته أشدُّ؛ لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. قال العلامة السعدي رحمه الله: من ترك شيئًا لله، عَوَّضَه الله خيرًا منه، ومَنْ غَضَّ بصره أنار الله بصيرته. مما يعين الإنسان على غض البصر علمُه أن نظر الله إليه أسبق من نظره: قال رجل للجنيد رحمه الله: بمَ أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبقُ من نظرك إلى المنظور إليه. مجاهدة النفس على غضِّ البصر: قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لو أنَّ امرأةً مستحسنة مرت على رجلين، فلما عرضت لهما اشتهيا النظر إليها، فجاهد أحدُهما نفسَه وغضَّ بصره، فما كانت إلا لحظة ونسي ما كان، وأوغل الآخر في النظر فعلقت بقلبه، فكان ذلك سبب فتنته، وذهاب دينه. صرف الإنسان بصره سريعًا لو وقع على محرم من غير قصد: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى عبادَه المؤمنين أن يغضُّوا أبصارهم عمَّا حرَّم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يُغمِضُوا أبصارَهم عن المحارم، فإن اتفق وأن وقع البصر على مُحَرَّم من غير قصد فليصرف بَصَرَه عنه سريعًا. خوف الإنسان من عقوبة الله إذا أطلق بصره: قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وعلاج هذه النظرة...خوف العقوبة من الله سبحانه عاجلًا وآجلًا، والحذر من سوء عاقبتها وما تجرُّ وتجني. فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ شبكة الالوكة -
بواسطة امانى يسرى محمد · قامت بالمشاركة
قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: 20]. قال القرطبي رحمه الله: "إن الدنيا دارُ بلاءٍ وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنةً لبعض على العموم في جميع الناس؛ مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغنيِّ، ومعنى هذا أن كل واحد مختبَرٌ بصاحبه". إن المتأمل للآية الكريمة يجدها تركز على جوانب أربعة: 1. حتمية تكوين العلاقات البشرية. 2. الفتنة؛ الاختبار والابتلاء. 3. الصبر على أقوال الناس وأفعالهم. 4. إحاطة علم الله تعالى بحركات الناس وسكناتهم. وعليه، فقد تضمنت الآية الكريمة توجيهات تربوية عدة؛ منها: أولًا: إن الطبيعة البشرية لا تنفكُّ عن الحاجة إلى تكوين علاقات اجتماعية، بل هي من ضروريات الحياة، وهي ذات مستويات وأبعاد مختلفة ومتنوعة؛ قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ [الزخرف: 32]. قال ابن كثير رحمه الله: "ليُسخِّرَ بعضهم بعضًا في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا". ثانيًا: أكَّدت السنة النبوية المطهرة على حقيقة المضايقات والصعوبات التي تحدُثُ من مخالطة الناس بعضهم لبعض، وأهمية الصبر عليها، وجاء هذا التوجيه النبويُّ موجِّهًا للمؤمنين، والإيمان من أعلى مراتب الدين، والمؤمن في الغالب الأكثر استجابة وتحمُّلًا للمسؤوليات، والصبر عليها؛ ابتغاء ما عند الله من الأجر والمثوبة؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم))؛ [الألباني، صحيح الجامع، 6651]. ثالثًا: إن الله سبحانه خالقُ الإنسان، وهو العليمُ بحاله وشؤونه كلها؛ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، وما دامت هناك علاقات بشرية قائمة، فإنها لا تخلو غالبًا من مدٍّ وجزر، واختلاف في وجهات النظر، مما قد ينتج معه ردود أفعال ربما تصل إلى إلحاق الضرر بأحد الأطراف، وهذه حقيقة مهمة للغاية، يجب ألَّا تغيب عن الأذهان؛ ولذلك لا بد من الحكمة في التعامل مع الآخرين، وأخذ الحيطة والحذر في كافة التعاملات والعلاقات البشرية؛ لتكون أكثر استقرارًا، ويَحُوطها الرفق واللين. رابعًا: لما كان تكوين العلاقات البشرية مَظِنَّة الفتنة، فليس من الحكمة التوسعُ فيها دون حاجة ماسَّة، فالأَولَى أن تكون علاقاتنا محدودة، وإن وُجِدت تكون منضبطة بأدبيات وأخلاقيات التعامل البشري الراقي. خامسًا: من المنطلقات الأساسية في الحياة التي يجب أن تكون واضحة في عقل ووجدان كل مسلم، أن الحياة ليست دار بقاء وسعادة، لا منغِّصات فيها، بل هي دار فناء وعناء وكَبَدٍ، وهذا يقع تحت دائرة الابتلاء، التي أوضحها القرآن الكريم غاية الإيضاح في غير ما آية؛ ومنها قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: 2]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أي: جعلتُ بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم"؛ [البغوي، تفسير البغوي، الفرقان: 20]. سادسًا: لما كانت العلاقات الاجتماعية حتمية الوجود؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وتكوينه، والاختلاف والتآلف بين البشر قد تحكمها أمور قدرِيَّة، خارجة عن قدرة الإنسان وسيطرته؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((الأرواح جنود مُجَنَّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف))؛ [صحيح مسلم، رقم: 2638]؛ قال النووي رحمه الله: "قيل لأنها خُلِقت مجتمعة، ثم فُرِّقت في أجسادها، فمن وافق بشِيَمِه ألِفه، ومن باعده نافره وخالفه"؛ [شرح النووي على صحيح مسلم، ج 16، ص 185]. سابعًا: من الأهمية أن يستقر في وجدان المسلم أن العلاقات مهما طالت، لا بد من الفراق؛ وهذا مصداق حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عِشْ ما شئت فإنك ميت، وأحْبِبْ من شئت؛ فإنك مفارقه))؛ [الطبراني، المعجم الأوسط، 4278]. هذا التوجيه النبوي يجعل الإنسان المسلم في حالة من الهدوء والاستقرار النفسي عند حدوث أي داعٍ للفراق وتشتت للعلاقات، مهما كان بينها من أواصر الحب والقرابة. ثامنًا: من لوازم استمرار العلاقات ونجاحها عدمُ التدقيق في كل صغيرة وكبيرة؛ بمعنى أوضح: إجادة فن التغافل، فهو من الحكمة، ومن كمال العقل. تاسعًا: قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]؛ قال القرطبي رحمه الله: "هو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى؛ أي: ليُعِنْ بعضكم بعضًا، وتحاثُّوا على أمر الله تعالى، واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه، وامتنعوا منه". فالواجب على منظومة العلاقات البشرية العنايةُ بالتعاون فيما بينهم بما يحقق الخير والنفع للناس، وتجنب التعاون على إلحاق الضرر بهم. والتعاون الْمُثْمِر يعزِّز الروابط الإنسانية، ويحقق التقدم والرخاء للمجتمع وللبشرية عامة. سائلًا اللهَ تعالى بفضله وإحسانه أن يُدِيمَ المحبة والأُلْفَة بين العلاقات البشرية، وأن يجنِّبهم الفتن والتنازع والبغضاء. والحمد لله رب العالمين. د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي شبكة الالوكة
-
-
أكثر العضوات تفاعلاً
لاتوجد مشارِكات لهذا الاسبوع
-
آخر تحديثات الحالة المزاجية
-
أم أنيس تشعر الآن ب حزينة
-
حواء أم هالة تشعر الآن ب راضية
-
مناهل ام الخير تشعر الآن ب سعيدة
-
سارة سيرو تشعر الآن ب مكتئبة
-
samra120 تشعر الآن ب غير مهتمة
-
-
إحصائيات الأقسام
-
إجمالي الموضوعات181955
-
إجمالي المشاركات2535191
-
-
إحصائيات العضوات
منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤
أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..